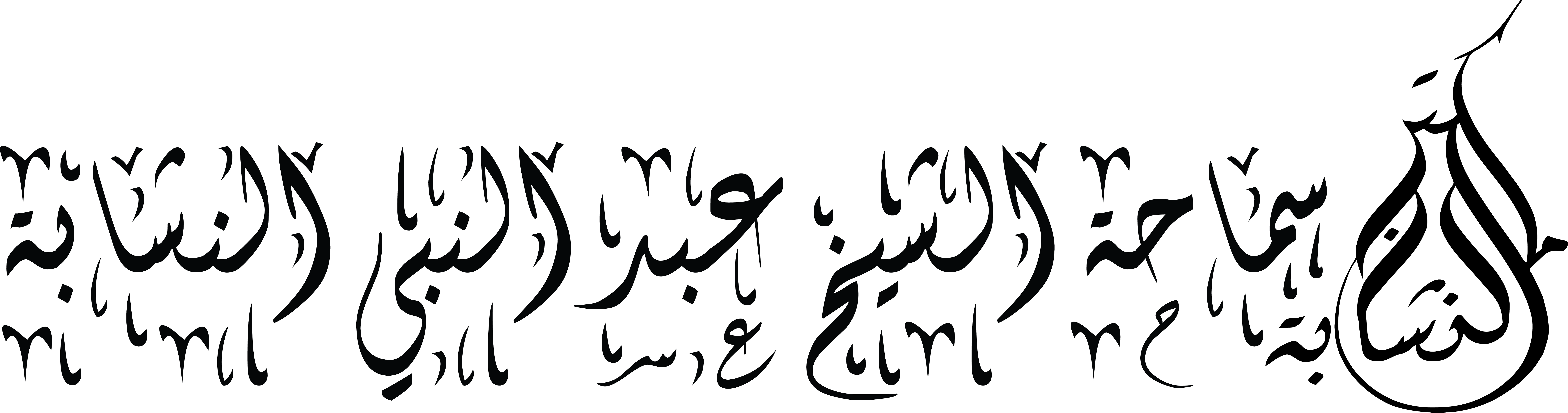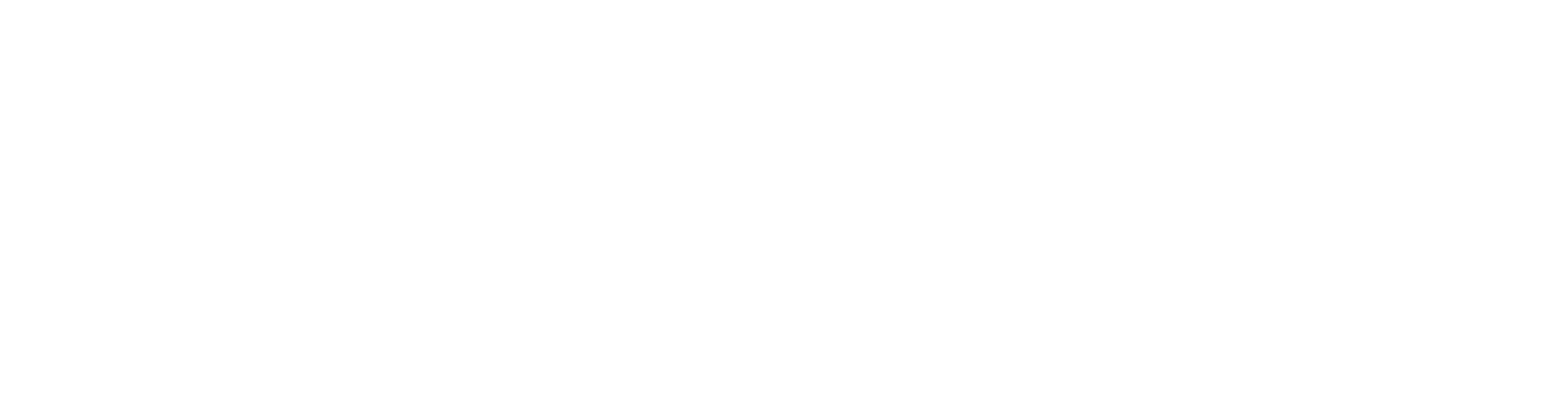كربلاء المقدسة
مرقد أبي الفضل العباس (ع)./ كربلاء المقدسة
مقدمة
رأسٌ رغمَ بطش العمودِ مرفوع، وعينٌ اختلط بها الدمُ بالدموع، ، ففاضت تغسلُ الورى من ذلّ الخنوع، وعَلَمٌ يرفرف فوقَ الجموع، وقمرٌ دائم الطلوع، ومرقدٌ طاهِرٌ يعمُرُه الأشرافُ ويقصدهُ الملايين، وتطوفُ به الأرواحُ وتحفُّ بهِ قلوبُ المؤمنين: ( السلامُ عليكَ أيها العبدُ الصالحُ المطيعُ للهِ ولرسولهِ ولأميرِ المؤمنينَ والحسنِ والحسين) .
قمرُ بني هاشم، وحامي خدورٍ الفواطم، عَلَمٌ من أعلامِ الأمَّة، جودٌ وإيثارٌ وعزمٌ وهِمَّة، ظاهِرٌ في الآفاقِ أمرُهَ، سائرٌ بين رُُكبانِ طُلاّبِ المآثِر ذِكرُه، زاكٍ من عبَق الشهادةِ نَشرُه، زاخِرٌ بالّلآلئِِ والدُرِّ بَحرُه، جَسَّدَ في كربلاءَ معاني العِزِّ والإباء، وأصبحَ رَمزاً للإيثارِ والأخوّةِ والوفاءْ، شاءت الحكمةُ الإلهيةُ أن يودِعَهُ الإمامُ الحسين(عليه السلام) شاطي الفرات لترتشفَ منهُ الأمواجُ فيضَ الحياة ويصبح لَهُ مزارٌ خاصُ ومقامُ محمودًُ شاخصُ للعيان، وشاهدُ على ظُلَمِ الطغيان، وصرخةًُ للعدلِ والإيمان، على مَرِّ الدهورِ والأزمان، قُبَّةٌ تعلو السحاب تعبِّر عن هامةٍ مِلؤُها الشموخُ والعنفوان، ومنارتان ككفين يستنزلانِ غيثَ السماءِ فيضاً وعطاء.
ومازالَ يُنيرُ بطلعتهِ ليالي السماء، ويطلعُ بدراً على اُفقٍ جَلَّلَتْهُ الدماء، يسحُر عيونَ المحدقين، ويجذبُ أفئدةَ العاشقين، لِتَنهلَ من رَيِّهِ العذب المَعين.
فقد برز أبو الفضل العباس ( عليه السلام ) على مسرح التاريخ الاِسلامي كأعظم قائدٍ فذٍّ لم تعرف له الاِنسانية نظيراً في بطولاته النادرة بل ولا في سائر مُثله الاَخرى التي استوعبت ـ بفخر ـ جميع لغات الاَرض.
لقد أبدى أبو الفضل يوم الطف من الصمود الهائل ، والارادة الصلبة ما يفوق الوصف ، فكان برباطة جأشه ، وقوّة عزيمته جيشاً لا يقهر فقد أرعب عسكر ابن زياد ، وهزمهم نفسيّاً ، كما هزمهم في ميادين الحرب فان البطولات لأبي الفضل كانت ولا تزال حديثاً للناس في مختلف العصور.
لذا انّ شجاعة أبي الفضل وسائر مواهبه ومزاياه التي تميز بها بشهادة الإمام الصادق (عليه السلام): ” كان عمّنا العبّاس نافذ البصيرة، صلب الإيمان ” تدعو إلى الاعتزاز والفخر ليس له وللمسلمين فحسب ، وإنما لكل إنسان يدين لإنسانيته ، ويخضع لقيمها الكريمة.
فهو كان مثالاً للصفات الشريفة ، والنزعات العظيمة ، فقد تجسّدت فيه الشهامة والنبل والوفاء والمواساة ، فقد واسى أخاه أبا الاَحرار الاِمام الحسين ( عليه السلام ) في أيام محنته الكبرى ، ففداه بنفسه ووقاه بمهجته ، ومن المقطوع به أن تلك المواساة لا يقدر عليها إلاّ من امتحن الله قلبه للاِيمان ، وزاده هدى.
ومثَّل أبو الفضل العباس ( عليه السلام ) في سلوكه مع أخيه الاِمام الحسين ( عليه السلام ) حقيقة الاَُخوّة الاِسلامية الصادقة ، وأبرز جميع قيمها ومثلها ، فلم يبق لون من ألوان الاَدب ، والبرّ والاِحسان إلاّ قدّمه له ، وكان من أروع ما قام به في ميادين المواساة له ، انه حينما استولى على الماء يوم الطفّ تناول منه غرفة ليشرب ، وكان قلبه الزاكي كصالية الغضا من شدّة الظمأ ، فتذكّر في تلك اللحظات الرهيبة عطش أخيه الاِمام الحسين وعطش الصبية من أهل البيت (عليهم السلام) ، فدفعه شرف النفس ، وسموّ الذات إلى رمي الماء من يده ، ومواساتهم في هذه المحنة الحازبة ، تصفّحوا في تاريخ الاُمم والشعوب فهل تجدون مثل هذه الاُخوّة الصادقة؟!! انظروا في سجلاّت نبلاء الدنيا فهل ترون مثل هذا النبل ، ومثل هذا الاِيثار؟!
لقد استُشهد أبو الفضل العباس من أجل المبادئ العليا التي رفع شعارها أبو الاَحرار أخوه الاِمام الحسين ( عليه السلام ) ، والتي كان من أهمّها أن يقيم في هذا الشرق حكم القرآن ، وينشر العدل بين الناس ويوزّع عليهم خيرات الاَرض ، فليست هي لقوم دون آخرين.
لقد استشهد أبو الفضل من أجل أن يعيد للاِنسان المسلم حرّيته وكرامته ، وينشر بين الناس رحمة الاِسلام ، ونعمته الكبرى الهادفة لاستئصال الظلم والجور ، وبناء مجتمع لا ظلّ فيه لأي لون من ألوان الفزع ، والخوف.
لقد حمل أبو الفضل مشعل الحرية والكرامة ، وقاد قوافل الشهداء إلى ساحات الشرف ، وميادين العزّة ، والنصر للشعوب الاِسلامية التي كانت ترزح تحت وطأة الظلم والجور.
لقد انطلق أبو الفضل إلى ميادين الجهاد من أجل أن ترتفع كلمة الله تعالى عالية في الاَرض ، تلك الكلمة التي هي منهج كامل للحياة الكريمة بين الناس.
فسلام الله عليك يا أبا الفضل ففي حياتك وشهادتك ملتقى أمين لجميع القيم الاِنسانية ، وحسبك أنّك وحدك كنت انموذجاً رائعاً لشهداء الطفّ الذين احتلّوا قمّة الشرف والمجد في دنيا العرب والاِسلام.
قمرُ بني هاشم، وحامي خدورٍ الفواطم، عَلَمٌ من أعلامِ الأمَّة، جودٌ وإيثارٌ وعزمٌ وهِمَّة، ظاهِرٌ في الآفاقِ أمرُهَ، سائرٌ بين رُُكبانِ طُلاّبِ المآثِر ذِكرُه، زاكٍ من عبَق الشهادةِ نَشرُه، زاخِرٌ بالّلآلئِِ والدُرِّ بَحرُه، جَسَّدَ في كربلاءَ معاني العِزِّ والإباء، وأصبحَ رَمزاً للإيثارِ والأخوّةِ والوفاءْ، شاءت الحكمةُ الإلهيةُ أن يودِعَهُ الإمامُ الحسين(عليه السلام) شاطي الفرات لترتشفَ منهُ الأمواجُ فيضَ الحياة ويصبح لَهُ مزارٌ خاصُ ومقامُ محمودًُ شاخصُ للعيان، وشاهدُ على ظُلَمِ الطغيان، وصرخةًُ للعدلِ والإيمان، على مَرِّ الدهورِ والأزمان، قُبَّةٌ تعلو السحاب تعبِّر عن هامةٍ مِلؤُها الشموخُ والعنفوان، ومنارتان ككفين يستنزلانِ غيثَ السماءِ فيضاً وعطاء.
ومازالَ يُنيرُ بطلعتهِ ليالي السماء، ويطلعُ بدراً على اُفقٍ جَلَّلَتْهُ الدماء، يسحُر عيونَ المحدقين، ويجذبُ أفئدةَ العاشقين، لِتَنهلَ من رَيِّهِ العذب المَعين.
فقد برز أبو الفضل العباس ( عليه السلام ) على مسرح التاريخ الاِسلامي كأعظم قائدٍ فذٍّ لم تعرف له الاِنسانية نظيراً في بطولاته النادرة بل ولا في سائر مُثله الاَخرى التي استوعبت ـ بفخر ـ جميع لغات الاَرض.
لقد أبدى أبو الفضل يوم الطف من الصمود الهائل ، والارادة الصلبة ما يفوق الوصف ، فكان برباطة جأشه ، وقوّة عزيمته جيشاً لا يقهر فقد أرعب عسكر ابن زياد ، وهزمهم نفسيّاً ، كما هزمهم في ميادين الحرب فان البطولات لأبي الفضل كانت ولا تزال حديثاً للناس في مختلف العصور.
لذا انّ شجاعة أبي الفضل وسائر مواهبه ومزاياه التي تميز بها بشهادة الإمام الصادق (عليه السلام): ” كان عمّنا العبّاس نافذ البصيرة، صلب الإيمان ” تدعو إلى الاعتزاز والفخر ليس له وللمسلمين فحسب ، وإنما لكل إنسان يدين لإنسانيته ، ويخضع لقيمها الكريمة.
فهو كان مثالاً للصفات الشريفة ، والنزعات العظيمة ، فقد تجسّدت فيه الشهامة والنبل والوفاء والمواساة ، فقد واسى أخاه أبا الاَحرار الاِمام الحسين ( عليه السلام ) في أيام محنته الكبرى ، ففداه بنفسه ووقاه بمهجته ، ومن المقطوع به أن تلك المواساة لا يقدر عليها إلاّ من امتحن الله قلبه للاِيمان ، وزاده هدى.
ومثَّل أبو الفضل العباس ( عليه السلام ) في سلوكه مع أخيه الاِمام الحسين ( عليه السلام ) حقيقة الاَُخوّة الاِسلامية الصادقة ، وأبرز جميع قيمها ومثلها ، فلم يبق لون من ألوان الاَدب ، والبرّ والاِحسان إلاّ قدّمه له ، وكان من أروع ما قام به في ميادين المواساة له ، انه حينما استولى على الماء يوم الطفّ تناول منه غرفة ليشرب ، وكان قلبه الزاكي كصالية الغضا من شدّة الظمأ ، فتذكّر في تلك اللحظات الرهيبة عطش أخيه الاِمام الحسين وعطش الصبية من أهل البيت (عليهم السلام) ، فدفعه شرف النفس ، وسموّ الذات إلى رمي الماء من يده ، ومواساتهم في هذه المحنة الحازبة ، تصفّحوا في تاريخ الاُمم والشعوب فهل تجدون مثل هذه الاُخوّة الصادقة؟!! انظروا في سجلاّت نبلاء الدنيا فهل ترون مثل هذا النبل ، ومثل هذا الاِيثار؟!
لقد استُشهد أبو الفضل العباس من أجل المبادئ العليا التي رفع شعارها أبو الاَحرار أخوه الاِمام الحسين ( عليه السلام ) ، والتي كان من أهمّها أن يقيم في هذا الشرق حكم القرآن ، وينشر العدل بين الناس ويوزّع عليهم خيرات الاَرض ، فليست هي لقوم دون آخرين.
لقد استشهد أبو الفضل من أجل أن يعيد للاِنسان المسلم حرّيته وكرامته ، وينشر بين الناس رحمة الاِسلام ، ونعمته الكبرى الهادفة لاستئصال الظلم والجور ، وبناء مجتمع لا ظلّ فيه لأي لون من ألوان الفزع ، والخوف.
لقد حمل أبو الفضل مشعل الحرية والكرامة ، وقاد قوافل الشهداء إلى ساحات الشرف ، وميادين العزّة ، والنصر للشعوب الاِسلامية التي كانت ترزح تحت وطأة الظلم والجور.
لقد انطلق أبو الفضل إلى ميادين الجهاد من أجل أن ترتفع كلمة الله تعالى عالية في الاَرض ، تلك الكلمة التي هي منهج كامل للحياة الكريمة بين الناس.
فسلام الله عليك يا أبا الفضل ففي حياتك وشهادتك ملتقى أمين لجميع القيم الاِنسانية ، وحسبك أنّك وحدك كنت انموذجاً رائعاً لشهداء الطفّ الذين احتلّوا قمّة الشرف والمجد في دنيا العرب والاِسلام.
العباس (عليه السلام)
سلسلة الآباء
هو العبّاس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
إلى هنا يقف الباحث عن الإتيان بباقي الآباء الأكارم الى آدم، بعد ما يقرأ قول النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ” إذا بَلغ نسبي إلى عدنان فامسكوا “.
وكأنّه نظر الى غرابة تلكم الأسماء، وتعاصيها على نطق العامة، فكان التصحيف إليها أسرع شيء، فيعود وهناً في ساحة جلالتهم، وخفةً في مقدارهم، وقد ولدوا الرّسول الأعظم والوصي المقدّم صلّى اللّه عليهم أجمعين.
وكيف كان فالمُهمّ الذي يجب الهتاف به هو كون كُلّ واحد من هؤلاء الأنجاب غير مدنّس بشيء من رجس الجاهلية، ولا موصوماً بعبادة وثن، وهو الذي يرتضيه علماء الحقّ، لكونهم صدّيقين بين أنبياء وأوصياء.
وقد نزّههم اللّه تعالى في خطابه لنبيّه الأقدس: { وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ }، فإنّه أثبت لهم جميعاً ـ بلفظ الجمع المحلّى باللام ـ السّجود الحقّ الذي يرتضيه لهم، وإنّ ما يؤثر عنهم من أشياء مستغربة لا بدّ أن يكون من الشريعة المشروعة لهم، أو يكون له معنىً تظهره الدراية والتنقيب وليس آزر ـ الذي كان ينحت الأصنام وكاهن نمرود ـ أبا إبراهيم الخليل، الذي نزل من ظهره، لأنّ أباه اسمه تارخ، وآزر، إمّا أن يكون عمّه، كما يرتئيه جماعة من المؤرّخين، وإطلاق الأب على العمّ شائع على المجاز، وجاء به الكتاب المجيد: { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ} فأطلق على إسماعيل لفظ الأب، ولم يكن أبا يعقوب وإنما هو عمّه، كما اُطلق على إبراهيم لفظ الأب وهو جدّه.
وإمّا أن يكون آزر جدّ إبراهيم لاُمّه كما يراه المنقّبون، والجد للأُمّ أب في الحقيقة، ويؤيّد أنّه غير أبيه قوله تعالى: { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ }.فميّزه باسمه، ولو أراد أباه الذي نزل من ظهره لاستغنى بإضافة الأُبوّة عن التسمية بآزر.
وصرّح الرسول بطهارة آبائه عن رجس الجاهلية وسفاح الكفر فقال: ” لمّا أراد اللّه أن يخلقنا، صوّرنا عمود نور في صلب آدم، فكان ذلك النور يلمع في جبينه، ثمّ انتقل إلى وصيّه شيث، وفيما أوصاه به ألاّ يضع هذا النور إلاّ في أرحام المطهّرات من النساء، ولم تزل هذه الوصيّة معمولاً بها يتناقلها كابر عن كابر، فولدنا الأخيار من الرجال والخيرات المطهّرات المهذّبات من النساء، حتّى انتهينا الى صلب عبد المطلب، فجعله نصفين: نصف في عبد اللّه فصار إلى آمنة، ونصف في أبي طالب فصار إلى فاطمة بنت أسد”.
أمّا ” عدنان ” فقد أوضح في خطبه في ظهور النّبي وأنّه من ذريّته وأوصى باتباعه.
وكان ابنه ” معد ” صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل ممّن حاد عن التوحيد، ولم يحارب أحداً إلاّ رجح عليه بالنصر والظفر، ولكونه على دين التوحيد ودين إبراهيم الخليل أمر اللّه أرميا أن يحمله معه على البراق كيلا تصيبه نقمة بختنصر، وقال سبحانه لارميا: إنّي سأخرج من صلبه نبياً كريماً اختم به الرسل، فحمله الى أرض الشام الى أن هدأت الفتن بموت بختنصّر.
وكان السبب في التسمية بـ ” نزار ” أنّ أباه لمّا نظر إلى نور النبوّة يشع من جبهته سرّه ذلك، فأطعم الناس لأجله وقال: إنه نزر في حقّه.
وورد النهي عن سبّ ربيعة ومضر ; لأنّهما مؤمنان، ومن كلام مضر: من يزرع شرّاً يحصد ندامةً.
و” إلياس بن مضر ” كبير قومه وسيّد عشيرته، وكان لا يقضى أمر دونه، وهو أوّل من هدى البدن إلى البيت الحرام، وأوّل من ظفر بمقام إبراهيم لما غرق البيت في زمن نوح، وكان مؤمناً موحّداً، ورد النهي عن سبّه، وقد أدرك مدركة بن إلياس كلّ عز وفخر كان لآبائه، وكان فيه نور النّبي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
و” كنانة ” شيخ عظيم القدر حسن المنظر، كانت العرب تحجّ إليه لعلمه وفضله، وكان يقول: قد آن خروج نبيّ من مكة يدعى أحمد، يدعو إلى اللّه وإلى البرّ والاحسان ومكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفاً وعزاً إلى عزّكم، ولا تكذبوا ما جاء به فهو الحقّ. وممّا يؤثر عنه: ” ربّ صورة تخالف المخبرة قد غرت بجمالها واختبر قبح فعالها، فاحذر الصور واطلب الخبر “، وكان يأنف أن يأكل وحده.
وولده ” النضر ” (قريش عند الفقهاء) فلا يقال لأولاد من فوقه قرشي، وإنّما أولاده مثل مالك وفهر، فمن ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده فليس بقرشي.
وأمّا ” فهر ” فقد حارب حسّان بن عبد كلال حين جاء من اليمن في حمير لأخذ أحجار الكعبة ليبني بها بيتاً باليمن يزوره الناس، فانتصر فهر وأسر حسّان وانهزمت حمير، وبقي حسّان في الأسر ثلاث سنين، ثمّ فدى نفسه بمال كثير وخرج فمات بين مكة واليمن، فهابت العرب فهراً وأعظموه وعلا أمره، خصوصاً مع ما يشاهدون في جبهته من نور النبوّة، ويؤثر عنه قوله لولده غالب: ” قليل ما في يدك أغنى لك من كثير ما أخلق وجهك وإن صار إليك “، وكان موحّداً.
ولم يزل كعب بن لؤي يذكر النّبي، ويُعلم قريشاً أنّه من ولده، ويأمرهم باتباعه ويقول: ” اسمعوا وعوا وتعلّموا تعلموا وتفهّموا تفهموا، ليل داج ونهار ساج والأرض مهاد والجبال أوتاد والأولون كالآخرين، كلّ ذلك إلى بلاء، فصلوا أرحامكم، وأصلحوا أحوالكم، فهل رأيتم من هلك رجع أو ميتاً نشر الدار أمامكم؟ والظنّ خلاف ما تقولون، زيّنوا حرمكم وعظّموه وتمسّكوا به ولا تفارقوه، فسيأتي له نبأ عظيم، وسيخرج منه نبيّ كريم، ثمّ قال:
نهارٌ وليلٌ واختلاف حوادث … سواءٌ عَلينا حلوُها ومريرُها
يؤوبان بالأَحداثِ حتّى تأوّبا… وبالنعمِ الضافي علينا ستُورها
على غفلة يأتِي النّبي محمّد… فيُخبر أخباراً صدوقاً خبيرها
ثمّ قال:
يَاليتني شاهِد فَحْواء دعوتهِ… حتّى العشيرةِ تبغي الحقّ خُذلانا
ولجلالته وشرفه في قومه أرّخوا بموته ثمّ أرّخوا بعام الفيل، ثمّ بموت عبد المطلب، وهو أوّل من سمّى يوم الجمعة ; لاجتماع قريش فيه، وكان اسمه في الجاهلية العروبة، ولما جاء الإسلام أمضاه.
و” كلاب بن مرّة ” الجد الثالث لآمنة أُمّ النّبي والرابع لأبيه عبد اللّه، كان معروفاً بالشجاعة، ونور النّبي لائح في جبهته.
ولا تسل عن سيّد الحرم ” قصي ” فلقد جمع قومه من منازلهم وأسكنهم أرض مكة، وأمرهم بالبناء حول البيت ; لتهابهم العرب، فبنوا حول جوانبه الأربعة، وجعلوا لهم أبواباً تخصهم، فباب لبني شيبة، وباب لبني جمح، وباب لبني مخزوم، وباب لبني سهم. وتركوا قدر الطواف بالبيت، وبنى قصي دار الندوة للمشاورة والتفاهم فيما يعرض عليهم من المهمات، وتيمّنت قريش برأيه وسمّي مجمعاً.
وعند مجيء الحاج قال لقريش: ” هذا أوان الحجّ، وقد سمعت العرب بما صنعتم وهم لكم معظمون، ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام، فليخرج كلّ انسان منكم من ماله خرجاً “. ففعلوا وجمع مالاً كثيراً، ولمّا جاء الحاج نحر لهم على كلّ طريق من طرق مكة جزوراً، غير ما نحره بمكة، وأوقد النار بالمزدلفة ليراها الناس.
وصنع للناس طعاماً أيام منى، وجرى عليه الحال حتّى جاء الإسلام، فالطعام الذي يصنعه السلطان أيام منى كلّ عام من آثار قصي، ومن هنا خضعت خزاعة لقصي، وسلّمت له أمر الحرم وسدانة البيت الحرام، بعد أن كانت عند حليل وعند قصي ابنته وهي أُمّ أولاده.
تولّى قصي سدانة البيت: إمّا بوصاية من حليل عند الموت إليه، أو أنّها كانت عند ابنته زوج قصي بالوراثة، فقام زوجها بتدبير شؤون البيت لعجز المرأة عن القيام بهذه الخدمة، أو أنّ أبا غبشان الخزاعي كان وصيّ حليل على هذه السدانة، فعاوضه عليها قصي بأثواب وأذواد من الإبل.
وهذا هو الصحيح المأثور في ولاية قصي سدانة البيت، ويتفق مع العقل الحاكم بنزاهة جدّ الرسول الأقدس خاتم الأنبياء عمّا تأباه شريعة إبراهيم الخليل من المعاوضة بالخمر المحرم في جميع الأديان.
أيجوز لجدّ الرسول أن يجعل للخمر قيمة ـ وثمنها سحت ـ وهو المانع عنها، المحذّر قومه منها؟! فإنّه قال لولده وقومه: ” اجتنبوا الخمر، فإنّها لا تصلح الأبدان، وتفسد الأذهان “، فكيف يعاوض بها؟! بل لا يتحيّل إلى مطلوبه بالخمر وهو القائل: ” من استحسن قبيحاً نزل إلى قبحه، ومن أكرم لئيماً أشركه في لؤمه، ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان، ومن طلب فوق قدره استحقّ الحرمان، والحسود هو العدو الخفي “.
وقد جمع أطراف المجد والشرف ” عبد مناف ” بن قصي، ولبهائه وجمال منظره قيل له: ” قمر البطحاء “، وكان سمحاً جواداً لا يعدم أحداً من ماله حتّى في أيام أبيه، فقيل له: ” الفيّاض “.
ويسمّى مناف ; لأنه أناف على الناس وعلا أمره حتّى ضربت له الركبان من أطراف الأرض(2)، وكان اسمه عبداً، ثمّ اُضيف إلى
مناف فقيل له: ” عبد مناف ” وهذا هو الصحيح المأثور.
وأمّا ما أثبته ابن دحلان في السيرة النبوية من أن أُمّه اخدمته صنماً اسمه مناف، فهو بعيدٌ عن الصواب ; إذ لا شكّ في نزاهة آباء النّبي وأُمهاته في جميع أدوار حياتهم من الخضوع للأصنام كرامة لحبيبه وصفيّه الرسول الأعظم، فليس بصحيح ما يقال: من أنّ في آباء النّبي وأُمهاته من يعبد الصنم، أو يخضع له ; لشهادة ما تقدّم من الأحاديث عليه، وإليه أشار البوصيري:
لَمْ تَََزلْ فِي ضَمائِر الكَونِِ تَختَا… رُ لََكَ الأُمّهاتُ والآباءُ
على أنّه لم يكن من الأصنام اسمه ” مناف “، وإنّما الموجود ” مناة ” بالتاء المثناة من فوق، ومن هنا كان يقول ابن الكلبي في كتاب الأصنام: 32: ” لا أدري أين كان هذا الصنم؟ ولمن كان؟ ومن نصبه “.
ومنه نعرف الغلط في قول البرقي والزبير: أنّ أُمه أخدمته مناة (بالتاء المثناة من فوق) فسمي عبد مناة، ولكن رأي قصي يوافق عبد مناة بن كنانة فحوّله عبد مناف.وكان بيت عبد مناف أشرف بيوتات قريش، ولسيادته كان عنده قوس إسماعيل ولواء نزار، ومن وصيّته ما وجد مكتوباً في بعض الأحجار: أوصى قريشاً بتقوى اللّه جلّ جلاله وصلة الرحم.
وجرى ابنه هاشم على سيرته حتّى فاق قريشاً وسائر العرب، واذعنوا له، وكان يُطعم الحّاج، كما كان يصنع أبوه. وأصابت قريشاً سنة مُجدِبة، فخرج هاشم الى الشام واشترى الدقيق والكعك، فهشم الخبز، ونحر الجزر، وأطعم الناس حتّى أشبعهم. وكانت مائدته منصوبةً لا ترفع في السّراء والضّراء، وكان يحمل ابن السبيل، ويؤمن الخائف، وإذا أهلّ هلالّ ذي الحجّة قام في صبيحته وأسند ظهره الى الكعبة من تلقاء بابها وخطب الناس فقال:
” يا معشر قريش ; إنّكم سادة العرب، أحسنها وجوهاً، وأعظمها أحلماً، وأوسطها نسباً، وإنّكم جيران بيت اللّه، أكرمكم اللّه بولايته، وخصّكم بجواره دون بني إسماعيل، وإنّه يأتيكم زوار اللّه يعظّمون بيته، فهم أضيافه، وحقّ من أكرم أضياف اللّه أنتم ; فأكرموا ضيفه وزواره، فإنّهم يأتونه غبراً من كلّ بلد، على ضوامر كالقداح، فوربِّ هذه البنية لو كان لي مال يحتمل ذلك لكفيتموه، وأنا مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ بظلم، ولم يدخل فيه حرام، فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل. وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله ـ لكرامة زوار بيت اللّه وتقويتهم ـ إلاّ طيّباً، لم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ غصباً “.
فكانوا يجتهدون في ذلك، ويخرجون من أموالهم، ويضعونه في دار الندوة.
وهو أوّل من سنّ لقريش الرحلتين ; رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، وأخذ لهم من ملوك الروم وغسان ما يعتصمون به(2) ; وذلك إنّ تجار قريش لم تعد تجارتهم نفس مكة وضواحيها، وإنّما تقدّم عليهم الأعاجم بالسلع، فيشترونها، حتّى رحل هاشم إلى الشام ونزل على قيصر، فأعجبه حسن خلقه وجمال هيئته وكرمه المنهمر، فلم يحجبه، وأذن له بالقدوم عليه بالتجارة، وكتب أماناً بينهم، فارتقت منزلة هاشم بين الناس، فكان يسافر في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، وشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوك اليمن والشام، وجعل لهم معه ربحاً، وساق لهم إبلاً مع إبله، وكفاهم مؤونة الأسفار على أن يكفوه مؤنة الأعداء في طريقه ومنصرفه، فكان في ذلك صلاح عام للفريقين، فكان المقيم رابحاً، والمسافر محفوظاً، فأخصبت قريش بذلك، وأتاها الخير من البلاد العالية والسافلة ببركة هاشم، وهذا هو الإيلاف المذكور في القرآن المجيد(3).
وكان يقول في خطبته: ” أيُّها الناس نحن آل إبراهيم، وذريّة إسماعيل، وبنو النضر بن كنانة، وبنو قصي بن كلاب، وأرباب مكة، وسكان الحرم، لنا ذروة الحسب، ومعدن المجد، ولكُلّ في كلّ خلف يجب عليه نصرته وإجابة دعوته، إلاّ ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم.
يا بني قصي، أنتم كغصني شجرة أيّهما كسر أوحش صاحبه، والسيف لا يصان إلاّ بغمده، ورامي العشيرة يصيبه سهمه، ومن أمحكه اللجاج وأخرجه إلى البغي.
أيّها الناس، الحلم شرف، والصبر ظفر، والمعروف كنز، والجود سؤدد، والجهل سفه، والأيام هول، والدهر غِير، والمرء منسوب إلى فعله، ومأخوذ بعمله، فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد، ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء، وأكرموا الجليس يعمر ناديكم، وحاموا الخليط يرغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسكم يوثق بكم، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنّها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنيّة فإنّها تضع الشرف، وتهدم المجد، وإنّ نهنهة الجاهل أهون من جريرته، ورأس العشيرة يحمل أثقالها، ومقام الحليم عظة لمن انتفع به “.
ولنور النبوّة الحالّ في جبهته كان وجهه يضيء في الليلة الظلماء، ولم يمرّ بحجر ولا شجر إلاّ ناداه: أبشر يا هاشم، سيظهر من ذريّتك أكرم خلق اللّه مُحمّد خاتم النبيّين.
وأوصاه أبوه ـ عبد مناف ـ بما أوصاه به أبوه قصي: أن لا يضع نور النبوّة إلاّ في الأرحام الطاهرات من النساء، وأخذ عليه العهد بذلك، فقبل.
وقد تقدّم أنّها موروثة من آدم (عليه السلام)، ومن هنا رغب الأشراف من الأكاسرة والقياصرة في مصاهرة هاشم وهو يأبى، حتّى إذا رأى في المنام قائلاً يقول: عليك بسلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن زيد بن عامر بن غنم بن مازن من بني النجار، فإنّها طاهرة مطهّرة الأذيال، ليس لها مشبه من النساء، فادفع المهر الجزيل، فإنّك ترزق منها ولداً يكون منه النّبي، فمشى هاشم وأخوه المطلب وبنو عمِّه إلى المدينة ومعهم لواء نزار وعليهم أفخر الثيّاب والدروع.
ولمّا اجتمع القوم خطب المطلب بن عبد مناف فقال: ” نحن وفد بيت اللّه الحرام، والمشاعر العظام، وإلينا سعت الأقدام، وأنتم تعلمون شرفنا وسؤددنا، وما خصّنا به اللّه من النور الساطع والضياء اللامع، ونحن بنو لؤي بن غالب، قد انتقل هذا النور إلى عبد مناف، ثُمّ إلى أخينا هاشم، وهو معنا من آدم (عليه السلام)، وقد ساقه اللّه إليكم، وأقدمه عليكم، فنحن لكريمتكم خاطبون، وفيكم راغبون “.
فأجابه عمرو ـ أبو سلمى ـ بالقبول والإنعام، وساقوا المهر كما أرادوا.
ولمّا تزوّج منها هاشم، ودخل بها، وحملت بعبد المطلب انتقل إليها النور، وما زالت تسمع البشائر بولادة خير البشر فأفزعها ذلك، إلاّ أنّ هاشماً عرّفها أمر النّبي.
فلمّا ولدت عبد المطلب كان يدعى (شيبة الحمد) ; لكثرة حمد الناس له، لكونه مفزع قريش في النوائب، وملجأهم في الأُمور، فكان شريف قومه وسيّدهم كمالاً ورفعةً، غير مدافع عن ذلك، وهو من حلماء قريش وحكمائها.
وقد سنّ أشياءَ أمضاها له الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، ووجد كنزاً أخرج خمسه وتصدّق به، وسنّ في القتل مائة من الإبل، ولم يكن للطواف عدد عند قريش. فسنّه سبعة أشواط، وقطع يد السارق، وحرّم الخمر والزنا، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يستقسم بالأزلام، ولا يؤكل ما ذبح على النصب.
ومما يؤثر عنه: ” الظلوم لن يخرج من الدنيا حتّى ينتقم منه، وإنّ وراء هذا الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإذا لم تصب الظلوم في الدنيا عقوبة فهي معدة له في الآخرة “.
وقيل له: الفيّاض ; لكثرة جوده ونائله، حتّى إنّ مائدته يأكل منها الراكب، ثُمّ ترفع إلى جبل أبي قبيس لتأكل منها الطير والوحوش.
ولعزّه المنيع وشرفه الباذخ كان يفرش له بإزاء الكعبة، ولم يفرش لأيّ أحد غيره، ولا يجالسه على بساط الأُبهة إلاّ نبيّ العظمة، وإذا أراد أحد أعمامه أن ينحيه صاح به عبد المطلب وقال: ” إنّ له لشأناً وملكاً عظيماً “.
ولا غرو في ذلك بعد أن كان وصيّاً من الأوصياء وقارئاً للكتب السماوية، ولقد أخبر أبو طالب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ” كان أبي
يقرأ الكتب جميعاً ” وقال: ” إنّ من صلبي نبيّاً، لوددت أنّي أدركت ذلك الزمان فآمنت به، فمن أدركه من ولدي فليؤمن به “.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” واللّه ما عَبدَ أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا عبد مناف ولا هاشم صنماً، وإنّما كانوا يعبدون اللّه، ويصلّون إلى البيت على دين إبراهيم، متمسّكين به “.
وكان أبو طالب سيّد البطحاء شبيهاً بأبيه شيبة الحمد، عالماً بما جاء به الأنبياء، وأخبرت به أُممهم من حوادث وملاحم ; لأنّه وصيّ من الأوصياء، وأمين على وصايا الأنبياء حتّى سلّمها إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله).
قال درست بن منصور: قلت لأبي الحسن الأوّل: أكان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) محجوجاً بأبي طالب؟
قال: ” لا، ولكن كان مستودع الوصايا فدفعها إلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ” قلت: دفعها إليه على أنّه محجوج به؟
قال (عليه السلام): ” لو كان محجوجاً به ما دفعها إليه “.
قلت: فما كان حال أبي طالب؟
قال: ” أقرّ بالنّبي وبما جاء به حتّى مات “.
وقال المجلسي: ” أجمعت الشيعة على أنّ أبا طالب لم يعبد صنماً قطّ، وأنّه كان من أوصياء إبراهيم الخليل (عليه السلام) “(1).
وحكى الطبرسي إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك، ووافقه ابن بطريق في كتاب المستدرك.
وقال الصدوق: ” كان عبد المطلب وأبو طالب من أعرف العلماء وأعلمهم بشأن النّبي، وكانا يكتمان ذلك عن الجهّال والكفرة “(2).
وممّا يشهد على أنّه كان على دين التوحيد وملّة إبراهيم، أنّ قريشاً لمّا أبصرت العجائب ليلة ولادة أمير المؤمنين ( عليه السلام)، خصوصاً لما أتوا بالآلهة إلى جبل أبي قبيس ليسكن بهم ما شاهدوه ارتجّ الجبل، وتساقطت الأصنام، ففزعوا إلى أبي طالب ; لأنّه مفزع اللاجىء، وعصمة المستجير، وسألوه عن ذلك، فرفع يديه مبتهلاً إلى المولى جلّ شأنه قائلاً: ” إلهي أسألك بالمحمّدية المحمودة، والعلويّة العالّية، والفاطميّة البيضاء إلاّ تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة، فسكن ما حلّ بهم، وعرفت قريش هذه الأسماء قبل ظهورها، فكانت العرب تكتب هذه الأسماء وتدعو بها عند المهمات، وهي لا تعرف حقيقتها “(3).
ومن هنا اعتمد عليه عبد المطلب في كفالة الرسول وخصّه به دون بنيه وقال:
وصيّت من كنيّته بطالّب… عبدَ مناف وهو ذو تجارّب
بابنِ الحبيّبِ أكرمِ الأقارّب… بابن الّذي قَدْ غابَ غيرَ آئب
فقال أبو طالب:
لا تُوصني بلازم وواجب… إنّي سمعتُ أعجبَ العجائبِ
من كُلّ حبر عالم وكاتب… بأنّ بحمّد اللّه قول الراهبِ
فقال عبد المطلب: ” أُنظر يا أبا طالب أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الّذي لم يَشمّ رائحة أبيه، ولم يذق شفقة أُمّه، أُنظر أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك، فإنّي قد تركت بنيّ كُلّهم وخصصتك به، لأنّك من أُمّ أبيه، وأعلم فإنّ استطعت أن تتبعه فافعل، وانصره بلسانك ويدك ومالك، فإنّه واللّه سيسودكم ويملك ما لا يملك أحد من آبائي، هل قبلت وصيّتي “؟
قال: ” نعم، قد قبلتُ، واللّه على ذلكِ شاهد “.
فقال عبد المطلب: ” الآن خُفّف عليَّ الموت “، ولم يزل يقبّله ويقول: ” اشهد أنّي لم أر أحداً في ولدي أطيب ريحاً منك ولا أحسن وجهاً “.
وفرح أبو طالب بهذه الحظوة من أبيه العطوف، وراح يدّخر لنفسه السعادة الخالدة بكفالة نبيّ الرحمة، فقام بأمره، وحماه في صغره بماله وجاهه من اليهود والعرب وقريش، وكان يؤثره على أهله ونفسه، وكيف لا يؤثره وهو يشاهد من ابن أخيه ولمّا يبلغ التاسعة من عمره هيكل القدس يملأ الدست هيبةً ورجاحة، أكثر ضحكه الابتسام، ويأنس بالوحدة أكثر من الاجتماع.
وإذا وضع له الطعام والشراب لا يتناول منه شيئاً إلاّ قال: ” بسم اللّه الأحد “، وإذا فرغ من الطعام حمِد اللّه وأثنى عليه، وإن رصده في نومه شاهد النور يسطع من رأسه إلى عنان السماء.
وكان يوماً معه بذي المجاز، فعطش أبو طالب ولم يجد الماء، فجاء النّبي إلى صخرة هناك وركلها برجله، فنبع من تحتها الماء العذب. وزاد على ذلك توفر الطعام القليل في بيته حتّى إنّه يكفي الجمع الكثير إذا تناول النّبي منه شيئاً.
وهذا وحده كاف للإِذعان بأن أبا طالب كان على يقين من نبوة ابن أخيه محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
أضف إلى ذلك قوله في خطبته لما أراد أن يزوّجه من خديجة: ” وهو واللّه بعد هذا له نبأ عظيم، وخطر جليل “(4).
وفي وصيته لقريش: ” إنّي أوصيكم بمحمّد خيراً، فإنّه الأمين في قريش، والصدّيق في العرب، وهو الجامع لكُلّ ما أوصاكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان “.
ولمّا جاء العبّاس بن عبد المطلّب يخبره بتألّب قُريش على معاداة الرسول قال له: ” إنّ أبي أخبرني أنّ الرسول على حقٍّ، ولا يضرّه ما عليه قريش من معاداة له، وإنّ أبي كان يقرأ الكتب جميعاً، وقال: إنّ من صلبي نبيّاً لوددت أنّي أدركته فآمنت به، فمن أدركه فليؤمن به “.
واستشهاده بكلمة أبيه القارئ للكتب، مع أنّه كان يقرؤها مثله، يدلّنا على تفنّنه في تنسيق القياس وإقامة البرهان على صحة النبوّة، وأنّ الواجب اعتناق شريعته الحقّة.
أمّا هو نفسه فعلى يقين من أنّ رسالة ابن أخيه خاتمة الرسل، وهو أفضل من تقدّمه قبل أن يشرق نور النبوّة على وجه البسيطة، ولم تجهل لديه صفات النّبي المبعوث.
وعلى هذا الأساس أخبر بعض أهلِ العلم من الأحبار حينما أسرّ إليه بأنّ ابن أخيه محمّداً الروح الطيّبة، والنّبي المطهّر على لسان التوراة والانجيل، فاستكتمه أبو طالب الحديث كي لا يفشوا الخبر، ثمّ قال له: ” إنّ أبي أخبرني أنّه النّبي المبعوث، وأمر أنْ أستر ذلك لئلا يغرى به الأعادي “.
ولو لم يكن معتقداً صدق الدعوة لما قال لأخيه حمزة لما أظهر الإسلام.
فصَبْراً أبا يَعلى على دينِ أحمد… وكُنْ مظهراً للدين وُفّقت صابراً
وحطْ من أتى بالدين من عندِ ربِّه…بصدق وحقّ لا تكن حمز كافراً
فقد سرّني إذ قلت إنّك مُؤمن …فكنْ لرسولِ اللّهِ في اللّهِ ناصرا
ونادِ قُريشاً بالذي قَدْ أتيته… جهاراً وقُلّ ما كان أحمدَ ساحرا
وقال راداً على قريش:
أَلَمْ تَعْلَموا أنّا وجدنا محمّداً… نبيّاً كموسى خطَّ في أوّل الكتّب
وقال:
وأَمسى ابنُ عبدِ اللّهِ فينا مُصدّقاً… على سخط من قَومنا غيرَ معتّب
وقال:
أمينٌ محبّ في العبادِ مسوّم… بخاتمِ ربِّ قاهر للخواتمِ
يرى الناسُ بُرهاناً عليه وهيْبة… وما جاهل في فعلهِ مثل عالمِ
نبيّ أتاه الوحي من عندِ ربِّه … فمَن قال لا يقرع بها سنّ نادم
وممّا خاطب به النجاشي:
أتدري خيارُ الناسِ أنّ محمّداً …وزيرٌ لموسى والمسيّح بن مريَم
أتى بالهدى مثَلَ الذي أتيَا بهِ … فكُلٌ بأمر اللّه يهدي ويَعصِمُ
وإنّكم تتلونه في كتابكم … بِصدقِ حديث لا حديثَ المُترجم
فلا تجعلوا للّهِ نداً وأسلموا… فإنّ طريق الحقِّ ليس بمُظلِمِ
وقال:
اذهب بُنيّ فمَا عليكَ غَضاضَة… اذهب وقرّ بذاك مِنك عيونا
واللّه لن يَصلوا إليكَ بجمعهِم … حتّى أُوسدَ في التّراب دفينا
ودعوتني وعلمتُ أنّكَ ناصحي… ولقد صدقتَ وكُنتَ قَبلُ أمينا
وذكرتَ ديناً لا محالة أنّه …من خير أديانِ البريّة دينا
وبعد هذه المصارحة هل يخالج الريبُ أحداً في إيمان أبي طالب؟ وهل يجوز لمن يقول: ” إنّا وجدنا محمّداً كموسى نبياً ” إلاّ الاعتراف بنبوته والإقرار برسالته كالأنبياء المتقدّمين؟ وهل يكون إقرار بالنبوّة أبلغ من قوله: ” فأمسى ابن عبد اللّه فينا مصدقاً “؟ وهل فرق بين أن يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وبين أن يقول:
وإن كانَ أحمد قَدْ جاءَهم …بصدق ولم يتّهم بالكَذِب
أَوَ يعترف الرجل بأنّ محمّداً كموسى وعيسى جاء بالهدى والرشاد مثل ما أتيا به ثُمّ يحكم عليه بالكفر؟! وهل هناك جملة يعبّر بها عن الإسلام أصرح من قول المسلم:
وذكرت ديناً لا محالة أنّه …من خيرِ أديان البرية ديناً؟
كلاّ! ولو لم يعرف أبو طالب من ابن أخيه الصدق فيما أخبر به لما قال له بمحضر قريش ليريهم من فضله وهو به خبير وبنبوّتِهِ مؤمن: ” يا بن أخي اللّه أرسلك “؟
قال: ” نعم “.
قال: ” إنّ للأنبياء معجزة وخرق عادة فأرنا آية “؟
قال (صلى الله عليه وآله): ” يا عم ادعُ تلك الشجرة وقل لها: يقول لك محمّد بن عبد اللّه: أقبلي بإذن اللّه “! فدعاها أبو طالب فأقبلت حتّى سجدت بين يديه، ثُمّ أمرها بالانصراف فانصرفت، فقال أبوطالب: ” أشهد أنّك صادق “، ثُمّ قال لابنه علي (عليه السلام): ” يا بنيّ الزَمْه “.
وقال يوماً لعلي: ” ما هذا الذي أنت عليه “؟
قال: ” يا أبة آمنت باللّه ورسوله، وصدّقت بما جاء به، ودخلت معه واتبعته “. فقال أبو طالب: ” أما إنّه لا يدعوك إلاّ إلى خير فالزمه “.
وهل يجد الباحث بعد هذا كُلّه ملتحداً عن الجزم بأنّ شيخ الأبطح كان معتنقاً للدّين الحنيف، ويكافح طواغيت قريش حتّى بالإِتمام مع النّبي في صلابة، وإن أهمله فريق من المؤرّخين رعاية لما هم عليه من حبّ الوقيعة في أبي طالب ورميه وقذفه بما ليس فيه، حنقاً على ولده (الإِمام) الذي لم يتسنّ لهم أي غميزة فيه، فتحاملوا على أُمّه وأبيه، إيذاءً له، واكثاراً لنظائر من يرومون إكباره وإجلاله ممّن سبق منهم الكفر، وحيث لم يسعهم الحطُّ من كرامة النّبي أو الوصيّ عمدوا إلى أبويهما الكريمين فعزوا إليهما الطامات، وربما ستروا ما يؤثر عنهما من الفضائل إيثاراً لما يروقهم اثباته!!
ويشهد لذلك ما ذكره بعض الكتّاب عند ذكر أسرى بدر فقال: ” وكان من الأسرى عمِّ النّبي، وعقيل ابن عمه (أخو علي) “.
فإنّه لو كان غرضه تعريف المأسور لكان في تعريف عقيل بأنّه ابن عمّ النّبي كفاية، كما اكتفى في تعريف العبّاس بأنّه عَمُّ النّبي، ولم يحتج أن يكتب بين قوسين (أخو علي)، وأنت تعرف المراد من ذكر هذه الكلمة بين قوسين، وإلى أيّ شيء يرمز بها الكاتب، ولكن فاته الغرض وهيهات الذي أراد ففشل.
ثُمّ جاء فريق آخر من المؤرّخين يحسبون حصر المصادر في ذوي الأغراض المستهدفة، وأنّ ما جاءوا به حقائق راهنة، فاقتصر على مرويّاتهم ممّا دبّ ودرج، وفيها الخرافات وما أوحته إليهم الأهواء والنوايا السيئة، ومن هنا أُهملت حقائق ورويت أباطيل.
فعزوا إلى أبي طالب قوله: ” إنّي لا أحبّ أن تعلوني أستي “! ثُمّ رووا عنه أنّه قال لرسول اللّه: ” ما هذا الدّين “؟
قال رسول اللّه: ” دين اللّه، ودين ملائكته ورسله، ودين أبينا إبراهيم، بعثني اللّه به إلى العباد، وأنت أحقّ من دعوته إلى الهدى وأحقّ من أجابني “.
فقال أبو طالب: ” إنّي لا استطيع أن أُفارق ديني ودين آبائي، واللّه لا يخلص إليك من قريش شيء تكرهه ما حييت “(1).
فحسبوا من هذا الكلام أنّ أبا طالب ممّن يعبد الأوثان، كيف! وهو على التوحيد أدلّ!
وجوابه: هذا من أنفس التورية وأبلغ المحاورة، فإنّ مراده من قوله لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عقيب قوله: ” أنت أحق من دعوته “: ” إنّي لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي ” الاعتراف بإيمانه، وأنّه باق على الملّة البيضاء، وحنيفية إبراهيم الخليل الذي هو دين الحقّ والهدى، وهو دينه ودين آبائه، ثُمّ زاد أبو طالب في تطمين النّبي بالمدافعة عنه مهما كان باقياً في الدنيا.
نعم، من لا خبرة له بأساليب الكلام وخواصّ التورية يحسب أنّ أبا طالب أراد بقوله: ” إنّي لا أُفارق ديني… إلى آخره ” الخضوع للأصنام، فصفق طرباً، واختال مرحاً.
وجاء الآخر يعتذر عنه بأنّه كان يراعي بقوله هذا الموافقة لقريش، ليتمكّن من كلاءة النّبي وتمشية دعوته.
نحن لا ننكر أنّ شيخ الأبطح كان يلاحظ شيئاً من ذلك ويروقه مداراة القوم في ما يمسّ بكرامة الرسول للحصول على غايته الثمينة، لكنّا لا نوافقهم في كلّ ما يقولون: من انسلاله عن الدّين الحنيف إنسلالاً باتاً، فإنّه خلاف الثابت من سيرته حتّى عند رواة تلكم المخزيات، ومهملي الحقائق الناصعة، حذراً عمّا لا يلائم خطتهم، فلقد كان يراغم أُولئك الطواغيت بما هو أعظم من التظاهر بالإيمان والائتمام بالصلاة مع النّبي.
وإنّ شعره الطافح بذكر النبوّة والتصديق بها سرت به الركبان، وكذلك أعماله الناجعة حول دعوة الرسالة:
ولولاَ أبُو طَالب وابنُهُُ… لمّا مَثُلَ الّدِين شَخصاً فَقامَا
فَذاكَ بِمَكةَ آوى وحَامَا …وهذا بيثرِبَ جَسّ الحِمامَا
تَكفّل عَبدُ مُناف بِأمرٍ …وأَودىَ فَكَان عليٌ تَمامَا
فللِّه ذا فَاتِحُ للهُدَى… وللّه ذا للمَعالِي خِتامَا
وما ضَرّ مَجدُ أبي طَالب… عَدو لغا أو جَهولٌ تعامى
وأمّا أمير المؤمنين فيخرس البليغ عن أن يأتي على صفاته، ويقف الكاتب متردّداً وما عساه أن يقول في من قال فيه أبوه أبو طالب، لمّا فزعت قريش إليه ليلة ولادة أمير المؤمنين إذا أبصروا عجائب لم يروها ولم يسمعوا بها:
” أيّها الناس سيظهر في هذه الليلة وليّ من أولياء اللّه، يكمّل فيه خصال الخير، ويتمّ به الوصيّين، وهو إمام المتقين، وناصر الدّين، وقامع المشركين، وغيظ المنافقين، وزين العابدين، ووصيّ رسول ربِّ العالمين، إمام هدىً، ونجم علا، ومصباح دجىً، ومبيد الشرك والشبهات، وهو نفس اليقين “،ولم يزل يكرّر هذا القول وهو يتخلّل سكك مكة وأسواقها حتّى أصبح.
ويقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): ” ضربة علي عمرو بن ود تعدل عِبادة الثقلين “، وقال يوم خيبر: ” لأعطينّ الراية رجلاً يُحبّ اللّه ورسوله ويحبّه اللّه ورسوله، لا يرجع حتّى يفتح على يديه فأعطاها لعلي (عليه السلام)، وكان الفتح على يده “.
وبعد هذا فلنقف عن الاتيان بما أودع اللّه فيه من نفسيات وغرائز، شكرها لَهُ الإسلام.
نعم، يجب أن نلفت القارئ إلى شيء أكثر البحث فيه رواة الحديث وهو: الإسلام حال الصغر، وتردّدت الكلمة في الجوامع، وتضاربت فيها الأقوال، ولا يهمنا إطالة القول فيها:
1 ـ فإنّا لا نقول: إنّ أمير المؤمنين أوّل من آمن وإن كان هو أوّل من وافق الرسول على مبدأ الإسلام لمّا صدع بالأمر، ولكنّا نقول: متى ” كفر ” علي حتّى يؤمن!! وإنّما كان هو وصاحب الدعوة الإلهية عارفين بالدّين وتعاليمه، معتنقين له، منذ كيانهما في عالم الأنوار قبل خلق الخلق، غير أنّ ذلك العالم مبدأ الفيض الأقدس ووجودهما الخارجي مجراه، فمحمّد نبيّ وعلي وصيّ وآدم بين الماء والطين صلّى اللّه عليهم أجمعين.
2 ـ على أنّ نبيّ الإسلام، وهو العارف بأحكامه، والذي خطّط لنا التكاليف قبل إسلام ابن عمِّه، وأنجز له جميع ما وعده به من الإخوّة والوصاية والخلافة، يوم أجاب دعوته وآزره على هذا الأمرّ وقد أُحجم عنه عندما نزلت آية: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}.
وهل ترى أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يومئذ يجد في شريعته عدم الجدوى بإسلام مثل علي (عليه السلام) لصغره، إلاّ أنّه حاباه، كلاّ وحاشا…!
وإنّما قابله بكلّ ترحيب، وخوّله ما لا يخوّل أحداً صحة إسلامه عنده، بحيث كان على أساس رصين، فاتخذه ردءاً، كمن اعتنق الدين عن قلب شاعر، ولبّ راجح، وعقلية ناضجة يغتنم بذلك محاماته ومرضاة أبيه في المستقبل:
وإذا أكبرنا النّبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كلّ مداهنة ومصانعة، فلا نجد مسرحاً في المقام لأيّ مقال إلاّ أن نقول: إنّ إسلام علي (عليه السلام)كان عن بصيرة وثبات مقبول عند اللّه ورسوله وكان ممدوحاً منهما عليه.
كما تمدّح بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) غير مرّة وهو أعرف الأُمّة بتعاليم الدّين بعد النّبي الكريم فقال: ” أنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي الاّ كاذب مفتر، صلّيت مع رسول اللّه قبل الناس بسبع سنين “.
وقال له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): ” أنت أوّل المؤمنين إيماناً واسلاماً “، كما مدحته الصحابة بذلك، وهم أبصر من غيرهم يوم كانوا يغترفون من مستقى العلم ومنبع الدين.
وعلى هذا الأساس تظافر الثناء عليه من العلماء والمؤلّفين والشعراء وسائر طبقات الأُمّة بأنّه أوّل من أسلم، لكن هناك ضالع في سيره حسب شيئاً فخانته هاجسته وهوى إلى مدحره الباطل فقال: إنّ علياً أسلم وهو صغير!! يريد بذلك الحطّ من مقامه وليس هناك.
3 ـ ولو تنازلنا عن جميع ذلك فمن أين علمنا أن اشتراط البلوغ في التكليف كان مشروعاً في أوّل البعثة، فلعلّه كبقية الأحكام التدريجية نزل به الوحي فيما بعد، ولقد حكى الخفاجي في شرح الشفا ج3 ص125 في باب دعاء النّبي على صبي عن البرهان الحلبي والسبكي: أنّ اشتراط الأحكام بالبلوغ إنّما كان بعد واقعة أحد، وعن غيرهما أنّه بعد الهجرة، وفي السيرة الحلبية ج1 ص304 أنّ الصبيان يومئذ مكلّفون وإنّما رفع القلم عن الصبي عام خيبر. وعن البيهقي أنّ الأحكام إنّما تعلّقت بالبلوغ في عام الخندق أو الحديبية وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز.
4 ـ على أنَّا معاشر الإمامية نعتقد في أئمة الدّين بأنّهم حاملو أعباء الحجة، متحلون بحلي الفضائل كلها، منذ الولادة، كما بُعِثَ عيسى في المهد نبيا، وأوتي الحكم يحيى صبيا، غير أنهم بين مأمور بالكلام أو مأمور بالسكوت حتى يأتي أوانه، فلهم أحكام خاصة غير أحكام الرعية، ومن أقلها قبول إجابة الدعوة ونحوها.
إذن، فلا مساغ لأي أحد البحث في المسألة.
هذه هي السلسلة الذهبية التي تحلّى بها أبو الفضل وهي (آباؤه الأكارم)، وقد اتحد مع كل حلقة منها الجوهر الفرد، لاثارة الفضائل، فما منهم إلا من أخذ بعضادتي الشرف، وملك أزِمّة المجد والخطر، قد ضم إلى طيب المحتد عظمة الزعامة، وإلى طهارة العنصر نزاهة الإيمان، فلا ترى أياًّ منهم إلا منار هدى، وبحر ندى، ومثال تقى، وداعية إلى التوحيد وإلى بسالة وبطولة وإباء وشمم، وهم الذين عرقوا في سيدنا العباس (عليه السلام) هذه الفضائل كلها، وإن كان القلم يقف عند انتهاء السلسلة إلى أمير المؤمنين، فلا يدري اليراع ما يخط من صفات الجلال والجمال، وأنه كيف عرفها في ولده المحبوب (قمر الهاشميين).
هو العبّاس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
إلى هنا يقف الباحث عن الإتيان بباقي الآباء الأكارم الى آدم، بعد ما يقرأ قول النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ” إذا بَلغ نسبي إلى عدنان فامسكوا “.
وكأنّه نظر الى غرابة تلكم الأسماء، وتعاصيها على نطق العامة، فكان التصحيف إليها أسرع شيء، فيعود وهناً في ساحة جلالتهم، وخفةً في مقدارهم، وقد ولدوا الرّسول الأعظم والوصي المقدّم صلّى اللّه عليهم أجمعين.
وكيف كان فالمُهمّ الذي يجب الهتاف به هو كون كُلّ واحد من هؤلاء الأنجاب غير مدنّس بشيء من رجس الجاهلية، ولا موصوماً بعبادة وثن، وهو الذي يرتضيه علماء الحقّ، لكونهم صدّيقين بين أنبياء وأوصياء.
وقد نزّههم اللّه تعالى في خطابه لنبيّه الأقدس: { وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ }، فإنّه أثبت لهم جميعاً ـ بلفظ الجمع المحلّى باللام ـ السّجود الحقّ الذي يرتضيه لهم، وإنّ ما يؤثر عنهم من أشياء مستغربة لا بدّ أن يكون من الشريعة المشروعة لهم، أو يكون له معنىً تظهره الدراية والتنقيب وليس آزر ـ الذي كان ينحت الأصنام وكاهن نمرود ـ أبا إبراهيم الخليل، الذي نزل من ظهره، لأنّ أباه اسمه تارخ، وآزر، إمّا أن يكون عمّه، كما يرتئيه جماعة من المؤرّخين، وإطلاق الأب على العمّ شائع على المجاز، وجاء به الكتاب المجيد: { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ} فأطلق على إسماعيل لفظ الأب، ولم يكن أبا يعقوب وإنما هو عمّه، كما اُطلق على إبراهيم لفظ الأب وهو جدّه.
وإمّا أن يكون آزر جدّ إبراهيم لاُمّه كما يراه المنقّبون، والجد للأُمّ أب في الحقيقة، ويؤيّد أنّه غير أبيه قوله تعالى: { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ }.فميّزه باسمه، ولو أراد أباه الذي نزل من ظهره لاستغنى بإضافة الأُبوّة عن التسمية بآزر.
وصرّح الرسول بطهارة آبائه عن رجس الجاهلية وسفاح الكفر فقال: ” لمّا أراد اللّه أن يخلقنا، صوّرنا عمود نور في صلب آدم، فكان ذلك النور يلمع في جبينه، ثمّ انتقل إلى وصيّه شيث، وفيما أوصاه به ألاّ يضع هذا النور إلاّ في أرحام المطهّرات من النساء، ولم تزل هذه الوصيّة معمولاً بها يتناقلها كابر عن كابر، فولدنا الأخيار من الرجال والخيرات المطهّرات المهذّبات من النساء، حتّى انتهينا الى صلب عبد المطلب، فجعله نصفين: نصف في عبد اللّه فصار إلى آمنة، ونصف في أبي طالب فصار إلى فاطمة بنت أسد”.
أمّا ” عدنان ” فقد أوضح في خطبه في ظهور النّبي وأنّه من ذريّته وأوصى باتباعه.
وكان ابنه ” معد ” صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل ممّن حاد عن التوحيد، ولم يحارب أحداً إلاّ رجح عليه بالنصر والظفر، ولكونه على دين التوحيد ودين إبراهيم الخليل أمر اللّه أرميا أن يحمله معه على البراق كيلا تصيبه نقمة بختنصر، وقال سبحانه لارميا: إنّي سأخرج من صلبه نبياً كريماً اختم به الرسل، فحمله الى أرض الشام الى أن هدأت الفتن بموت بختنصّر.
وكان السبب في التسمية بـ ” نزار ” أنّ أباه لمّا نظر إلى نور النبوّة يشع من جبهته سرّه ذلك، فأطعم الناس لأجله وقال: إنه نزر في حقّه.
وورد النهي عن سبّ ربيعة ومضر ; لأنّهما مؤمنان، ومن كلام مضر: من يزرع شرّاً يحصد ندامةً.
و” إلياس بن مضر ” كبير قومه وسيّد عشيرته، وكان لا يقضى أمر دونه، وهو أوّل من هدى البدن إلى البيت الحرام، وأوّل من ظفر بمقام إبراهيم لما غرق البيت في زمن نوح، وكان مؤمناً موحّداً، ورد النهي عن سبّه، وقد أدرك مدركة بن إلياس كلّ عز وفخر كان لآبائه، وكان فيه نور النّبي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
و” كنانة ” شيخ عظيم القدر حسن المنظر، كانت العرب تحجّ إليه لعلمه وفضله، وكان يقول: قد آن خروج نبيّ من مكة يدعى أحمد، يدعو إلى اللّه وإلى البرّ والاحسان ومكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفاً وعزاً إلى عزّكم، ولا تكذبوا ما جاء به فهو الحقّ. وممّا يؤثر عنه: ” ربّ صورة تخالف المخبرة قد غرت بجمالها واختبر قبح فعالها، فاحذر الصور واطلب الخبر “، وكان يأنف أن يأكل وحده.
وولده ” النضر ” (قريش عند الفقهاء) فلا يقال لأولاد من فوقه قرشي، وإنّما أولاده مثل مالك وفهر، فمن ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده فليس بقرشي.
وأمّا ” فهر ” فقد حارب حسّان بن عبد كلال حين جاء من اليمن في حمير لأخذ أحجار الكعبة ليبني بها بيتاً باليمن يزوره الناس، فانتصر فهر وأسر حسّان وانهزمت حمير، وبقي حسّان في الأسر ثلاث سنين، ثمّ فدى نفسه بمال كثير وخرج فمات بين مكة واليمن، فهابت العرب فهراً وأعظموه وعلا أمره، خصوصاً مع ما يشاهدون في جبهته من نور النبوّة، ويؤثر عنه قوله لولده غالب: ” قليل ما في يدك أغنى لك من كثير ما أخلق وجهك وإن صار إليك “، وكان موحّداً.
ولم يزل كعب بن لؤي يذكر النّبي، ويُعلم قريشاً أنّه من ولده، ويأمرهم باتباعه ويقول: ” اسمعوا وعوا وتعلّموا تعلموا وتفهّموا تفهموا، ليل داج ونهار ساج والأرض مهاد والجبال أوتاد والأولون كالآخرين، كلّ ذلك إلى بلاء، فصلوا أرحامكم، وأصلحوا أحوالكم، فهل رأيتم من هلك رجع أو ميتاً نشر الدار أمامكم؟ والظنّ خلاف ما تقولون، زيّنوا حرمكم وعظّموه وتمسّكوا به ولا تفارقوه، فسيأتي له نبأ عظيم، وسيخرج منه نبيّ كريم، ثمّ قال:
نهارٌ وليلٌ واختلاف حوادث … سواءٌ عَلينا حلوُها ومريرُها
يؤوبان بالأَحداثِ حتّى تأوّبا… وبالنعمِ الضافي علينا ستُورها
على غفلة يأتِي النّبي محمّد… فيُخبر أخباراً صدوقاً خبيرها
ثمّ قال:
يَاليتني شاهِد فَحْواء دعوتهِ… حتّى العشيرةِ تبغي الحقّ خُذلانا
ولجلالته وشرفه في قومه أرّخوا بموته ثمّ أرّخوا بعام الفيل، ثمّ بموت عبد المطلب، وهو أوّل من سمّى يوم الجمعة ; لاجتماع قريش فيه، وكان اسمه في الجاهلية العروبة، ولما جاء الإسلام أمضاه.
و” كلاب بن مرّة ” الجد الثالث لآمنة أُمّ النّبي والرابع لأبيه عبد اللّه، كان معروفاً بالشجاعة، ونور النّبي لائح في جبهته.
ولا تسل عن سيّد الحرم ” قصي ” فلقد جمع قومه من منازلهم وأسكنهم أرض مكة، وأمرهم بالبناء حول البيت ; لتهابهم العرب، فبنوا حول جوانبه الأربعة، وجعلوا لهم أبواباً تخصهم، فباب لبني شيبة، وباب لبني جمح، وباب لبني مخزوم، وباب لبني سهم. وتركوا قدر الطواف بالبيت، وبنى قصي دار الندوة للمشاورة والتفاهم فيما يعرض عليهم من المهمات، وتيمّنت قريش برأيه وسمّي مجمعاً.
وعند مجيء الحاج قال لقريش: ” هذا أوان الحجّ، وقد سمعت العرب بما صنعتم وهم لكم معظمون، ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام، فليخرج كلّ انسان منكم من ماله خرجاً “. ففعلوا وجمع مالاً كثيراً، ولمّا جاء الحاج نحر لهم على كلّ طريق من طرق مكة جزوراً، غير ما نحره بمكة، وأوقد النار بالمزدلفة ليراها الناس.
وصنع للناس طعاماً أيام منى، وجرى عليه الحال حتّى جاء الإسلام، فالطعام الذي يصنعه السلطان أيام منى كلّ عام من آثار قصي، ومن هنا خضعت خزاعة لقصي، وسلّمت له أمر الحرم وسدانة البيت الحرام، بعد أن كانت عند حليل وعند قصي ابنته وهي أُمّ أولاده.
تولّى قصي سدانة البيت: إمّا بوصاية من حليل عند الموت إليه، أو أنّها كانت عند ابنته زوج قصي بالوراثة، فقام زوجها بتدبير شؤون البيت لعجز المرأة عن القيام بهذه الخدمة، أو أنّ أبا غبشان الخزاعي كان وصيّ حليل على هذه السدانة، فعاوضه عليها قصي بأثواب وأذواد من الإبل.
وهذا هو الصحيح المأثور في ولاية قصي سدانة البيت، ويتفق مع العقل الحاكم بنزاهة جدّ الرسول الأقدس خاتم الأنبياء عمّا تأباه شريعة إبراهيم الخليل من المعاوضة بالخمر المحرم في جميع الأديان.
أيجوز لجدّ الرسول أن يجعل للخمر قيمة ـ وثمنها سحت ـ وهو المانع عنها، المحذّر قومه منها؟! فإنّه قال لولده وقومه: ” اجتنبوا الخمر، فإنّها لا تصلح الأبدان، وتفسد الأذهان “، فكيف يعاوض بها؟! بل لا يتحيّل إلى مطلوبه بالخمر وهو القائل: ” من استحسن قبيحاً نزل إلى قبحه، ومن أكرم لئيماً أشركه في لؤمه، ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان، ومن طلب فوق قدره استحقّ الحرمان، والحسود هو العدو الخفي “.
وقد جمع أطراف المجد والشرف ” عبد مناف ” بن قصي، ولبهائه وجمال منظره قيل له: ” قمر البطحاء “، وكان سمحاً جواداً لا يعدم أحداً من ماله حتّى في أيام أبيه، فقيل له: ” الفيّاض “.
ويسمّى مناف ; لأنه أناف على الناس وعلا أمره حتّى ضربت له الركبان من أطراف الأرض(2)، وكان اسمه عبداً، ثمّ اُضيف إلى
مناف فقيل له: ” عبد مناف ” وهذا هو الصحيح المأثور.
وأمّا ما أثبته ابن دحلان في السيرة النبوية من أن أُمّه اخدمته صنماً اسمه مناف، فهو بعيدٌ عن الصواب ; إذ لا شكّ في نزاهة آباء النّبي وأُمهاته في جميع أدوار حياتهم من الخضوع للأصنام كرامة لحبيبه وصفيّه الرسول الأعظم، فليس بصحيح ما يقال: من أنّ في آباء النّبي وأُمهاته من يعبد الصنم، أو يخضع له ; لشهادة ما تقدّم من الأحاديث عليه، وإليه أشار البوصيري:
لَمْ تَََزلْ فِي ضَمائِر الكَونِِ تَختَا… رُ لََكَ الأُمّهاتُ والآباءُ
على أنّه لم يكن من الأصنام اسمه ” مناف “، وإنّما الموجود ” مناة ” بالتاء المثناة من فوق، ومن هنا كان يقول ابن الكلبي في كتاب الأصنام: 32: ” لا أدري أين كان هذا الصنم؟ ولمن كان؟ ومن نصبه “.
ومنه نعرف الغلط في قول البرقي والزبير: أنّ أُمه أخدمته مناة (بالتاء المثناة من فوق) فسمي عبد مناة، ولكن رأي قصي يوافق عبد مناة بن كنانة فحوّله عبد مناف.وكان بيت عبد مناف أشرف بيوتات قريش، ولسيادته كان عنده قوس إسماعيل ولواء نزار، ومن وصيّته ما وجد مكتوباً في بعض الأحجار: أوصى قريشاً بتقوى اللّه جلّ جلاله وصلة الرحم.
وجرى ابنه هاشم على سيرته حتّى فاق قريشاً وسائر العرب، واذعنوا له، وكان يُطعم الحّاج، كما كان يصنع أبوه. وأصابت قريشاً سنة مُجدِبة، فخرج هاشم الى الشام واشترى الدقيق والكعك، فهشم الخبز، ونحر الجزر، وأطعم الناس حتّى أشبعهم. وكانت مائدته منصوبةً لا ترفع في السّراء والضّراء، وكان يحمل ابن السبيل، ويؤمن الخائف، وإذا أهلّ هلالّ ذي الحجّة قام في صبيحته وأسند ظهره الى الكعبة من تلقاء بابها وخطب الناس فقال:
” يا معشر قريش ; إنّكم سادة العرب، أحسنها وجوهاً، وأعظمها أحلماً، وأوسطها نسباً، وإنّكم جيران بيت اللّه، أكرمكم اللّه بولايته، وخصّكم بجواره دون بني إسماعيل، وإنّه يأتيكم زوار اللّه يعظّمون بيته، فهم أضيافه، وحقّ من أكرم أضياف اللّه أنتم ; فأكرموا ضيفه وزواره، فإنّهم يأتونه غبراً من كلّ بلد، على ضوامر كالقداح، فوربِّ هذه البنية لو كان لي مال يحتمل ذلك لكفيتموه، وأنا مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ بظلم، ولم يدخل فيه حرام، فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل. وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله ـ لكرامة زوار بيت اللّه وتقويتهم ـ إلاّ طيّباً، لم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ غصباً “.
فكانوا يجتهدون في ذلك، ويخرجون من أموالهم، ويضعونه في دار الندوة.
وهو أوّل من سنّ لقريش الرحلتين ; رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، وأخذ لهم من ملوك الروم وغسان ما يعتصمون به(2) ; وذلك إنّ تجار قريش لم تعد تجارتهم نفس مكة وضواحيها، وإنّما تقدّم عليهم الأعاجم بالسلع، فيشترونها، حتّى رحل هاشم إلى الشام ونزل على قيصر، فأعجبه حسن خلقه وجمال هيئته وكرمه المنهمر، فلم يحجبه، وأذن له بالقدوم عليه بالتجارة، وكتب أماناً بينهم، فارتقت منزلة هاشم بين الناس، فكان يسافر في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، وشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوك اليمن والشام، وجعل لهم معه ربحاً، وساق لهم إبلاً مع إبله، وكفاهم مؤونة الأسفار على أن يكفوه مؤنة الأعداء في طريقه ومنصرفه، فكان في ذلك صلاح عام للفريقين، فكان المقيم رابحاً، والمسافر محفوظاً، فأخصبت قريش بذلك، وأتاها الخير من البلاد العالية والسافلة ببركة هاشم، وهذا هو الإيلاف المذكور في القرآن المجيد(3).
وكان يقول في خطبته: ” أيُّها الناس نحن آل إبراهيم، وذريّة إسماعيل، وبنو النضر بن كنانة، وبنو قصي بن كلاب، وأرباب مكة، وسكان الحرم، لنا ذروة الحسب، ومعدن المجد، ولكُلّ في كلّ خلف يجب عليه نصرته وإجابة دعوته، إلاّ ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم.
يا بني قصي، أنتم كغصني شجرة أيّهما كسر أوحش صاحبه، والسيف لا يصان إلاّ بغمده، ورامي العشيرة يصيبه سهمه، ومن أمحكه اللجاج وأخرجه إلى البغي.
أيّها الناس، الحلم شرف، والصبر ظفر، والمعروف كنز، والجود سؤدد، والجهل سفه، والأيام هول، والدهر غِير، والمرء منسوب إلى فعله، ومأخوذ بعمله، فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد، ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء، وأكرموا الجليس يعمر ناديكم، وحاموا الخليط يرغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسكم يوثق بكم، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنّها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنيّة فإنّها تضع الشرف، وتهدم المجد، وإنّ نهنهة الجاهل أهون من جريرته، ورأس العشيرة يحمل أثقالها، ومقام الحليم عظة لمن انتفع به “.
ولنور النبوّة الحالّ في جبهته كان وجهه يضيء في الليلة الظلماء، ولم يمرّ بحجر ولا شجر إلاّ ناداه: أبشر يا هاشم، سيظهر من ذريّتك أكرم خلق اللّه مُحمّد خاتم النبيّين.
وأوصاه أبوه ـ عبد مناف ـ بما أوصاه به أبوه قصي: أن لا يضع نور النبوّة إلاّ في الأرحام الطاهرات من النساء، وأخذ عليه العهد بذلك، فقبل.
وقد تقدّم أنّها موروثة من آدم (عليه السلام)، ومن هنا رغب الأشراف من الأكاسرة والقياصرة في مصاهرة هاشم وهو يأبى، حتّى إذا رأى في المنام قائلاً يقول: عليك بسلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن زيد بن عامر بن غنم بن مازن من بني النجار، فإنّها طاهرة مطهّرة الأذيال، ليس لها مشبه من النساء، فادفع المهر الجزيل، فإنّك ترزق منها ولداً يكون منه النّبي، فمشى هاشم وأخوه المطلب وبنو عمِّه إلى المدينة ومعهم لواء نزار وعليهم أفخر الثيّاب والدروع.
ولمّا اجتمع القوم خطب المطلب بن عبد مناف فقال: ” نحن وفد بيت اللّه الحرام، والمشاعر العظام، وإلينا سعت الأقدام، وأنتم تعلمون شرفنا وسؤددنا، وما خصّنا به اللّه من النور الساطع والضياء اللامع، ونحن بنو لؤي بن غالب، قد انتقل هذا النور إلى عبد مناف، ثُمّ إلى أخينا هاشم، وهو معنا من آدم (عليه السلام)، وقد ساقه اللّه إليكم، وأقدمه عليكم، فنحن لكريمتكم خاطبون، وفيكم راغبون “.
فأجابه عمرو ـ أبو سلمى ـ بالقبول والإنعام، وساقوا المهر كما أرادوا.
ولمّا تزوّج منها هاشم، ودخل بها، وحملت بعبد المطلب انتقل إليها النور، وما زالت تسمع البشائر بولادة خير البشر فأفزعها ذلك، إلاّ أنّ هاشماً عرّفها أمر النّبي.
فلمّا ولدت عبد المطلب كان يدعى (شيبة الحمد) ; لكثرة حمد الناس له، لكونه مفزع قريش في النوائب، وملجأهم في الأُمور، فكان شريف قومه وسيّدهم كمالاً ورفعةً، غير مدافع عن ذلك، وهو من حلماء قريش وحكمائها.
وقد سنّ أشياءَ أمضاها له الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، ووجد كنزاً أخرج خمسه وتصدّق به، وسنّ في القتل مائة من الإبل، ولم يكن للطواف عدد عند قريش. فسنّه سبعة أشواط، وقطع يد السارق، وحرّم الخمر والزنا، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يستقسم بالأزلام، ولا يؤكل ما ذبح على النصب.
ومما يؤثر عنه: ” الظلوم لن يخرج من الدنيا حتّى ينتقم منه، وإنّ وراء هذا الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإذا لم تصب الظلوم في الدنيا عقوبة فهي معدة له في الآخرة “.
وقيل له: الفيّاض ; لكثرة جوده ونائله، حتّى إنّ مائدته يأكل منها الراكب، ثُمّ ترفع إلى جبل أبي قبيس لتأكل منها الطير والوحوش.
ولعزّه المنيع وشرفه الباذخ كان يفرش له بإزاء الكعبة، ولم يفرش لأيّ أحد غيره، ولا يجالسه على بساط الأُبهة إلاّ نبيّ العظمة، وإذا أراد أحد أعمامه أن ينحيه صاح به عبد المطلب وقال: ” إنّ له لشأناً وملكاً عظيماً “.
ولا غرو في ذلك بعد أن كان وصيّاً من الأوصياء وقارئاً للكتب السماوية، ولقد أخبر أبو طالب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ” كان أبي
يقرأ الكتب جميعاً ” وقال: ” إنّ من صلبي نبيّاً، لوددت أنّي أدركت ذلك الزمان فآمنت به، فمن أدركه من ولدي فليؤمن به “.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” واللّه ما عَبدَ أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا عبد مناف ولا هاشم صنماً، وإنّما كانوا يعبدون اللّه، ويصلّون إلى البيت على دين إبراهيم، متمسّكين به “.
وكان أبو طالب سيّد البطحاء شبيهاً بأبيه شيبة الحمد، عالماً بما جاء به الأنبياء، وأخبرت به أُممهم من حوادث وملاحم ; لأنّه وصيّ من الأوصياء، وأمين على وصايا الأنبياء حتّى سلّمها إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله).
قال درست بن منصور: قلت لأبي الحسن الأوّل: أكان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) محجوجاً بأبي طالب؟
قال: ” لا، ولكن كان مستودع الوصايا فدفعها إلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ” قلت: دفعها إليه على أنّه محجوج به؟
قال (عليه السلام): ” لو كان محجوجاً به ما دفعها إليه “.
قلت: فما كان حال أبي طالب؟
قال: ” أقرّ بالنّبي وبما جاء به حتّى مات “.
وقال المجلسي: ” أجمعت الشيعة على أنّ أبا طالب لم يعبد صنماً قطّ، وأنّه كان من أوصياء إبراهيم الخليل (عليه السلام) “(1).
وحكى الطبرسي إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك، ووافقه ابن بطريق في كتاب المستدرك.
وقال الصدوق: ” كان عبد المطلب وأبو طالب من أعرف العلماء وأعلمهم بشأن النّبي، وكانا يكتمان ذلك عن الجهّال والكفرة “(2).
وممّا يشهد على أنّه كان على دين التوحيد وملّة إبراهيم، أنّ قريشاً لمّا أبصرت العجائب ليلة ولادة أمير المؤمنين ( عليه السلام)، خصوصاً لما أتوا بالآلهة إلى جبل أبي قبيس ليسكن بهم ما شاهدوه ارتجّ الجبل، وتساقطت الأصنام، ففزعوا إلى أبي طالب ; لأنّه مفزع اللاجىء، وعصمة المستجير، وسألوه عن ذلك، فرفع يديه مبتهلاً إلى المولى جلّ شأنه قائلاً: ” إلهي أسألك بالمحمّدية المحمودة، والعلويّة العالّية، والفاطميّة البيضاء إلاّ تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة، فسكن ما حلّ بهم، وعرفت قريش هذه الأسماء قبل ظهورها، فكانت العرب تكتب هذه الأسماء وتدعو بها عند المهمات، وهي لا تعرف حقيقتها “(3).
ومن هنا اعتمد عليه عبد المطلب في كفالة الرسول وخصّه به دون بنيه وقال:
وصيّت من كنيّته بطالّب… عبدَ مناف وهو ذو تجارّب
بابنِ الحبيّبِ أكرمِ الأقارّب… بابن الّذي قَدْ غابَ غيرَ آئب
فقال أبو طالب:
لا تُوصني بلازم وواجب… إنّي سمعتُ أعجبَ العجائبِ
من كُلّ حبر عالم وكاتب… بأنّ بحمّد اللّه قول الراهبِ
فقال عبد المطلب: ” أُنظر يا أبا طالب أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الّذي لم يَشمّ رائحة أبيه، ولم يذق شفقة أُمّه، أُنظر أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك، فإنّي قد تركت بنيّ كُلّهم وخصصتك به، لأنّك من أُمّ أبيه، وأعلم فإنّ استطعت أن تتبعه فافعل، وانصره بلسانك ويدك ومالك، فإنّه واللّه سيسودكم ويملك ما لا يملك أحد من آبائي، هل قبلت وصيّتي “؟
قال: ” نعم، قد قبلتُ، واللّه على ذلكِ شاهد “.
فقال عبد المطلب: ” الآن خُفّف عليَّ الموت “، ولم يزل يقبّله ويقول: ” اشهد أنّي لم أر أحداً في ولدي أطيب ريحاً منك ولا أحسن وجهاً “.
وفرح أبو طالب بهذه الحظوة من أبيه العطوف، وراح يدّخر لنفسه السعادة الخالدة بكفالة نبيّ الرحمة، فقام بأمره، وحماه في صغره بماله وجاهه من اليهود والعرب وقريش، وكان يؤثره على أهله ونفسه، وكيف لا يؤثره وهو يشاهد من ابن أخيه ولمّا يبلغ التاسعة من عمره هيكل القدس يملأ الدست هيبةً ورجاحة، أكثر ضحكه الابتسام، ويأنس بالوحدة أكثر من الاجتماع.
وإذا وضع له الطعام والشراب لا يتناول منه شيئاً إلاّ قال: ” بسم اللّه الأحد “، وإذا فرغ من الطعام حمِد اللّه وأثنى عليه، وإن رصده في نومه شاهد النور يسطع من رأسه إلى عنان السماء.
وكان يوماً معه بذي المجاز، فعطش أبو طالب ولم يجد الماء، فجاء النّبي إلى صخرة هناك وركلها برجله، فنبع من تحتها الماء العذب. وزاد على ذلك توفر الطعام القليل في بيته حتّى إنّه يكفي الجمع الكثير إذا تناول النّبي منه شيئاً.
وهذا وحده كاف للإِذعان بأن أبا طالب كان على يقين من نبوة ابن أخيه محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
أضف إلى ذلك قوله في خطبته لما أراد أن يزوّجه من خديجة: ” وهو واللّه بعد هذا له نبأ عظيم، وخطر جليل “(4).
وفي وصيته لقريش: ” إنّي أوصيكم بمحمّد خيراً، فإنّه الأمين في قريش، والصدّيق في العرب، وهو الجامع لكُلّ ما أوصاكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان “.
ولمّا جاء العبّاس بن عبد المطلّب يخبره بتألّب قُريش على معاداة الرسول قال له: ” إنّ أبي أخبرني أنّ الرسول على حقٍّ، ولا يضرّه ما عليه قريش من معاداة له، وإنّ أبي كان يقرأ الكتب جميعاً، وقال: إنّ من صلبي نبيّاً لوددت أنّي أدركته فآمنت به، فمن أدركه فليؤمن به “.
واستشهاده بكلمة أبيه القارئ للكتب، مع أنّه كان يقرؤها مثله، يدلّنا على تفنّنه في تنسيق القياس وإقامة البرهان على صحة النبوّة، وأنّ الواجب اعتناق شريعته الحقّة.
أمّا هو نفسه فعلى يقين من أنّ رسالة ابن أخيه خاتمة الرسل، وهو أفضل من تقدّمه قبل أن يشرق نور النبوّة على وجه البسيطة، ولم تجهل لديه صفات النّبي المبعوث.
وعلى هذا الأساس أخبر بعض أهلِ العلم من الأحبار حينما أسرّ إليه بأنّ ابن أخيه محمّداً الروح الطيّبة، والنّبي المطهّر على لسان التوراة والانجيل، فاستكتمه أبو طالب الحديث كي لا يفشوا الخبر، ثمّ قال له: ” إنّ أبي أخبرني أنّه النّبي المبعوث، وأمر أنْ أستر ذلك لئلا يغرى به الأعادي “.
ولو لم يكن معتقداً صدق الدعوة لما قال لأخيه حمزة لما أظهر الإسلام.
فصَبْراً أبا يَعلى على دينِ أحمد… وكُنْ مظهراً للدين وُفّقت صابراً
وحطْ من أتى بالدين من عندِ ربِّه…بصدق وحقّ لا تكن حمز كافراً
فقد سرّني إذ قلت إنّك مُؤمن …فكنْ لرسولِ اللّهِ في اللّهِ ناصرا
ونادِ قُريشاً بالذي قَدْ أتيته… جهاراً وقُلّ ما كان أحمدَ ساحرا
وقال راداً على قريش:
أَلَمْ تَعْلَموا أنّا وجدنا محمّداً… نبيّاً كموسى خطَّ في أوّل الكتّب
وقال:
وأَمسى ابنُ عبدِ اللّهِ فينا مُصدّقاً… على سخط من قَومنا غيرَ معتّب
وقال:
أمينٌ محبّ في العبادِ مسوّم… بخاتمِ ربِّ قاهر للخواتمِ
يرى الناسُ بُرهاناً عليه وهيْبة… وما جاهل في فعلهِ مثل عالمِ
نبيّ أتاه الوحي من عندِ ربِّه … فمَن قال لا يقرع بها سنّ نادم
وممّا خاطب به النجاشي:
أتدري خيارُ الناسِ أنّ محمّداً …وزيرٌ لموسى والمسيّح بن مريَم
أتى بالهدى مثَلَ الذي أتيَا بهِ … فكُلٌ بأمر اللّه يهدي ويَعصِمُ
وإنّكم تتلونه في كتابكم … بِصدقِ حديث لا حديثَ المُترجم
فلا تجعلوا للّهِ نداً وأسلموا… فإنّ طريق الحقِّ ليس بمُظلِمِ
وقال:
اذهب بُنيّ فمَا عليكَ غَضاضَة… اذهب وقرّ بذاك مِنك عيونا
واللّه لن يَصلوا إليكَ بجمعهِم … حتّى أُوسدَ في التّراب دفينا
ودعوتني وعلمتُ أنّكَ ناصحي… ولقد صدقتَ وكُنتَ قَبلُ أمينا
وذكرتَ ديناً لا محالة أنّه …من خير أديانِ البريّة دينا
وبعد هذه المصارحة هل يخالج الريبُ أحداً في إيمان أبي طالب؟ وهل يجوز لمن يقول: ” إنّا وجدنا محمّداً كموسى نبياً ” إلاّ الاعتراف بنبوته والإقرار برسالته كالأنبياء المتقدّمين؟ وهل يكون إقرار بالنبوّة أبلغ من قوله: ” فأمسى ابن عبد اللّه فينا مصدقاً “؟ وهل فرق بين أن يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وبين أن يقول:
وإن كانَ أحمد قَدْ جاءَهم …بصدق ولم يتّهم بالكَذِب
أَوَ يعترف الرجل بأنّ محمّداً كموسى وعيسى جاء بالهدى والرشاد مثل ما أتيا به ثُمّ يحكم عليه بالكفر؟! وهل هناك جملة يعبّر بها عن الإسلام أصرح من قول المسلم:
وذكرت ديناً لا محالة أنّه …من خيرِ أديان البرية ديناً؟
كلاّ! ولو لم يعرف أبو طالب من ابن أخيه الصدق فيما أخبر به لما قال له بمحضر قريش ليريهم من فضله وهو به خبير وبنبوّتِهِ مؤمن: ” يا بن أخي اللّه أرسلك “؟
قال: ” نعم “.
قال: ” إنّ للأنبياء معجزة وخرق عادة فأرنا آية “؟
قال (صلى الله عليه وآله): ” يا عم ادعُ تلك الشجرة وقل لها: يقول لك محمّد بن عبد اللّه: أقبلي بإذن اللّه “! فدعاها أبو طالب فأقبلت حتّى سجدت بين يديه، ثُمّ أمرها بالانصراف فانصرفت، فقال أبوطالب: ” أشهد أنّك صادق “، ثُمّ قال لابنه علي (عليه السلام): ” يا بنيّ الزَمْه “.
وقال يوماً لعلي: ” ما هذا الذي أنت عليه “؟
قال: ” يا أبة آمنت باللّه ورسوله، وصدّقت بما جاء به، ودخلت معه واتبعته “. فقال أبو طالب: ” أما إنّه لا يدعوك إلاّ إلى خير فالزمه “.
وهل يجد الباحث بعد هذا كُلّه ملتحداً عن الجزم بأنّ شيخ الأبطح كان معتنقاً للدّين الحنيف، ويكافح طواغيت قريش حتّى بالإِتمام مع النّبي في صلابة، وإن أهمله فريق من المؤرّخين رعاية لما هم عليه من حبّ الوقيعة في أبي طالب ورميه وقذفه بما ليس فيه، حنقاً على ولده (الإِمام) الذي لم يتسنّ لهم أي غميزة فيه، فتحاملوا على أُمّه وأبيه، إيذاءً له، واكثاراً لنظائر من يرومون إكباره وإجلاله ممّن سبق منهم الكفر، وحيث لم يسعهم الحطُّ من كرامة النّبي أو الوصيّ عمدوا إلى أبويهما الكريمين فعزوا إليهما الطامات، وربما ستروا ما يؤثر عنهما من الفضائل إيثاراً لما يروقهم اثباته!!
ويشهد لذلك ما ذكره بعض الكتّاب عند ذكر أسرى بدر فقال: ” وكان من الأسرى عمِّ النّبي، وعقيل ابن عمه (أخو علي) “.
فإنّه لو كان غرضه تعريف المأسور لكان في تعريف عقيل بأنّه ابن عمّ النّبي كفاية، كما اكتفى في تعريف العبّاس بأنّه عَمُّ النّبي، ولم يحتج أن يكتب بين قوسين (أخو علي)، وأنت تعرف المراد من ذكر هذه الكلمة بين قوسين، وإلى أيّ شيء يرمز بها الكاتب، ولكن فاته الغرض وهيهات الذي أراد ففشل.
ثُمّ جاء فريق آخر من المؤرّخين يحسبون حصر المصادر في ذوي الأغراض المستهدفة، وأنّ ما جاءوا به حقائق راهنة، فاقتصر على مرويّاتهم ممّا دبّ ودرج، وفيها الخرافات وما أوحته إليهم الأهواء والنوايا السيئة، ومن هنا أُهملت حقائق ورويت أباطيل.
فعزوا إلى أبي طالب قوله: ” إنّي لا أحبّ أن تعلوني أستي “! ثُمّ رووا عنه أنّه قال لرسول اللّه: ” ما هذا الدّين “؟
قال رسول اللّه: ” دين اللّه، ودين ملائكته ورسله، ودين أبينا إبراهيم، بعثني اللّه به إلى العباد، وأنت أحقّ من دعوته إلى الهدى وأحقّ من أجابني “.
فقال أبو طالب: ” إنّي لا استطيع أن أُفارق ديني ودين آبائي، واللّه لا يخلص إليك من قريش شيء تكرهه ما حييت “(1).
فحسبوا من هذا الكلام أنّ أبا طالب ممّن يعبد الأوثان، كيف! وهو على التوحيد أدلّ!
وجوابه: هذا من أنفس التورية وأبلغ المحاورة، فإنّ مراده من قوله لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عقيب قوله: ” أنت أحق من دعوته “: ” إنّي لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي ” الاعتراف بإيمانه، وأنّه باق على الملّة البيضاء، وحنيفية إبراهيم الخليل الذي هو دين الحقّ والهدى، وهو دينه ودين آبائه، ثُمّ زاد أبو طالب في تطمين النّبي بالمدافعة عنه مهما كان باقياً في الدنيا.
نعم، من لا خبرة له بأساليب الكلام وخواصّ التورية يحسب أنّ أبا طالب أراد بقوله: ” إنّي لا أُفارق ديني… إلى آخره ” الخضوع للأصنام، فصفق طرباً، واختال مرحاً.
وجاء الآخر يعتذر عنه بأنّه كان يراعي بقوله هذا الموافقة لقريش، ليتمكّن من كلاءة النّبي وتمشية دعوته.
نحن لا ننكر أنّ شيخ الأبطح كان يلاحظ شيئاً من ذلك ويروقه مداراة القوم في ما يمسّ بكرامة الرسول للحصول على غايته الثمينة، لكنّا لا نوافقهم في كلّ ما يقولون: من انسلاله عن الدّين الحنيف إنسلالاً باتاً، فإنّه خلاف الثابت من سيرته حتّى عند رواة تلكم المخزيات، ومهملي الحقائق الناصعة، حذراً عمّا لا يلائم خطتهم، فلقد كان يراغم أُولئك الطواغيت بما هو أعظم من التظاهر بالإيمان والائتمام بالصلاة مع النّبي.
وإنّ شعره الطافح بذكر النبوّة والتصديق بها سرت به الركبان، وكذلك أعماله الناجعة حول دعوة الرسالة:
ولولاَ أبُو طَالب وابنُهُُ… لمّا مَثُلَ الّدِين شَخصاً فَقامَا
فَذاكَ بِمَكةَ آوى وحَامَا …وهذا بيثرِبَ جَسّ الحِمامَا
تَكفّل عَبدُ مُناف بِأمرٍ …وأَودىَ فَكَان عليٌ تَمامَا
فللِّه ذا فَاتِحُ للهُدَى… وللّه ذا للمَعالِي خِتامَا
وما ضَرّ مَجدُ أبي طَالب… عَدو لغا أو جَهولٌ تعامى
وأمّا أمير المؤمنين فيخرس البليغ عن أن يأتي على صفاته، ويقف الكاتب متردّداً وما عساه أن يقول في من قال فيه أبوه أبو طالب، لمّا فزعت قريش إليه ليلة ولادة أمير المؤمنين إذا أبصروا عجائب لم يروها ولم يسمعوا بها:
” أيّها الناس سيظهر في هذه الليلة وليّ من أولياء اللّه، يكمّل فيه خصال الخير، ويتمّ به الوصيّين، وهو إمام المتقين، وناصر الدّين، وقامع المشركين، وغيظ المنافقين، وزين العابدين، ووصيّ رسول ربِّ العالمين، إمام هدىً، ونجم علا، ومصباح دجىً، ومبيد الشرك والشبهات، وهو نفس اليقين “،ولم يزل يكرّر هذا القول وهو يتخلّل سكك مكة وأسواقها حتّى أصبح.
ويقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): ” ضربة علي عمرو بن ود تعدل عِبادة الثقلين “، وقال يوم خيبر: ” لأعطينّ الراية رجلاً يُحبّ اللّه ورسوله ويحبّه اللّه ورسوله، لا يرجع حتّى يفتح على يديه فأعطاها لعلي (عليه السلام)، وكان الفتح على يده “.
وبعد هذا فلنقف عن الاتيان بما أودع اللّه فيه من نفسيات وغرائز، شكرها لَهُ الإسلام.
نعم، يجب أن نلفت القارئ إلى شيء أكثر البحث فيه رواة الحديث وهو: الإسلام حال الصغر، وتردّدت الكلمة في الجوامع، وتضاربت فيها الأقوال، ولا يهمنا إطالة القول فيها:
1 ـ فإنّا لا نقول: إنّ أمير المؤمنين أوّل من آمن وإن كان هو أوّل من وافق الرسول على مبدأ الإسلام لمّا صدع بالأمر، ولكنّا نقول: متى ” كفر ” علي حتّى يؤمن!! وإنّما كان هو وصاحب الدعوة الإلهية عارفين بالدّين وتعاليمه، معتنقين له، منذ كيانهما في عالم الأنوار قبل خلق الخلق، غير أنّ ذلك العالم مبدأ الفيض الأقدس ووجودهما الخارجي مجراه، فمحمّد نبيّ وعلي وصيّ وآدم بين الماء والطين صلّى اللّه عليهم أجمعين.
2 ـ على أنّ نبيّ الإسلام، وهو العارف بأحكامه، والذي خطّط لنا التكاليف قبل إسلام ابن عمِّه، وأنجز له جميع ما وعده به من الإخوّة والوصاية والخلافة، يوم أجاب دعوته وآزره على هذا الأمرّ وقد أُحجم عنه عندما نزلت آية: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}.
وهل ترى أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يومئذ يجد في شريعته عدم الجدوى بإسلام مثل علي (عليه السلام) لصغره، إلاّ أنّه حاباه، كلاّ وحاشا…!
وإنّما قابله بكلّ ترحيب، وخوّله ما لا يخوّل أحداً صحة إسلامه عنده، بحيث كان على أساس رصين، فاتخذه ردءاً، كمن اعتنق الدين عن قلب شاعر، ولبّ راجح، وعقلية ناضجة يغتنم بذلك محاماته ومرضاة أبيه في المستقبل:
وإذا أكبرنا النّبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كلّ مداهنة ومصانعة، فلا نجد مسرحاً في المقام لأيّ مقال إلاّ أن نقول: إنّ إسلام علي (عليه السلام)كان عن بصيرة وثبات مقبول عند اللّه ورسوله وكان ممدوحاً منهما عليه.
كما تمدّح بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) غير مرّة وهو أعرف الأُمّة بتعاليم الدّين بعد النّبي الكريم فقال: ” أنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي الاّ كاذب مفتر، صلّيت مع رسول اللّه قبل الناس بسبع سنين “.
وقال له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): ” أنت أوّل المؤمنين إيماناً واسلاماً “، كما مدحته الصحابة بذلك، وهم أبصر من غيرهم يوم كانوا يغترفون من مستقى العلم ومنبع الدين.
وعلى هذا الأساس تظافر الثناء عليه من العلماء والمؤلّفين والشعراء وسائر طبقات الأُمّة بأنّه أوّل من أسلم، لكن هناك ضالع في سيره حسب شيئاً فخانته هاجسته وهوى إلى مدحره الباطل فقال: إنّ علياً أسلم وهو صغير!! يريد بذلك الحطّ من مقامه وليس هناك.
3 ـ ولو تنازلنا عن جميع ذلك فمن أين علمنا أن اشتراط البلوغ في التكليف كان مشروعاً في أوّل البعثة، فلعلّه كبقية الأحكام التدريجية نزل به الوحي فيما بعد، ولقد حكى الخفاجي في شرح الشفا ج3 ص125 في باب دعاء النّبي على صبي عن البرهان الحلبي والسبكي: أنّ اشتراط الأحكام بالبلوغ إنّما كان بعد واقعة أحد، وعن غيرهما أنّه بعد الهجرة، وفي السيرة الحلبية ج1 ص304 أنّ الصبيان يومئذ مكلّفون وإنّما رفع القلم عن الصبي عام خيبر. وعن البيهقي أنّ الأحكام إنّما تعلّقت بالبلوغ في عام الخندق أو الحديبية وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز.
4 ـ على أنَّا معاشر الإمامية نعتقد في أئمة الدّين بأنّهم حاملو أعباء الحجة، متحلون بحلي الفضائل كلها، منذ الولادة، كما بُعِثَ عيسى في المهد نبيا، وأوتي الحكم يحيى صبيا، غير أنهم بين مأمور بالكلام أو مأمور بالسكوت حتى يأتي أوانه، فلهم أحكام خاصة غير أحكام الرعية، ومن أقلها قبول إجابة الدعوة ونحوها.
إذن، فلا مساغ لأي أحد البحث في المسألة.
هذه هي السلسلة الذهبية التي تحلّى بها أبو الفضل وهي (آباؤه الأكارم)، وقد اتحد مع كل حلقة منها الجوهر الفرد، لاثارة الفضائل، فما منهم إلا من أخذ بعضادتي الشرف، وملك أزِمّة المجد والخطر، قد ضم إلى طيب المحتد عظمة الزعامة، وإلى طهارة العنصر نزاهة الإيمان، فلا ترى أياًّ منهم إلا منار هدى، وبحر ندى، ومثال تقى، وداعية إلى التوحيد وإلى بسالة وبطولة وإباء وشمم، وهم الذين عرقوا في سيدنا العباس (عليه السلام) هذه الفضائل كلها، وإن كان القلم يقف عند انتهاء السلسلة إلى أمير المؤمنين، فلا يدري اليراع ما يخط من صفات الجلال والجمال، وأنه كيف عرفها في ولده المحبوب (قمر الهاشميين).
نشأته
مما لا شك فيه أن لنفسيات الآباء ونزعاتهم وكمياتهم من العلم والخطر أو الانحطاط والضعة دخلا تاما في نشأة الأولاد وتربيتهم، إن لم نقل إن مقتضاهما هو العامل الوحيد في تكيف نفسيات الناشئة، بكيفيات فاضلة أو رذيلة، فلا يكاد يرتأي صاحب أي خطة إلا أن يكون خلفه على خطته، ولا أن الخلف يتحرى غير ما وجد عليه سلفه، ولذلك تجد في الغالب مشاكلة بين الجيل الأول والثاني في العادات والأهواء والمعارف والعلوم، اللهم إلا أن يسود هناك تطور يكبح ذلك الاقتضاء.
وعلى هذا الأساس يسعنا أن نعرف مقدار ما عليه أبو الفضل (عليه السلام) من العلم والمعرفة وحسن التربية بنشوئه في البيت العلوي، منبثق أنوار العلم، ومحط أسرار اللاهوت، ومستودع علم الغيب، فهو بيت العلم والعمل، بيت الجهاد والورع، بيت المعرفة والإيمان:
بيت علا سمك الضراح رفعة… فكان أعلى شرفا وأمنعا
أعزّه الله فما تهبطُ في… كعبتِه الأملاكُ إلا خُضّعا
بيت من القدس وناهيك به… محط أسرار الهدى وموضعا
وكان مأوى المرتجي والملتجى… فما أعز شأنه وأرفعا
وبسيف صاحب هذا البيت المنيع انجلت غواشي الإلحاد، وببيانه تقشعت غيوم الشبه والأوهام، إذن، فطبع الحال يدلنا على أن سيد الأوصياء لم يبغَ بابنه بدلا في حسن التربية الإلهية، ولا أن شظية الخلافة يروقه غير اقتصاص أثر أبيه الأقدس، فلك هاهنا أن تحدث عن بقية أمير المؤمنين في أي ناحية من نواحي الفضيلة، ولا حرج.
لم تكن كل البصائر في أبي الفضل (عليه السلام) اكتسابية، بل كان مجبولاً من طينة القداسة التي مزيجها النور الإلهي، حتى تكونت في صلب من هو مثال الحق، ذلك الذي لو كشف عنه الغطاء ما ازداد يقينا، فلم يصل أبو الفضل (عليه السلام) إلى عالم الوجود إلا وهو معدن الذكاء والفطنة، وأذن واعية للمعارف الإلهية، ومادة قابلة لصور الفضائل كلها، فاحتضنه حجر العلم والعمل، حجر اليقين والإيمان، وعادت أرومته الطيبة هيكلا للتوحيد، يغذيه أبوه بالمعرفة، فتشرق عليه أنوار الملكوت، وأسرار اللاهوت، وتهب عليه نسمات الغيب، فيستنشق منها الحقائق.
دعاه أبوه (عليه السلام) في عهد الصبا وأجلسه في حجره وقال له:
” قل واحد! فقال: واحد، فقال له: قل إثنين! قال: استحي أن أقول إثنين بلسانٍ قلت بهِ واحدا “.
وإذا أمعنا النظر في هذه الكلمة ـ وهو على عهد نعومة أظفاره في حين أن نظراءه في السن لا يبلغون إلى ما هو دون ذلك الشأو البعيد ـ فلا نجد بداً من البخوع بأنها من أشعة تلك الإشراقات الإلهية، فما ظنك إذن حينما يلتقي مع المبادئ الفياضة من أبيه سيد الوصيين، وأخويه الإمامين سيدي شباب أهل الجنة، فلا يقتني من خزائن معارفهم إلا كل در ثمين، ودري لامع.
وغير خفي ما أراده سيدنا العباس، فإنه أشار إلى أن الوحدانية لا تليق إلا بفاطر السموات والأرضين، ويجل مثله المتفرع من دوح الإمامة أن يجري على لسانه الناطق بالوحدانية لباري الأشياء صفة تنزه عنها سبحانه وتعالى وعنها ينطق كتابه المجيد: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }.
ومما زاد في سرور أبيه أمير المؤمنين أن زينب العقيلة كانت حاضرة حينذاك وهي صغيرة فقالت لأبيها أتحبنا؟ قال: بلى، فقالت: لا يجتمع حبان في قلب مؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان ولا بد فالحب لله تعالى والشفقة للأولاد، فأعجبه كلامها وزاد في حبه وعطفه عليهما.
أما العلم ; فهو رضيع لبانه، وناهيك في حجر أبيه مدرسة يتخرج منها مثل أبي الفضل (عليه السلام)! وما ظنك بهذا التلميذ المصاغ من جوهر الاستعداد، وذلك الأستاذ الذي هو عيبة العلم الإلهي، ومستودع أسرار النبوة، وهو المشيّد لنشر المعارف الربوبية، وتعلم الأخلاق الفاضلة، ونشر أحكام الإسلام، ودحض الأوهام والوساوس.
وإذا كان الإمام (عليه السلام) يربي البعداء الأجانب بتلك التربية الصحيحة المأثورة، حتى استفادوا منه أسرار التكوين، ووقفوا على غامض ما في النشأتين، وكان عندهم بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلايا، كحبيب بن مظاهر، وميثم التمار، ورشيد الهجري، وكميل بن زياد، وأمثالهم ; فهل من المعقول أن يذر قرة عينه، وفلذة كبده خلوا من أي علم؟!
أو أن قابلية المحل تربى بأولئك الأفراد دون سيدنا العباس (عليه السلام)؟
لا والله، ما كان سيد الأوصياء يضن بشيء من علومه، لا سيما على قطعة فؤاده، ولا أن غيره ممن انضوى إلى أبيه علم الهداية يشق له غبارا في القابلية والاستعداد.
فهنالك التقى مبدأ فياض، ومحل قابل للإفاضة، وقد ارتفعت عامة الموانع، فذلك برهان على أن ” عباس اليقين ” من أوعية العلم، ومن الراسخين فيه.
ثم هلم معنا إلى جامعتين للعلوم الإلهية، ملازمتين للجامعة الأولى في نشر المعارف، وتفانيهما لإفاضة التعاليم الحقة لكل تلميذ، والرقي به إلى أوج العظمة في العلم والعمل، ألا وهما ” كليتا ” السبطين الحسن والحسين (عليهما السلام). وانظر إلى ملازمته لأخويه بعد أبيه سيد الأوصياء، ملازمة الظل لديه، فهناك يتجلى لك أن سماء علمهما لم تهطل نوراً ويقيناً إلا وعاد لؤلؤا رطبا في نفسه، ولا أنفقا شيئا من ذلك الكنز الخالد إلا واتخذه ثروة علمية لا تنفد.
أضف إلى ذلك ما كان يرويه عن عقيلة بيت الوحي، زينب الكبرى، وهي العالمة غير المعلمة بنص الإمام زين العابدين.
وبعد هذا كله، فقد حوى أبو الفضل من صفاء النفس، والجبلّة الطيبة، والعنصر الزاكي، والإخلاص في العمل، والدؤوب على العبادة ; ما يفتح له أبوابا من العلم، ويوقفه على كنوز المعرفة، فيتفرع من كل أصل فرع، وتنحل عنده المشكلات.
وإذا كان الحديث ينص على أن من أخلص لله أربعين صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إذن فما ظنك بمن أخلص لله سبحانه طيلة عمره، وهو متخلٍّ عن كل رذيلة، ومتحلٍّ بكل فضيلة، فهل يبقى إلا أن تكون ذاته المقدسة متجلية بأنوار العلوم والفضائل، وإلا أن يكون علمه تحققا لا تعلقا؟!
وبعد ذلك فما أوشك أن يكون علمه وجدانيا، وإن برع في البرهنة وتنسيق القياس، ومن هنا جاء المأثور عن المعصومين (عليهم السلام): ” إن العباس بن علي زُقّ العلم زَقّا “(.
وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر فرخه حين لم يقو على الغذاء بنفسه، وحيث استعمل الإمام (عليه السلام) ـ وهو العارف بأساليب الكلام ـ هذه اللفظة هنا، نعرف أن أبا الفضل (عليه السلام) كان محل القابلية لتلقي العلوم والمعارف، منذ كان طفلا ورضيعا، كما هو كذلك بلا ريب.
فلم يكن أبو الفضل بدعا من أهل هذا البيت الطاهر الذي حوى العلم المتدفق منذ الصغر، كما شهد بذلك أعداؤهم، ففي الحديث عن الصادق (عليه السلام):
أن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد، فسأله، فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني، قال عثمان: دونك الفتية الذين تراهم، وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، فمضى الرجل نحوهم وسألهم، فقال له الحسن: يا هذا، المسألة لا تحل إلا في ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، أيتها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن بخمسين دينارا، والحسين بتسعة وأربعين دينارا، وعبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين، فانصرف الرجل ومر بعثمان، فحكى له القصة وما أعطوه، فقال له: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية، أولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة.
قال الصدوق بعد الخبر: ” معنى (فطموا العلم): أي قطعوه عن غيرهم وجمعوه لأنفسهم “(1).
وجاء في الأثر: أن يزيد بن معاوية قال في حق السجاد: ” إنه من أهل بيت زقوا العلم زقا “.
ومن أجل ذلك قال العلامة المحقق الفقيه المولى محمد باقر بن المولى محمد حسن بن المولى أسد الله بن الحاج عبد الله بن الحاج علي محمد القائيني، نزيل برجند، في كتاب الكبريت الأحمر ج3 ص45: ” إن العباس من أكابر وأفاضل فقهاء أهل البيت، بل إنه عالم غير متعلم، وليس في ذلك منافاة، لتعليم أبيه (عليه السلام) إياه “.
وكان هذا الشيخ الجليل ثبتا في النقل، منقبا في الحديث، يشهد بذلك كبريته، تتلمذ (رحمه الله) في العراق على الفاضل الإيرواني، وميرزا حبيب الله الرشتي، والسيد الشيرازي، وفي خراسان على السيد مرتضى القائني، والعلامة محمد تقي البجنردي، وكان له أربعة وثلاثون مؤلفا.
ومن مستطرف الأحاديث ما حدثني به الشيخ العلامة ميرزا محمد علي الأردبادي، عن حجة الإسلام السيد ميرزا عبد الهادي آل سيد الأمة الميرزا الشيرازي (قدس سره)، عن العالم البارع السيد ميرزا عبد الحميد البجنردي، أنه شاهد في كربلاء المشرفة رجلا من الأفاضل قد اغتر بعلمه، وبلغ من غلوائه في ذلك أنه كان في منتدى من أصحابه وجرى ذكر أبي الفضل، وما حمله من المعارف، الإلهية التي امتاز بها على سائر الشهداء، فصارح الرجل بأفضليته على العباس! واستغرب من حضر هذه الجرأة، وأنكروا عليه، ولاموه على هذه البادرة، فطفق الرجل يبرهن على تهيئته بتعداد مآثره وعلومه، وما ينوء به من تهجد وتنفل وزهادة، وقال: إن كان أبو الفضل العباس يفضل بأمثال هذه فعنده مثلها، والشهادة يوم الطف لا تقابل ما تحمله من العلوم الدينية وأصولها ونواميسها.
فقام الجماعة من المجلس والرجل على ذلك الغرور والغلواء، غير نادم ولا متهيب.
ولما أصبحوا لم يكن لهم هم إلا معرفة خبر الرجل، وأنه هل بقي على غيه أو أن الهداية الإلهية شملته؟ فقصدوا داره وطرقوا الباب، فقيل لهم: إن الرجل في حرم العباس، فتوجهوا إليه ليستبروا خبره، فإذا الرجل قد ربط نفسه في الضريح الأقدس بحبل شد طرفه بعنقه والآخر بالضريح، وهو تائب نادم مما فرط.
فسألوه عن شأنه وخبره؟ فقال: لما نمت البارحة، وأنا على الحال الذي فارقتكم عليه، رأيت نفسي في مجتمع من أهل الفضل، وإذا رجل دخل النادي وهو يقول: إن أبا الفضل قادم عليكم، فأخذ ذكره من القلوب مأخذا حتى دخل (عليه السلام) والنور الإلهي يسطع من أسارير جبهته، والجمال العلوي يزهو في محياه، فاستقر على كرسي في صدر النادي، والحضور كلهم خاضعون لجلالته، وخصتني من بينهم رهبة عظيمة، وفرق مقلق، لما أتذكره من تفريطي في جنب ولي الله، فطفق (عليه السلام) يحيي أهل النادي واحدا واحدا حتى وصلت النوبة إلي.
ثم قال لي: ماذا تقول أنت؟ فكاد أن يرتج علي القول، ثم راجعت نفسي وقلت: في المصارحة منتدحا عن الارتباك وفوزا بالحقيقة، فأنهيت إليه ما ذكرته لكم بالأمس من البرهنة.
فقال (عليه السلام): أما أنا فقد درست عند أبي أمير المؤمنين وأخوي الإمامين الحسن والحسين (عليهما السلام)، وأنا على يقين من ديني بما تلقيته من مشيختي من الحقائق وتعاليم الإسلام، وأنت شاك في دينك، شاك في إمامك، أليس الأمر هكذا؟ فلم يسعني إنكار ما يقوله.
ثم قال (عليه السلام): وأما شيخك الذي قرأت عليه، وأخذت منه فهو أتعس منك حالا، وما عسى أن يكون عندك من أصول وقواعد مضروبة للجاهل بالأحكام، يعمل بها إذا أعوزه الوصول إلى الواقع، وإني غير محتاج إليها، لمعرفتي بواقع الأحكام من مصدر الوحي الإلهي.
ثم قال (عليه السلام): وفي نفسيات كريمة، وأخذ يعددها: من كرم، وصبر، ومواساة، وجهاد إلى غيرها، ولو قسمت على جميعكم لما أمكنك حمل شيء منها.
على أن فيك ملكات رذيلة من حسد، ومراء، ورياء، ثم ضرب بيده الشريفة على فم الرجل، فانتبه فزعا نادما، معترفا بالتقصير، ولم يجد منتدحا إلا بالتوسل به، والإنابة إليه، صلوات الله عليه وعلى آبائه.
وعلى هذا الأساس يسعنا أن نعرف مقدار ما عليه أبو الفضل (عليه السلام) من العلم والمعرفة وحسن التربية بنشوئه في البيت العلوي، منبثق أنوار العلم، ومحط أسرار اللاهوت، ومستودع علم الغيب، فهو بيت العلم والعمل، بيت الجهاد والورع، بيت المعرفة والإيمان:
بيت علا سمك الضراح رفعة… فكان أعلى شرفا وأمنعا
أعزّه الله فما تهبطُ في… كعبتِه الأملاكُ إلا خُضّعا
بيت من القدس وناهيك به… محط أسرار الهدى وموضعا
وكان مأوى المرتجي والملتجى… فما أعز شأنه وأرفعا
وبسيف صاحب هذا البيت المنيع انجلت غواشي الإلحاد، وببيانه تقشعت غيوم الشبه والأوهام، إذن، فطبع الحال يدلنا على أن سيد الأوصياء لم يبغَ بابنه بدلا في حسن التربية الإلهية، ولا أن شظية الخلافة يروقه غير اقتصاص أثر أبيه الأقدس، فلك هاهنا أن تحدث عن بقية أمير المؤمنين في أي ناحية من نواحي الفضيلة، ولا حرج.
لم تكن كل البصائر في أبي الفضل (عليه السلام) اكتسابية، بل كان مجبولاً من طينة القداسة التي مزيجها النور الإلهي، حتى تكونت في صلب من هو مثال الحق، ذلك الذي لو كشف عنه الغطاء ما ازداد يقينا، فلم يصل أبو الفضل (عليه السلام) إلى عالم الوجود إلا وهو معدن الذكاء والفطنة، وأذن واعية للمعارف الإلهية، ومادة قابلة لصور الفضائل كلها، فاحتضنه حجر العلم والعمل، حجر اليقين والإيمان، وعادت أرومته الطيبة هيكلا للتوحيد، يغذيه أبوه بالمعرفة، فتشرق عليه أنوار الملكوت، وأسرار اللاهوت، وتهب عليه نسمات الغيب، فيستنشق منها الحقائق.
دعاه أبوه (عليه السلام) في عهد الصبا وأجلسه في حجره وقال له:
” قل واحد! فقال: واحد، فقال له: قل إثنين! قال: استحي أن أقول إثنين بلسانٍ قلت بهِ واحدا “.
وإذا أمعنا النظر في هذه الكلمة ـ وهو على عهد نعومة أظفاره في حين أن نظراءه في السن لا يبلغون إلى ما هو دون ذلك الشأو البعيد ـ فلا نجد بداً من البخوع بأنها من أشعة تلك الإشراقات الإلهية، فما ظنك إذن حينما يلتقي مع المبادئ الفياضة من أبيه سيد الوصيين، وأخويه الإمامين سيدي شباب أهل الجنة، فلا يقتني من خزائن معارفهم إلا كل در ثمين، ودري لامع.
وغير خفي ما أراده سيدنا العباس، فإنه أشار إلى أن الوحدانية لا تليق إلا بفاطر السموات والأرضين، ويجل مثله المتفرع من دوح الإمامة أن يجري على لسانه الناطق بالوحدانية لباري الأشياء صفة تنزه عنها سبحانه وتعالى وعنها ينطق كتابه المجيد: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }.
ومما زاد في سرور أبيه أمير المؤمنين أن زينب العقيلة كانت حاضرة حينذاك وهي صغيرة فقالت لأبيها أتحبنا؟ قال: بلى، فقالت: لا يجتمع حبان في قلب مؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان ولا بد فالحب لله تعالى والشفقة للأولاد، فأعجبه كلامها وزاد في حبه وعطفه عليهما.
أما العلم ; فهو رضيع لبانه، وناهيك في حجر أبيه مدرسة يتخرج منها مثل أبي الفضل (عليه السلام)! وما ظنك بهذا التلميذ المصاغ من جوهر الاستعداد، وذلك الأستاذ الذي هو عيبة العلم الإلهي، ومستودع أسرار النبوة، وهو المشيّد لنشر المعارف الربوبية، وتعلم الأخلاق الفاضلة، ونشر أحكام الإسلام، ودحض الأوهام والوساوس.
وإذا كان الإمام (عليه السلام) يربي البعداء الأجانب بتلك التربية الصحيحة المأثورة، حتى استفادوا منه أسرار التكوين، ووقفوا على غامض ما في النشأتين، وكان عندهم بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلايا، كحبيب بن مظاهر، وميثم التمار، ورشيد الهجري، وكميل بن زياد، وأمثالهم ; فهل من المعقول أن يذر قرة عينه، وفلذة كبده خلوا من أي علم؟!
أو أن قابلية المحل تربى بأولئك الأفراد دون سيدنا العباس (عليه السلام)؟
لا والله، ما كان سيد الأوصياء يضن بشيء من علومه، لا سيما على قطعة فؤاده، ولا أن غيره ممن انضوى إلى أبيه علم الهداية يشق له غبارا في القابلية والاستعداد.
فهنالك التقى مبدأ فياض، ومحل قابل للإفاضة، وقد ارتفعت عامة الموانع، فذلك برهان على أن ” عباس اليقين ” من أوعية العلم، ومن الراسخين فيه.
ثم هلم معنا إلى جامعتين للعلوم الإلهية، ملازمتين للجامعة الأولى في نشر المعارف، وتفانيهما لإفاضة التعاليم الحقة لكل تلميذ، والرقي به إلى أوج العظمة في العلم والعمل، ألا وهما ” كليتا ” السبطين الحسن والحسين (عليهما السلام). وانظر إلى ملازمته لأخويه بعد أبيه سيد الأوصياء، ملازمة الظل لديه، فهناك يتجلى لك أن سماء علمهما لم تهطل نوراً ويقيناً إلا وعاد لؤلؤا رطبا في نفسه، ولا أنفقا شيئا من ذلك الكنز الخالد إلا واتخذه ثروة علمية لا تنفد.
أضف إلى ذلك ما كان يرويه عن عقيلة بيت الوحي، زينب الكبرى، وهي العالمة غير المعلمة بنص الإمام زين العابدين.
وبعد هذا كله، فقد حوى أبو الفضل من صفاء النفس، والجبلّة الطيبة، والعنصر الزاكي، والإخلاص في العمل، والدؤوب على العبادة ; ما يفتح له أبوابا من العلم، ويوقفه على كنوز المعرفة، فيتفرع من كل أصل فرع، وتنحل عنده المشكلات.
وإذا كان الحديث ينص على أن من أخلص لله أربعين صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إذن فما ظنك بمن أخلص لله سبحانه طيلة عمره، وهو متخلٍّ عن كل رذيلة، ومتحلٍّ بكل فضيلة، فهل يبقى إلا أن تكون ذاته المقدسة متجلية بأنوار العلوم والفضائل، وإلا أن يكون علمه تحققا لا تعلقا؟!
وبعد ذلك فما أوشك أن يكون علمه وجدانيا، وإن برع في البرهنة وتنسيق القياس، ومن هنا جاء المأثور عن المعصومين (عليهم السلام): ” إن العباس بن علي زُقّ العلم زَقّا “(.
وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر فرخه حين لم يقو على الغذاء بنفسه، وحيث استعمل الإمام (عليه السلام) ـ وهو العارف بأساليب الكلام ـ هذه اللفظة هنا، نعرف أن أبا الفضل (عليه السلام) كان محل القابلية لتلقي العلوم والمعارف، منذ كان طفلا ورضيعا، كما هو كذلك بلا ريب.
فلم يكن أبو الفضل بدعا من أهل هذا البيت الطاهر الذي حوى العلم المتدفق منذ الصغر، كما شهد بذلك أعداؤهم، ففي الحديث عن الصادق (عليه السلام):
أن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد، فسأله، فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني، قال عثمان: دونك الفتية الذين تراهم، وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، فمضى الرجل نحوهم وسألهم، فقال له الحسن: يا هذا، المسألة لا تحل إلا في ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، أيتها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن بخمسين دينارا، والحسين بتسعة وأربعين دينارا، وعبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين، فانصرف الرجل ومر بعثمان، فحكى له القصة وما أعطوه، فقال له: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية، أولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة.
قال الصدوق بعد الخبر: ” معنى (فطموا العلم): أي قطعوه عن غيرهم وجمعوه لأنفسهم “(1).
وجاء في الأثر: أن يزيد بن معاوية قال في حق السجاد: ” إنه من أهل بيت زقوا العلم زقا “.
ومن أجل ذلك قال العلامة المحقق الفقيه المولى محمد باقر بن المولى محمد حسن بن المولى أسد الله بن الحاج عبد الله بن الحاج علي محمد القائيني، نزيل برجند، في كتاب الكبريت الأحمر ج3 ص45: ” إن العباس من أكابر وأفاضل فقهاء أهل البيت، بل إنه عالم غير متعلم، وليس في ذلك منافاة، لتعليم أبيه (عليه السلام) إياه “.
وكان هذا الشيخ الجليل ثبتا في النقل، منقبا في الحديث، يشهد بذلك كبريته، تتلمذ (رحمه الله) في العراق على الفاضل الإيرواني، وميرزا حبيب الله الرشتي، والسيد الشيرازي، وفي خراسان على السيد مرتضى القائني، والعلامة محمد تقي البجنردي، وكان له أربعة وثلاثون مؤلفا.
ومن مستطرف الأحاديث ما حدثني به الشيخ العلامة ميرزا محمد علي الأردبادي، عن حجة الإسلام السيد ميرزا عبد الهادي آل سيد الأمة الميرزا الشيرازي (قدس سره)، عن العالم البارع السيد ميرزا عبد الحميد البجنردي، أنه شاهد في كربلاء المشرفة رجلا من الأفاضل قد اغتر بعلمه، وبلغ من غلوائه في ذلك أنه كان في منتدى من أصحابه وجرى ذكر أبي الفضل، وما حمله من المعارف، الإلهية التي امتاز بها على سائر الشهداء، فصارح الرجل بأفضليته على العباس! واستغرب من حضر هذه الجرأة، وأنكروا عليه، ولاموه على هذه البادرة، فطفق الرجل يبرهن على تهيئته بتعداد مآثره وعلومه، وما ينوء به من تهجد وتنفل وزهادة، وقال: إن كان أبو الفضل العباس يفضل بأمثال هذه فعنده مثلها، والشهادة يوم الطف لا تقابل ما تحمله من العلوم الدينية وأصولها ونواميسها.
فقام الجماعة من المجلس والرجل على ذلك الغرور والغلواء، غير نادم ولا متهيب.
ولما أصبحوا لم يكن لهم هم إلا معرفة خبر الرجل، وأنه هل بقي على غيه أو أن الهداية الإلهية شملته؟ فقصدوا داره وطرقوا الباب، فقيل لهم: إن الرجل في حرم العباس، فتوجهوا إليه ليستبروا خبره، فإذا الرجل قد ربط نفسه في الضريح الأقدس بحبل شد طرفه بعنقه والآخر بالضريح، وهو تائب نادم مما فرط.
فسألوه عن شأنه وخبره؟ فقال: لما نمت البارحة، وأنا على الحال الذي فارقتكم عليه، رأيت نفسي في مجتمع من أهل الفضل، وإذا رجل دخل النادي وهو يقول: إن أبا الفضل قادم عليكم، فأخذ ذكره من القلوب مأخذا حتى دخل (عليه السلام) والنور الإلهي يسطع من أسارير جبهته، والجمال العلوي يزهو في محياه، فاستقر على كرسي في صدر النادي، والحضور كلهم خاضعون لجلالته، وخصتني من بينهم رهبة عظيمة، وفرق مقلق، لما أتذكره من تفريطي في جنب ولي الله، فطفق (عليه السلام) يحيي أهل النادي واحدا واحدا حتى وصلت النوبة إلي.
ثم قال لي: ماذا تقول أنت؟ فكاد أن يرتج علي القول، ثم راجعت نفسي وقلت: في المصارحة منتدحا عن الارتباك وفوزا بالحقيقة، فأنهيت إليه ما ذكرته لكم بالأمس من البرهنة.
فقال (عليه السلام): أما أنا فقد درست عند أبي أمير المؤمنين وأخوي الإمامين الحسن والحسين (عليهما السلام)، وأنا على يقين من ديني بما تلقيته من مشيختي من الحقائق وتعاليم الإسلام، وأنت شاك في دينك، شاك في إمامك، أليس الأمر هكذا؟ فلم يسعني إنكار ما يقوله.
ثم قال (عليه السلام): وأما شيخك الذي قرأت عليه، وأخذت منه فهو أتعس منك حالا، وما عسى أن يكون عندك من أصول وقواعد مضروبة للجاهل بالأحكام، يعمل بها إذا أعوزه الوصول إلى الواقع، وإني غير محتاج إليها، لمعرفتي بواقع الأحكام من مصدر الوحي الإلهي.
ثم قال (عليه السلام): وفي نفسيات كريمة، وأخذ يعددها: من كرم، وصبر، ومواساة، وجهاد إلى غيرها، ولو قسمت على جميعكم لما أمكنك حمل شيء منها.
على أن فيك ملكات رذيلة من حسد، ومراء، ورياء، ثم ضرب بيده الشريفة على فم الرجل، فانتبه فزعا نادما، معترفا بالتقصير، ولم يجد منتدحا إلا بالتوسل به، والإنابة إليه، صلوات الله عليه وعلى آبائه.
كنيته
اشتهر أبو الفضل العباس (عليه السلام) بكنى وألقاب، وصف ببعضها في يوم الطف، والبعض الآخر كان ثابتا له من قبل، فمن كناه:
أبو قربة
لحمله الماء في مشهد الطف غير مرة، وقد سُدّت الشرائع، ومُنِع الورود على ابن المصطفى وعياله، وتناصرت على ذلك أجلاف الكوفة، وأخذوا الاحتياط اللازم، ولكن أبا الفضل لم يرعه جمعهم المتكاثف، ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة، ولا السيوف المجردة، فجاء بالماء وسقى عيال أخيه وصحبه.
أبو القاسم
ولم ينص المؤرخون وأهل النسب على كنيته بأبي القاسم ; إذ لم يذكر أحد أن له ولدا اسمه القاسم.
نعم، خاطبه جابر الأنصاري في زيارة الأربعين بها قال: ” السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا عباس بن علي “، وبما أن هذا الصحابي الكبير المتربي في بيت النبوة والإمامة خبير بالسبب الموجب لهذا الخطاب، فهو أدرى بما يقول.
أبي الفضل
وقد اشتهر بكنيته الثالثة ” أبي الفضل ” من جهة أن له ولدا اسمه الفضل، وكان حريا بها فإن فضله لا يخفى، ونوره لا يطفى. ومن فضائله الجسام نعرف أنه ممن حبس الفضل عليه، ووقف لديه، فهو رضيع لبانه، وركن من أركانه، وإليه يشير شارح ميمية أبي فراس:
بذلتَ أيا عباسُ نفساً نفيسةً … لنصرِ حسينٍ عزّ بالنصرِ من مِثْلِ
أبيتَ التذاذَ الماءِ قبلَ التذاذِهِ … فحُسنُ فِعال المرءِ فَرعٌ عن الأَصْلِ
فأنتَ أخو السبطَينِ في يومِ مَفخرٍ …وفي يومِ بذلِ الماءِ أنتَ أبو الفَضْلِ
أبو قربة
لحمله الماء في مشهد الطف غير مرة، وقد سُدّت الشرائع، ومُنِع الورود على ابن المصطفى وعياله، وتناصرت على ذلك أجلاف الكوفة، وأخذوا الاحتياط اللازم، ولكن أبا الفضل لم يرعه جمعهم المتكاثف، ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة، ولا السيوف المجردة، فجاء بالماء وسقى عيال أخيه وصحبه.
أبو القاسم
ولم ينص المؤرخون وأهل النسب على كنيته بأبي القاسم ; إذ لم يذكر أحد أن له ولدا اسمه القاسم.
نعم، خاطبه جابر الأنصاري في زيارة الأربعين بها قال: ” السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا عباس بن علي “، وبما أن هذا الصحابي الكبير المتربي في بيت النبوة والإمامة خبير بالسبب الموجب لهذا الخطاب، فهو أدرى بما يقول.
أبي الفضل
وقد اشتهر بكنيته الثالثة ” أبي الفضل ” من جهة أن له ولدا اسمه الفضل، وكان حريا بها فإن فضله لا يخفى، ونوره لا يطفى. ومن فضائله الجسام نعرف أنه ممن حبس الفضل عليه، ووقف لديه، فهو رضيع لبانه، وركن من أركانه، وإليه يشير شارح ميمية أبي فراس:
بذلتَ أيا عباسُ نفساً نفيسةً … لنصرِ حسينٍ عزّ بالنصرِ من مِثْلِ
أبيتَ التذاذَ الماءِ قبلَ التذاذِهِ … فحُسنُ فِعال المرءِ فَرعٌ عن الأَصْلِ
فأنتَ أخو السبطَينِ في يومِ مَفخرٍ …وفي يومِ بذلِ الماءِ أنتَ أبو الفَضْلِ
صفاته
لقد كان من لطف المولى سبحانه وتعالى على وليه المقدس، سلالة الخلافة الكبرى، سيد الأوصياء، أن جمع فيه صفات الهيبة من بأس وشجاعة وإباء ونجدة، وخصال الجمال من سؤدد وكرم ودماثة في الخلق، وعطف على الضعيف، كل ذلك من البهجة في المنظر ووضاءة في المحيا من ثغر باسم ووجه طلق تتموج عليه أسارسير الحسن، ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى جبهته أنوار الإيمان.
ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي قيل له: ” قمر بني هاشم “، حيث كان يفوق بجماله كل جميل، وينذ بطلاوة منظره كل أحد، حتى كأنه الفذ في عالم البهاء، والوحيد في دنياه، كالقمر الفائق بنوره أشعة النجوم، وهذا هو حديث الرواة:
” كان العباس رجلا وسيما جميلا، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض، وكان يقال له: قمر بني هاشم “.
وقد وصفته الرواية المحكية في مقاتل الطالبيين بان ” بين عينيه أثر السجود “، ونصها:
” قال المدائني: حدثني أبو غسان هارون بن سعد، عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة، قال: رأيت رجلا من بني أبان بن دارم أسود الوجه، وكنت أعرفه جميلا شديد البياض، فقلت له: ما كدت أعرفك؟ قال: إني قتلت شابا أمرد مع الحسين، بين عينيه أثر السجود، فما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني، فيأخذ بتلابيبي حتى يأتي جهنم، فيدفعني فيها، فأصيح فما يبقى في الحي إلا سمع صياحي. قال: والمقتول هو العباس بن علي (عليه السلام) “.
وروى سبط بن الجوزي عن هشام بن محمد، عن القاسم بن الأصبغ المجاشعي قال: ” لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة، وإذا بفارس قد علق في رقبة فرسه رأس غلام أمرد، كأنه القمر ليلة تمامه، والفرس يمرح، فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض، فقلت: رأس من هذا؟ قال: رأس العباس بن علي، قلت: ومن أنت؟ قال: حرملة بن الكاهل الأسدي.
قال: فلبثت أياما وإذا بحرملة وجهه أشد سوادا من القار، فقلت: رأيتك يوم حملت الرأس وما في العرب أنظر وجها منك، وما أرى اليوم أقبح ولا أسود وجها منك؟ فبكى وقال: والله منذ حملت الرأس وإلى اليوم ما تمر علي ليلة إلا واثنان يأخذان بضبعي، ثم ينتهيان بي إلى نار تؤجج، فيدفعاني فيها وأنا أنكص، فتسفعني كما ترى، ثم مات على أقبح حال “.
ويمنع الإذعان بما في الروايتين من تعريف المقتول بأنه العباس بن علي (عليه السلام)، عدم الالتئام مع كونه شابا أمرد، فإن للعباس يوم مقتله أربعا وثلاثين سنة، والعادة قاضية بعدم كون مثله أمرد، ولم ينص التاريخ على كونه كقيس بن سعد بن عبادة لا طاقة شعر في وجهه.
وفي دار السلام للعلامة النوري ج1 ص114 والكبريت الأحمر ج3 ص52 ما يشهد للاستبعاد، واصلاحه كما في كتاب ” قمر بني هاشم ” ص126 بأنه رأس العباس الأصغر بلا قرينة، مع الشك في حضوره الطف وشهادته، وهذا كاصلاحه بتقدير المقتول: ” أخ العباس ” المنطبق على عثمان الذي له يوم مقتله إحدى وعشرين سنة، أو محمد بن العباس المستشهد على رواية ابن شهرآشوب، فإن كل ذلك من الاجتهاد المحض.
ولعل النظرة الصادقة فيما رواه الصدوق منضما إلى رواية ابن جرير الطبري تساعد على كون المقتول حبيب بن مظاهر.
قال الصدوق: ” وبهذا الاسناد عن عمرو بن سعيد، عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة، قال: قدم علينا رجل من بني أبان بن دارم ممن شهد قتل الحسين، وكان رجلا جميلا شديد البياض، فقلت له: ما كدت أعرفك لتغير لونك؟ قال: قتلت رجلا من أصحاب الحسين، يبصر بين عينيه أثر السجود وجئت برأسه.
فقال القاسم: لقد رأيته على فرس له مرحا، وقد علق الرأس بلبانها، وهو يصيبه بركبتيه، قال: فقلت لأبي: لو أنه رفع الرأس قليلا، أما ترى ما تصنع به الفرس برجليها؟ فقال: يا بني ما يصنع به أشد، لقد حدثني قال: ما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني في منامي، حتى يأخذ بكتفي فيقودني ويقول: انطلق، فينطلق بي إلى جهنم، فيقذف بي، فأصيح، قال: فسمعت جارة له قالت: ما يدعنا ننام شيئا من الليل من صياحه، قال: فقمت في شباب من الحي فأتينا امرأته فسألناها فقالت: قد أبدى على نفسه قد صدقكم “.
وقد اتفقت هذه الروايات الثلاث في الحكاية عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة بما فعل بالرأس الطاهر.
وتفيدنا رواية الصدوق أن المقتول رجل لا شاب، وأنه من أصحاب الحسين (عليه السلام)، ولا إشكال فيها، وإذا وافقنا ابن جرير على أن الرأس المعلق هو رأس حبيب بن مظاهر ـ في حين أن المؤرخين لم يذكروا هذه الفعلة بغيره من الرؤوس الطاهرة ـ أمكننا أن ننسب الاشتباه إلى الروايتين السابقتين، خصوصا بعد ملاحظة ذلك الاستبعاد بالنسبة إلى العباس، وتوقف التصحيح فيهما على الاجتهاد بلا قرينة واضحة.
قال ابن جرير في ج6 ص252 من التاريخ: ” وقاتل قتالا شديدا، فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه فقتله، وكان يقال له: بديل بن صريم من بني عقفان، وحمل عليه آخر من بني تميم فطعنه، فوقع، فذهب ليقوم، فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف، فوقع، ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه، فقال له الحصين: إني لشريكك في قتله! فقال الآخر: والله ما قتله غيري! فقال الحصين: أعطنيه أعقله في عنق فرسي كيما يرى الناس ويعلموا أني شركت في قتله، ثم خذه أنت بعد فامض به إلى عبيد الله بن زياد، فلا حاجة لي فيما تعطاه على قتلك إياه، فأبى عليه، فأصلح قومه فيما بينهما على هذا، فرفع إليه رأس حبيب بن مظاهر، فجال به في العسكر، قد علقه في عنق فرسه، ثم دفعه بعد ذلك إليه، فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر رأس حبيبا فعلقه في لبان فرسه، ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر، فبصر به ابنه القاسم بن حبيب، وهو يومئذ قد راهق، فأقبل مع الفارس، لا يفارقه كلما دخل القصر دخل معه، وإذا خرج خرج معه، فارتاب به، فقال: ما لك يا بني تتبعني؟ قال: لا شيء! قال: بلى يا بني أخبرني؟
قال له: إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي أفتعطينيه حتى أدفنه؟
قال: يا بني لا يرضى الأمير أن يدفن، وأنا أريد أن يثيبني الأمير على قتله ثوابا حسنا!
قال له الغلام: لكن الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب، أما والله لقد قتلته خيرا منك وبكى.
فمكث الغلام حتى إذا أدرك لم يكن له همة إلا اتباع أثر قاتل أبيه ليجد منه غرة فيقتله بأبيه، فلما كان زمان مصعب بن الزبير، وغزا مصعب باجمير ادخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاطه، فأقبل يختلف في طلبه والتماس غرته، فدخل عليه وهو قائل نصف النهار فضربه بسيفه حتى برد… “.
نعم، في رواية الصدوق أن القاسم يسأل أباه عما يفعله الفرس بالرأس فيقول: ” قلت لأبي: لو أنه رفع الرأس.. إلى آخره “.
وهو يدل على حياة الأصبغ ذلك اليوم، وعليه فلم يعرف الوجه في تأخره عن حضور المشهد الكريم، مع مقامه العالي في التشيع، وإخلاصه في الموالاة لأمير المؤمنين وولده المعصومين (عليهم السلام)، ومشاهدته هذا الفعل من الطاغي يدل على عدم حبسه عند ابن زياد كباقي الشيعة الخلص، ولا مخرج عنه إلا بالوفاة قبل تلك الفاجعة العظمى كما هو الظاهر مما ذكره أصحابنا عند ترجمته، من الثناء عليه، والمبالغة في مدحه، وعدم الغمز فيه.
فتلك الجملة: ” قلت لأبي “، لا يعرف من أين جاءت. ولا غرابة في زيادتها بعد طعن أهل السنة فيه كما في اللآلئ المصنوعة ج1 ص213، فإنه بعد أن ذكر حديث الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري ” أنهم أمروا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي “، قال: ” لا يصح الحديث، لأن الأصبغ متروك، لا يساوي فلسا “.
وفيه ص195 ذكر عن ابن عباس حديث الركبان يوم القيامة رسول الله وصالح وحمزة وعلي قال: ” رجال الحديث بين مجهول وبين معروف بعدم الثقة “(2).
ولقد طعنوا في أمثاله من خواص الشيعة بكل ما يتسنى لهم، وما ذكر في تراجمهم يشهد لهذه الدعوى، ولا يتحمل هذا المختصر التبسط في ذكرها، ومراجعة ما كتبه السيد العلامة محمد بن أبي عقيل في ” العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ” ص40 في الباب الثاني فيه كفاية، فإنه ذكر جملة من أتباع أهل البيت طعنوا فيهم بلا سبب إلا لموالاة أمير المؤمنين وولده (عليهم السلام).
ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي قيل له: ” قمر بني هاشم “، حيث كان يفوق بجماله كل جميل، وينذ بطلاوة منظره كل أحد، حتى كأنه الفذ في عالم البهاء، والوحيد في دنياه، كالقمر الفائق بنوره أشعة النجوم، وهذا هو حديث الرواة:
” كان العباس رجلا وسيما جميلا، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض، وكان يقال له: قمر بني هاشم “.
وقد وصفته الرواية المحكية في مقاتل الطالبيين بان ” بين عينيه أثر السجود “، ونصها:
” قال المدائني: حدثني أبو غسان هارون بن سعد، عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة، قال: رأيت رجلا من بني أبان بن دارم أسود الوجه، وكنت أعرفه جميلا شديد البياض، فقلت له: ما كدت أعرفك؟ قال: إني قتلت شابا أمرد مع الحسين، بين عينيه أثر السجود، فما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني، فيأخذ بتلابيبي حتى يأتي جهنم، فيدفعني فيها، فأصيح فما يبقى في الحي إلا سمع صياحي. قال: والمقتول هو العباس بن علي (عليه السلام) “.
وروى سبط بن الجوزي عن هشام بن محمد، عن القاسم بن الأصبغ المجاشعي قال: ” لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة، وإذا بفارس قد علق في رقبة فرسه رأس غلام أمرد، كأنه القمر ليلة تمامه، والفرس يمرح، فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض، فقلت: رأس من هذا؟ قال: رأس العباس بن علي، قلت: ومن أنت؟ قال: حرملة بن الكاهل الأسدي.
قال: فلبثت أياما وإذا بحرملة وجهه أشد سوادا من القار، فقلت: رأيتك يوم حملت الرأس وما في العرب أنظر وجها منك، وما أرى اليوم أقبح ولا أسود وجها منك؟ فبكى وقال: والله منذ حملت الرأس وإلى اليوم ما تمر علي ليلة إلا واثنان يأخذان بضبعي، ثم ينتهيان بي إلى نار تؤجج، فيدفعاني فيها وأنا أنكص، فتسفعني كما ترى، ثم مات على أقبح حال “.
ويمنع الإذعان بما في الروايتين من تعريف المقتول بأنه العباس بن علي (عليه السلام)، عدم الالتئام مع كونه شابا أمرد، فإن للعباس يوم مقتله أربعا وثلاثين سنة، والعادة قاضية بعدم كون مثله أمرد، ولم ينص التاريخ على كونه كقيس بن سعد بن عبادة لا طاقة شعر في وجهه.
وفي دار السلام للعلامة النوري ج1 ص114 والكبريت الأحمر ج3 ص52 ما يشهد للاستبعاد، واصلاحه كما في كتاب ” قمر بني هاشم ” ص126 بأنه رأس العباس الأصغر بلا قرينة، مع الشك في حضوره الطف وشهادته، وهذا كاصلاحه بتقدير المقتول: ” أخ العباس ” المنطبق على عثمان الذي له يوم مقتله إحدى وعشرين سنة، أو محمد بن العباس المستشهد على رواية ابن شهرآشوب، فإن كل ذلك من الاجتهاد المحض.
ولعل النظرة الصادقة فيما رواه الصدوق منضما إلى رواية ابن جرير الطبري تساعد على كون المقتول حبيب بن مظاهر.
قال الصدوق: ” وبهذا الاسناد عن عمرو بن سعيد، عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة، قال: قدم علينا رجل من بني أبان بن دارم ممن شهد قتل الحسين، وكان رجلا جميلا شديد البياض، فقلت له: ما كدت أعرفك لتغير لونك؟ قال: قتلت رجلا من أصحاب الحسين، يبصر بين عينيه أثر السجود وجئت برأسه.
فقال القاسم: لقد رأيته على فرس له مرحا، وقد علق الرأس بلبانها، وهو يصيبه بركبتيه، قال: فقلت لأبي: لو أنه رفع الرأس قليلا، أما ترى ما تصنع به الفرس برجليها؟ فقال: يا بني ما يصنع به أشد، لقد حدثني قال: ما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني في منامي، حتى يأخذ بكتفي فيقودني ويقول: انطلق، فينطلق بي إلى جهنم، فيقذف بي، فأصيح، قال: فسمعت جارة له قالت: ما يدعنا ننام شيئا من الليل من صياحه، قال: فقمت في شباب من الحي فأتينا امرأته فسألناها فقالت: قد أبدى على نفسه قد صدقكم “.
وقد اتفقت هذه الروايات الثلاث في الحكاية عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة بما فعل بالرأس الطاهر.
وتفيدنا رواية الصدوق أن المقتول رجل لا شاب، وأنه من أصحاب الحسين (عليه السلام)، ولا إشكال فيها، وإذا وافقنا ابن جرير على أن الرأس المعلق هو رأس حبيب بن مظاهر ـ في حين أن المؤرخين لم يذكروا هذه الفعلة بغيره من الرؤوس الطاهرة ـ أمكننا أن ننسب الاشتباه إلى الروايتين السابقتين، خصوصا بعد ملاحظة ذلك الاستبعاد بالنسبة إلى العباس، وتوقف التصحيح فيهما على الاجتهاد بلا قرينة واضحة.
قال ابن جرير في ج6 ص252 من التاريخ: ” وقاتل قتالا شديدا، فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه فقتله، وكان يقال له: بديل بن صريم من بني عقفان، وحمل عليه آخر من بني تميم فطعنه، فوقع، فذهب ليقوم، فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف، فوقع، ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه، فقال له الحصين: إني لشريكك في قتله! فقال الآخر: والله ما قتله غيري! فقال الحصين: أعطنيه أعقله في عنق فرسي كيما يرى الناس ويعلموا أني شركت في قتله، ثم خذه أنت بعد فامض به إلى عبيد الله بن زياد، فلا حاجة لي فيما تعطاه على قتلك إياه، فأبى عليه، فأصلح قومه فيما بينهما على هذا، فرفع إليه رأس حبيب بن مظاهر، فجال به في العسكر، قد علقه في عنق فرسه، ثم دفعه بعد ذلك إليه، فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر رأس حبيبا فعلقه في لبان فرسه، ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر، فبصر به ابنه القاسم بن حبيب، وهو يومئذ قد راهق، فأقبل مع الفارس، لا يفارقه كلما دخل القصر دخل معه، وإذا خرج خرج معه، فارتاب به، فقال: ما لك يا بني تتبعني؟ قال: لا شيء! قال: بلى يا بني أخبرني؟
قال له: إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي أفتعطينيه حتى أدفنه؟
قال: يا بني لا يرضى الأمير أن يدفن، وأنا أريد أن يثيبني الأمير على قتله ثوابا حسنا!
قال له الغلام: لكن الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب، أما والله لقد قتلته خيرا منك وبكى.
فمكث الغلام حتى إذا أدرك لم يكن له همة إلا اتباع أثر قاتل أبيه ليجد منه غرة فيقتله بأبيه، فلما كان زمان مصعب بن الزبير، وغزا مصعب باجمير ادخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاطه، فأقبل يختلف في طلبه والتماس غرته، فدخل عليه وهو قائل نصف النهار فضربه بسيفه حتى برد… “.
نعم، في رواية الصدوق أن القاسم يسأل أباه عما يفعله الفرس بالرأس فيقول: ” قلت لأبي: لو أنه رفع الرأس.. إلى آخره “.
وهو يدل على حياة الأصبغ ذلك اليوم، وعليه فلم يعرف الوجه في تأخره عن حضور المشهد الكريم، مع مقامه العالي في التشيع، وإخلاصه في الموالاة لأمير المؤمنين وولده المعصومين (عليهم السلام)، ومشاهدته هذا الفعل من الطاغي يدل على عدم حبسه عند ابن زياد كباقي الشيعة الخلص، ولا مخرج عنه إلا بالوفاة قبل تلك الفاجعة العظمى كما هو الظاهر مما ذكره أصحابنا عند ترجمته، من الثناء عليه، والمبالغة في مدحه، وعدم الغمز فيه.
فتلك الجملة: ” قلت لأبي “، لا يعرف من أين جاءت. ولا غرابة في زيادتها بعد طعن أهل السنة فيه كما في اللآلئ المصنوعة ج1 ص213، فإنه بعد أن ذكر حديث الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري ” أنهم أمروا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي “، قال: ” لا يصح الحديث، لأن الأصبغ متروك، لا يساوي فلسا “.
وفيه ص195 ذكر عن ابن عباس حديث الركبان يوم القيامة رسول الله وصالح وحمزة وعلي قال: ” رجال الحديث بين مجهول وبين معروف بعدم الثقة “(2).
ولقد طعنوا في أمثاله من خواص الشيعة بكل ما يتسنى لهم، وما ذكر في تراجمهم يشهد لهذه الدعوى، ولا يتحمل هذا المختصر التبسط في ذكرها، ومراجعة ما كتبه السيد العلامة محمد بن أبي عقيل في ” العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ” ص40 في الباب الثاني فيه كفاية، فإنه ذكر جملة من أتباع أهل البيت طعنوا فيهم بلا سبب إلا لموالاة أمير المؤمنين وولده (عليهم السلام).
أخواته
كانت أخوات العباس من أبيه ثمان عشرة، فمنهنّ من توفيت أيام أبيها كزينب الصغرى، وجُمانة، وأُمامة، وأمّ سلمة، ورملةَ الصغرى.
ومنهنّ من لم يُذكرْ خُروجهنّ إلى أزواج.
والذين خرجن إلى أزواج: فالعقيلة زينب الكبرى كانت عند عبد الله بن جعفر الطيار، فأولدت له جعفراً الأكبر، وعباسا، وعلياً المعروف بالزينبي، وعوناً الأكبر قُتِل يوم الطف في حملة آل أبي طالب.
وأم كلثوم، وهي التي زوجها الحسين من ابن عمها القاسم بن محمد الطيار وأنحلها البغيبغات.
ورقية عند ابن عمها الشهيد مسلم بن عقيل، ولدت له عبد الله وعليا ومحمدا.
وفي العمدة تزوج مسلم أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) فولدت له حميدة، تزوّجها الفقيه الجليل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، أولدها محمداً منه العقب.
ولا يتم هذا إلا بعد وفاة إحداهن ; إذ لا يجوز الجمع بين الأختين، وكانت فاطمة عند أبي سعيد بن عقيل، ولدت له حميدة، وخديجة كانت عند عبد الرحمن بن عقيل، ولدت له سعيداً، وأم هاني تزوّجها عبد الله الأكبر بن عقيل، ولدت له عبد الرحمن ومحمداَ.
وأم الحسن خرجت إلى جعدة بن هبيرة المخزومي، وأمامة كانت عند الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ولدت له نفيسة.
ومنهنّ من لم يُذكرْ خُروجهنّ إلى أزواج.
والذين خرجن إلى أزواج: فالعقيلة زينب الكبرى كانت عند عبد الله بن جعفر الطيار، فأولدت له جعفراً الأكبر، وعباسا، وعلياً المعروف بالزينبي، وعوناً الأكبر قُتِل يوم الطف في حملة آل أبي طالب.
وأم كلثوم، وهي التي زوجها الحسين من ابن عمها القاسم بن محمد الطيار وأنحلها البغيبغات.
ورقية عند ابن عمها الشهيد مسلم بن عقيل، ولدت له عبد الله وعليا ومحمدا.
وفي العمدة تزوج مسلم أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) فولدت له حميدة، تزوّجها الفقيه الجليل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، أولدها محمداً منه العقب.
ولا يتم هذا إلا بعد وفاة إحداهن ; إذ لا يجوز الجمع بين الأختين، وكانت فاطمة عند أبي سعيد بن عقيل، ولدت له حميدة، وخديجة كانت عند عبد الرحمن بن عقيل، ولدت له سعيداً، وأم هاني تزوّجها عبد الله الأكبر بن عقيل، ولدت له عبد الرحمن ومحمداَ.
وأم الحسن خرجت إلى جعدة بن هبيرة المخزومي، وأمامة كانت عند الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ولدت له نفيسة.
أخوته
إن حاجة الباحث في تاريخ أبي الفضل (عليه السلام) ماسة إلى معرفة أخوته الأكارم لمناسبات هناك، فإن منهم من يعد قربه منه فضيلة رابية وشرفاً باذخاً فضلاً عن الأخوة، وهما الإمامان على الأمة إن قاما وإن قعدا.
وإذا كانت بُنوّتُهما لأمير المؤمنين معدودة من فضائله، مع ما له من الفضائل التي لا يأتي عليها الحصر، كما يظهر من قوله (عليه السلام) يوم الشورى: ” أنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطاي الحسن والحسين ابني رسول الله، وسيدي شباب أهل الجنة غيري “؟ قالوا: لا.
كما أنه (عليه السلام) افتخر بهما يوم كتب إليه معاوية أن لي فضائل ; كان أبي سيداً في الجاهلية، وصرتُ ملكاً في الإسلام، وأنا صهر رسول الله، وخال المؤمنين، وكاتب الوحي.
فكتب إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) أبياتاً سبعةً ذكر فيها مصاهرته من رسول الله، وأن عمه سيد الشهداء، وأخاه الطيار مع الملائكة في الجنان، وسبقه إلى الإسلام، وأخذ البيعة له (يوم الغدير)، وأن ولديه سبطا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وحينئذ فأخوة العباس لهما أولى أن تعقد منهما مآثره وفضائله. أضف إلى ذلك ما استفادهُ منهما من العلوم والمعارف الإلهية.
ومنهم من يجمعه وإياه جامع العقب، فإن المعقبين من أولاد أمير المؤمنين الإمامان والعباس ومحمد بن الحنفية وعمر الأطرف.
ومنهم من شاركه في موقف الطف.
ومنهم من يعد هو وإياه تحت جامع الأمومة.
ومنهم من شاركه في الاسم.
وعليه فأولاد أمير المؤمنين الذكور ستة عشر:
الحسن والحسين والمحسن، أمُّهم سيدة نساء العالمين.
محمد بن الحنفية، أمُّه خولة.
العباس وعبد الله وجعفر وعثمان، أمُّهم أمُّ البنين.
عمر الأطرف والعباس الأصغر، أمُّهما الصهباء.
محمد الأصغر، أمُّه أُمامة بنت أبي العاص.
يحيى وعون، أمُّهما أسماء بنت عميس.
عبد الله وأبو بكر، أمُّهما ليلى بنت مسعود.
محمد الأوسط، أمُّه أم ولد.
أما الإمامان فالأحرى أن نجعجع اليراع عن التبسط في فضلهما وموقفهما من القداسة ومحلهما من الزلفى، وما أوتيا من حول وطول، والبسطة في العلم، فإن الوقوف على كنه ذلك فوق مرتكز العقول.
وأما المحسن ـ بتشديد السين كما في تاج العروس بمادة شبر، والإصابة بترجمته ـ وضم الميم، وسكون الحاء كما في حاشية السيد محمد الحنفي على شرح ابن حجر لهمزية البوصيري ص 251.
فعند الإمامية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سماه باسم ابن هارون مشبر كمحدث كما في القاموس وغيره، وكان حملا، وبعد وفاته أسقطته فاطمة الزهراء لستة أشهر، والروايات التي ذكرها ابن طاووس في (الطرف) وغيره في غيرها تساعدهم.
وإذا كانت بُنوّتُهما لأمير المؤمنين معدودة من فضائله، مع ما له من الفضائل التي لا يأتي عليها الحصر، كما يظهر من قوله (عليه السلام) يوم الشورى: ” أنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطاي الحسن والحسين ابني رسول الله، وسيدي شباب أهل الجنة غيري “؟ قالوا: لا.
كما أنه (عليه السلام) افتخر بهما يوم كتب إليه معاوية أن لي فضائل ; كان أبي سيداً في الجاهلية، وصرتُ ملكاً في الإسلام، وأنا صهر رسول الله، وخال المؤمنين، وكاتب الوحي.
فكتب إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) أبياتاً سبعةً ذكر فيها مصاهرته من رسول الله، وأن عمه سيد الشهداء، وأخاه الطيار مع الملائكة في الجنان، وسبقه إلى الإسلام، وأخذ البيعة له (يوم الغدير)، وأن ولديه سبطا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وحينئذ فأخوة العباس لهما أولى أن تعقد منهما مآثره وفضائله. أضف إلى ذلك ما استفادهُ منهما من العلوم والمعارف الإلهية.
ومنهم من يجمعه وإياه جامع العقب، فإن المعقبين من أولاد أمير المؤمنين الإمامان والعباس ومحمد بن الحنفية وعمر الأطرف.
ومنهم من شاركه في موقف الطف.
ومنهم من يعد هو وإياه تحت جامع الأمومة.
ومنهم من شاركه في الاسم.
وعليه فأولاد أمير المؤمنين الذكور ستة عشر:
الحسن والحسين والمحسن، أمُّهم سيدة نساء العالمين.
محمد بن الحنفية، أمُّه خولة.
العباس وعبد الله وجعفر وعثمان، أمُّهم أمُّ البنين.
عمر الأطرف والعباس الأصغر، أمُّهما الصهباء.
محمد الأصغر، أمُّه أُمامة بنت أبي العاص.
يحيى وعون، أمُّهما أسماء بنت عميس.
عبد الله وأبو بكر، أمُّهما ليلى بنت مسعود.
محمد الأوسط، أمُّه أم ولد.
أما الإمامان فالأحرى أن نجعجع اليراع عن التبسط في فضلهما وموقفهما من القداسة ومحلهما من الزلفى، وما أوتيا من حول وطول، والبسطة في العلم، فإن الوقوف على كنه ذلك فوق مرتكز العقول.
وأما المحسن ـ بتشديد السين كما في تاج العروس بمادة شبر، والإصابة بترجمته ـ وضم الميم، وسكون الحاء كما في حاشية السيد محمد الحنفي على شرح ابن حجر لهمزية البوصيري ص 251.
فعند الإمامية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سماه باسم ابن هارون مشبر كمحدث كما في القاموس وغيره، وكان حملا، وبعد وفاته أسقطته فاطمة الزهراء لستة أشهر، والروايات التي ذكرها ابن طاووس في (الطرف) وغيره في غيرها تساعدهم.
الأعمام
هلمّ معنا أيها القارئ لنقرأ صحيفة بيضاء مختصرة من حياة أعمام أبي الفضل (عليه السلام)، الذين هم أغصان تلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فإن للعمومة عرقا يضرب في نفسيات المولود من فضائل وفواضل، وقد جاء في الحديث: ” الولد كما يشبه أخواله يشبه أعمامه “.
وقبل الإتيان على ما حباهم به المولى من الآلاء نستعرض اليسير من حياة عم الرسول (صلى الله عليه وآله)، الذي لم يزل يفتخر به في مواطن شتى، ألا وهو الحمزة بن عبد المطلب.
وما أدراك ما حمزة؟ وما هو! وهل تعلم ماذا عنى نبي العظمة من وصفه ” بأسد الله وأسد رسوله “؟ وهل أنه أراد الشدة والبسالة فحسب؟!
لا ; لأنه (صلى الله عليه وآله) أفصح من نطق بالضاد، وكلامه فوق كلام البلغاء، فلو كان يريد خصوص الشجاعة لكان حق التعبير أن يأتي بلفظ ” الأسد ” مجردا عن الإضافة إلى الله سبحانه وإلى رسوله، كما هو المطرد في التشبيه به نظما ونثرا.
وحيث أضافه الرسول إلى ذات الجلالة والرسالة فلا بد أن يكون لغاية هناك أخرى، وليست هي إلا إفادة أن ما فيه من كر وإقدام وبطش وتنمر مخصوص في نصرة كلمة الله العليا ودعوة الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهذا أربى من غيره وأرقى، فكان سلام الله عليه من عمد الدين، وأعلام الهداية، ولذلك وجب الاعتراف بفضله، وبما حباه المولى سبحانه من النزاهة التي لا ينالها أيّ كان من الشهداء، وكان ذلك من مكملات الإيمان، ومتممات العقائد الحقة.
يشهد له ما في كتاب ” الطرف ” للسيد ابن طاووس: أن رسول الله قال لحمزة في الليلة التي أصيب في يومها: ” إنك ستغيب غيبة بعيدة، فما تقول لو سألك الله عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان “؟
فبكى حمزة وقال: أرشدني وفهمني.
فقال النبي: ” تشهد لله بالوحدانية، ولمحمد بالرسالة، ولعلي بالولاية، وأن الأئمة من ذرية الحسين، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، وأن جعفر الطيار مع الملائكة في الجنة ابن أخيك، وأن محمدا وآله خير البرية “.
قال حمزة: آمنت وصدقت.
ثم قال رسول الله: ” وتشهد بأنك سيد الشهداء، وأسد الله وأسد رسوله “.
فلما سمع ذلك حمزة أُدهش وسقط لوجهه، ثم قبل عيني رسول الله وقال: أشهدك على ذلك وأشهد الله وكفى بالله شهيدا.
وإن التأمل في الحديث يفيدنا منزلة كبرى لحمزة من الدين والإيمان لا تحد، وإلا فما الفائدة في هذه البيعة والاعتراف بعد ما صدر منه بمكة من الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة؟! ولكنه (صلى الله عليه وآله) أراد لهذه الذات الطاهرة، التي حلّقت بصاحبها إلى ذروة اليقين التحلي بأفضل صفات الكمال، وهو التسليم لأمير المؤمنين بالولاية العامة، ولأبنائه المعصومين (عليهم السلام) بالخلافة عن جدهم الأمين.
وهناك مرتبة أخرى لا يبلغ مداها أحد، وهي اعتراف حمزة وشهادته بأنه سيد الشهداء، وأنه أسد الله وأسد رسوله، وأن ابن أخيه الطيار مع الملائكة في الجنة. وهذه خاصة لم يكلف بها العباد فوق ما عرفوه من منازل أهل البيت المعصومين، وإنما هي من مراتب السلوك والكشف واليقين.
وإذا نظرنا الى إكبار الأئمة لمقامه ـ وهم أعرف بنفسيات الرجال، حتى إنهم احتجوا على خصومهم بعمومته وشهادته دون الدين، كما احتجوا بنسبتهم إلى الرسول الأقدس، مع أن هناك رجالا بذلوا أنفسهم دون مرضاة الله تعالى. استفدنا درجة عالية تقرب من درجاتهم (عليهم السلام) فهذا أمير المؤمنين يقول: ” إن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين، ولكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيد الشهداء، وخصه رسول الله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه “.
وفي يوم الشورى احتُجّ عليهم به فقال: ” نشدتكم بالله هل فيكم أحد له مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله “؟!
وقال الإمام المجتبى في بعض خطبه: ” وكان ممن استجاب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله) عمه حمزة وابن عمه جعفر، فقتلا شهيدين في قتلى كثيرة معهما من أصحاب رسول الله، فجعل حمزة سيد الشهداء “.
وقال سيد الشهداء أبو عبد الله يوم الطف: ” أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي “؟!
إلى غير ذلك مما جاء عنهم في الإشادة بذكره حتى إن رسول الله لم يزل يكرر الهتاف بفضله، ويعرف المهاجرين والأنصار بما امتاز به أسد الله وأسد رسوله من بينهم، كي لا يقول قائل ولا يتردد مسلم عن الإذعان بما حبا الله تعالى سيد الشهداء من الكرامة، فيقول (صلى الله عليه وآله):
” يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنا محمد رسول الله، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي: أنا، وعلي، وحمزة، وجعفر “.
والغرض من هذا ليس إلا التعريف بخصوص فضل عمه وابن عمه، فلذلك لم يتعرض لخلق الأئمة، بل ولا شيعتهم المخلوقين من فاضل طينتهم ـ كما في صحيح الآثار ـ وإنما ذكر نفسه ووصيه لكونهما من أصول الإسلام والإيمان.
كما أن أمير المؤمنين يوم فتح البصرة لما صرّح بفضل سبعة من ولد عبد المطلب قال: ” لا ينكر فضلهم إلا كافر، ولا يجحده إلا جاحد، وهم: النبي محمد، ووصيه، والسبطان، والمهدي، وسيد الشهداء حمزة، والطيار في الجنان جعفر “، لم يقصد بذلك إلا التنويه بفضل عمه وأخيه، فقرن شهادتهما بمن نهض في سبيل الدعوة الإلهية وهم أركان الإسلام والإيمان.
ولو لم تكن لسيد الشهداء حمزة وابن أخيه الطيار كل فضيلة سوى شهادة النبيّ لهما بالتبليغ وأداء الرسالة، لكفى أن لا يطلب الإنسان غيرها.
قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): ” إذا كان يوم القيامة وجمع الله ـ تبارك وتعالى ـ الخلائق كان نوح (عليه السلام) أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟
فيقول: نعم.
فيقال له: من يشهد لك؟!
فيقول: محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله).
قال: فيخرج نوح (عليه السلام) ويتخطى الناس حتى يأتي إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو على كثيب المسك، ومعه علي (عليه السلام)، وهو قول الله عز وجل: { فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا }، فيقول نوح لمحمد (صلى الله عليه وآله): يا محمد إن الله ـ تبارك وتعالى ـ سألني هل بلغت؟ فقلت: نعم، فقال: من يشهد لك؟ قلت: محمد! فيقول: يا جعفر، يا حمزة اذهبا واشهدا أنه قد بلغ.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء (عليهم السلام) بما بلغوا “.
فقال الراوي: جعلت فداك فعلي (عليه السلام) أين هو؟
فقال: “هو أعظم منزلة من ذلك “.
وهذه الشهادة لا بد أن تكون حقيقية، بمعنى أنها تكون عن وقوف على معالم دين نوح (عليه السلام) وأديان الأنبياء الذين يشهدان لهم بنص الحديث، وإحاطة شهودية بها، وبمعارفها، وبمواقعها، وبوضعها في الموضع المقرر له، وإلا لما صحت الشهادة. وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن من الشهادة عند إطلاقها، فهي ليست شهادة علمية، بمعنى حصول العلم لهما من عصمة الأنبياء بأنهم وضعوا ودائع نبواتهم في مواضعها، ولو كان ذلك كافيا لما طولبوا بمن يشهد لهم، فإن جاعل العصمة فيهم ـ جل شأنه ـ أعرف بأمانتهم، لكنه لضرب من الحكمة أراد سبحانه وتعالى أن يجري الأمر على أصول الحكم يوم فصل القضاء.
ثم إن هذه الشهادة ليست فرعية، بمعنى إنهما يشهدان عن شهادة رسول الله، فإن المطلوب في المحاكم هي الشهادة الوجدانية فحسب.
فإذا تقرر ذلك فحسب حمزة وجعفر من العلم المتدفق خبرتهما بنواميس الأديان كلها، والنواميس الإلهية جمعاء، أو وقوفهما بحق اليقين، أو بالمعاينة في عالم الأنوار، أو المشاهدة في عالم الأظلة والذكر لها في عالم الشهود والوجود، ومن المستحيل بعد تلك الإحاطة أن يكونا جاهلين بشيء من نواميس الإسلام.
طالب
إن الثابت عند المحققين إسلام طالب بن أبي طالب من أول الدعوة، فإن المتأمل إذا نظر بعين البصيرة إلى أبي طالب، وقد ضم أولاده أجمع والنبي (صلى الله عليه وآله) معهم، لا يفارقونه في جميع الأحوال، مع ما يشاهدونه منه (صلى الله عليه وآله) من الآيات الباهرات ; لا يرتاب في صدق الدعوى، وقد أفصح عنه شعره:
إذا قيل مَنْ خيرُ هذا الورى… قبيلاً وأكرمُهُم أسرة
أناف بعبدِ منافٍ أبٌ… وفََضّله هاشم الغرة
لقد حلّ مجدُ بني هاشمٍ… مكانِ النعائِمِ والنثرة
وخيرُ بني هاشِمٍ أحمدٍ … رَسولِ الإلهِ على فترة
وإن في حديث جابر الأنصاري ما يفيد منزلة أرقى من مجرد الإسلام يقول قلت لرسول الله: أكثر الناس يقولون: إن أبا طالب مات كافرا؟
قال: ” يا جابر، ربك أعلم بالغيب، إنه لما كانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش، فرأيت أربعة أنوار، فقلت: إلهي ما هذه الأنوار؟
فقال: يا محمد، هذا عبد المطلب، وهذا أبو طالب، وهذا أبوك عبد الله، وهذا أخوك طالب.
فقلت: إلهي وسيدي، فبمَ نالوا هذه الدرجة؟
قال: بكتمانهم الإيمان والصبر على ذلك حتى ماتوا “.
وروى الكليني في روضة الكافي عن الصادق (عليه السلام): ” كان طالب مسلما قبل بدر، وإنما أخرجته قريش كَرْهاً، فنزل راجزوهم يرتجزون، ونزل طالب يرتجز:
يا ربّ إمّا يغزُوَنْ بطالِبِ… في مَقْنبٍ من هذه المَقانِبِ
في مَقْنبِ المُحاربِ المُغالِبِ… يَجعلُهُ المسلوبُ غير السالِبِ
وروى محمد بن المثنى الحضرمي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقي أبا رافع مولى العباس بن عبد المطلب يوم بدر، فسأله عن قومه؟ فأخبره أن قريشا أخرجوهم مكرهين.
ويشهد له ما رواه ابن جرير أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال يوم بدر: ” إني لأعرف رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، إنما خرج مستكرها “.
وقد اختلف في موت طالب فقيل: إنه لما خرج إلى بدر فقد ولم يعرف خبره، وقيل: أقحمه فرسه في البحر فغرق. وليس من البعيد أن قريشا قتلته حينما عرفت منه الإسلام، وعرفت مصارحته بالتفاؤل بمغلوبيتهم، وكان حاله كحال سعد بن عبادة لما رماه الجن ـ لو صدقت الأوهام ـ.
عقيل
كان عقيل بن أبي طالب أحد أغصان الشجرة الطيبة، وممن رضي عنهم الرسول (صلى الله عليه وآله)، فإن النظرة الصحيحة في التاريخ تفيد اعتناقه الإسلام أول الدعوة، وكان هذا مجلبة للحب النبوي حيث اجتمعت فيه شرائط الولاء من: رسوخ الإيمان في جوانحه، وعمل الخيرات بجوارحه، ولزوم الطاعة في أعماله، واقتفاء الصدق في أقواله، فقول النبي له: ” إني أحبك حبين: حبا لك، وحبا لحب أبي طالب لك ” إنما هو لأجل هاتيك المآثر، وليس من المعقول كون حبه لشيء من عرض الدنيا.
إذن، فحسب عقيل من العظمة هذه المكانة الشامخة. وقد حدته قوة الإيمان إلى أن يجاهد أعداء أخيه أمير المؤمنين بلسانِهِ من خلال الدليل والحجّة الدامغة، كاشفاً بذلك زيفهم وراداً عليهم كيدهم على مدى الحقب والأعوام.
على أن حب أبي طالب له لم يكن لمحض النبوة، فإنه لم يكن ولده البكر، ولا كان أشجع ولده، ولا أوفاهم ذمة، ولا ولده الوحيد، وقد كان في ولده مثل أمير المؤمنين وأبي المساكين جعفر الطيار، وهو أكبرهم سنا، وإنما كان ” شيخ الأبطح ” يظهر مرتبة من الحب له مع وجود ولده (الإمام) وأخيه الطيار لجمعه الفضائل والفواضل، موروثة ومكتسبة.
وبعد أن فرضنا أن أبا طالب حجة زمامه، وأنه وصي من الأوصياء لم يكن يحابي أحدا بالمحبة، وإن كان أعز ولده، إلا أن يجده ذلك الإنسان الكامل الذي يجب في شريعة الحق إظهار الولاء له.
ولا شك أن عقيلا لم يكن على غير الطريقة التي عليها أهل بيته أجمع من الإيمان والوحدانية لله تعالى، وكيف يشذ عن خاصته وأهله وهو وإياهم في بيت واحد، وأبو طالب هو المتكفل تربيته وإعاشته، فلا هو بطارده عن حوزته، ولا بمبعده عن حومته، ولا بمتضجر منه على الأقل؟
وكيف يتظاهر بحبه ويدنيه منه ـ كما يعلمنا النص النبوي السابق ـ لو لم يتوثق من إيمانه، ويتيقن من إسلامه، غير أنه كان مبطنا له، كما كان أبوه من قبل وأخوه طالب؟، وان كنا لا نشك في تفاوت الإيمان فيه وفي أخويه الطيار وأمير المؤمنين (عليه السلام).
وحينئذ لم يكن عقيل بمعزلٍ من هذا البيت الطاهر الذي بني الإسلام على علاليه، فهو مؤمن بما صدع به الرسول منذ هتف داعية الهدى.
كما لبت هذا الهتاف أختهم أم هاني، فكانت من السابقات إلى الإيمان، كما عليه صحيح الأثر، وفي بيتها نزل النبي عن معراجه، وهو في السنة الثالثة من البعثة، وحدثها بأمره قبل أن يخرج إلى الناس، وكانت مصدقة له غير أنها خشيت تكذيب قريش إياه، وعليه فلا يؤخذ بما زُعِمَ من تأخّر إسلامها إلى عام الفتح سنة ثمان من الهجرة.
وما عسى أن يقول القائل في أمهم فاطمة بنت أسد، زوج شيخ الأبطح، بعد شهادة الرسول الأمين بأنها من الطاهرات الطيبات المؤمنات في جميع أدوار حياتها.
والعجب! ممن اغتر بتمويه المبطلين فدون تلك الفرية، زعما منه أنها من فضائل سيد الأوصياء وهي: إن فاطمة بنت أسد دخلت البيت الحرام وهي حاملٌ بعلي (عليه السلام) فأرادت أن تسجد لهبل فمنعها علي وهو في بطنها.
وقد فات المسكين أن في هذه الكرامة طعنا بتلك الذات المبرأة من رجس الجاهلية ودنس الشرك.
وكيف يكون أشرف المخلوقات بعد خاتم الأنبياء المتكون من النور الإلهي مودعا في وعاء الكفر والجحود؟!
كما أنهم أبعدوها كثيرا عن مستوى التعاليم الإلهية، ودروس خاتم الأنبياء الملقاة عليها كل صباح ومساء، وفيها ما فرضه المهيمن ـ جل شأنه ـ على الأمة جمعاء من الإيمان بما حبا ولدها والوصي بالولاية على المؤمنين حتى اختص بها دون الأئمة من أبنائه، وإن كانوا نورا واحدا وطينة واحدة، ولقد غضب الإمام الصادق (عليه السلام) على من أسماه أمير المؤمنين وقال: ” مه لا يصلح هذا الاسم إلا لجدي أمير المؤمنين “.
فرووا أن النبي (صلى الله عليه وآله) وقف على قبرها وصاح: ” ابنك علي لا جعفر ولا عقيل ” ولما سئل عنه أجاب: ” أن الملك سألها عمن تدين بولايته بعد الرسول، فخجلت أن تقول ولدي “.
أمن المعقول أن تكون تلك الذات الطاهرة الحاملة لأشرف الخلق بعد النبيّ بعيدة عن تلك التعاليم المقدسة؟ وهل في الدين حياء؟
نعم أرادوا أن يزحزحوها عن الصراط السوي ولكن فاتهم الغرض وأخطأوا الرمية، فإن الصحيح من الآثار ينص على أن النبي لما أنزلها في لحدها ناداها بصوت رفيع: ” يا فاطمة أنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر، فإذا أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي: الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليي “، ثم خرج من القبر وأهال عليها التراب.
ولعل هذا خاص بها ومن جرى مجراها من الزاكين الطيبين، وإلا فلم يعهد في زمن الرسالة تلقين الأموات بمعرفة الولي بعده، فإنه كتخصيصها بالتكبير أربعين، مع أن التكبير على الأموات خمس.
وبالرغم من هاتيك السفاسف التي أرادوا بها الحط من مقام والدة الإمام، أظهر الرسول أمام الأمة ما أعرب عن مكانتها من الدين، وأنها بعين فاطر السماء حين كفّنها بقميصه الذي لا يبلى، لتكون مستورة يوم يعرى الخلق، وكان الاضطجاع في قبرها إجابة لرغبتها فيه عندما حدّثها عن أهوال القبر وما يكون فيه من ضغطة ابن آدم.
فتحصّل: إن هذا البيت الطاهر (بيت أبي طالب) بيت توحيد وإيمان وهدى ورشاد، وإن من حواهم البيت رجالاً ونساءً كلهم على دين واحد منذ هتف داعية الهدى وصدع بأمر الرسالة، غير أنهم بين من جاهر باتباع الدعوة، وبين من كتم الإيمان لضرب من المصلحة.
وقبل الإتيان على ما حباهم به المولى من الآلاء نستعرض اليسير من حياة عم الرسول (صلى الله عليه وآله)، الذي لم يزل يفتخر به في مواطن شتى، ألا وهو الحمزة بن عبد المطلب.
وما أدراك ما حمزة؟ وما هو! وهل تعلم ماذا عنى نبي العظمة من وصفه ” بأسد الله وأسد رسوله “؟ وهل أنه أراد الشدة والبسالة فحسب؟!
لا ; لأنه (صلى الله عليه وآله) أفصح من نطق بالضاد، وكلامه فوق كلام البلغاء، فلو كان يريد خصوص الشجاعة لكان حق التعبير أن يأتي بلفظ ” الأسد ” مجردا عن الإضافة إلى الله سبحانه وإلى رسوله، كما هو المطرد في التشبيه به نظما ونثرا.
وحيث أضافه الرسول إلى ذات الجلالة والرسالة فلا بد أن يكون لغاية هناك أخرى، وليست هي إلا إفادة أن ما فيه من كر وإقدام وبطش وتنمر مخصوص في نصرة كلمة الله العليا ودعوة الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهذا أربى من غيره وأرقى، فكان سلام الله عليه من عمد الدين، وأعلام الهداية، ولذلك وجب الاعتراف بفضله، وبما حباه المولى سبحانه من النزاهة التي لا ينالها أيّ كان من الشهداء، وكان ذلك من مكملات الإيمان، ومتممات العقائد الحقة.
يشهد له ما في كتاب ” الطرف ” للسيد ابن طاووس: أن رسول الله قال لحمزة في الليلة التي أصيب في يومها: ” إنك ستغيب غيبة بعيدة، فما تقول لو سألك الله عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان “؟
فبكى حمزة وقال: أرشدني وفهمني.
فقال النبي: ” تشهد لله بالوحدانية، ولمحمد بالرسالة، ولعلي بالولاية، وأن الأئمة من ذرية الحسين، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، وأن جعفر الطيار مع الملائكة في الجنة ابن أخيك، وأن محمدا وآله خير البرية “.
قال حمزة: آمنت وصدقت.
ثم قال رسول الله: ” وتشهد بأنك سيد الشهداء، وأسد الله وأسد رسوله “.
فلما سمع ذلك حمزة أُدهش وسقط لوجهه، ثم قبل عيني رسول الله وقال: أشهدك على ذلك وأشهد الله وكفى بالله شهيدا.
وإن التأمل في الحديث يفيدنا منزلة كبرى لحمزة من الدين والإيمان لا تحد، وإلا فما الفائدة في هذه البيعة والاعتراف بعد ما صدر منه بمكة من الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة؟! ولكنه (صلى الله عليه وآله) أراد لهذه الذات الطاهرة، التي حلّقت بصاحبها إلى ذروة اليقين التحلي بأفضل صفات الكمال، وهو التسليم لأمير المؤمنين بالولاية العامة، ولأبنائه المعصومين (عليهم السلام) بالخلافة عن جدهم الأمين.
وهناك مرتبة أخرى لا يبلغ مداها أحد، وهي اعتراف حمزة وشهادته بأنه سيد الشهداء، وأنه أسد الله وأسد رسوله، وأن ابن أخيه الطيار مع الملائكة في الجنة. وهذه خاصة لم يكلف بها العباد فوق ما عرفوه من منازل أهل البيت المعصومين، وإنما هي من مراتب السلوك والكشف واليقين.
وإذا نظرنا الى إكبار الأئمة لمقامه ـ وهم أعرف بنفسيات الرجال، حتى إنهم احتجوا على خصومهم بعمومته وشهادته دون الدين، كما احتجوا بنسبتهم إلى الرسول الأقدس، مع أن هناك رجالا بذلوا أنفسهم دون مرضاة الله تعالى. استفدنا درجة عالية تقرب من درجاتهم (عليهم السلام) فهذا أمير المؤمنين يقول: ” إن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين، ولكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيد الشهداء، وخصه رسول الله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه “.
وفي يوم الشورى احتُجّ عليهم به فقال: ” نشدتكم بالله هل فيكم أحد له مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله “؟!
وقال الإمام المجتبى في بعض خطبه: ” وكان ممن استجاب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله) عمه حمزة وابن عمه جعفر، فقتلا شهيدين في قتلى كثيرة معهما من أصحاب رسول الله، فجعل حمزة سيد الشهداء “.
وقال سيد الشهداء أبو عبد الله يوم الطف: ” أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي “؟!
إلى غير ذلك مما جاء عنهم في الإشادة بذكره حتى إن رسول الله لم يزل يكرر الهتاف بفضله، ويعرف المهاجرين والأنصار بما امتاز به أسد الله وأسد رسوله من بينهم، كي لا يقول قائل ولا يتردد مسلم عن الإذعان بما حبا الله تعالى سيد الشهداء من الكرامة، فيقول (صلى الله عليه وآله):
” يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنا محمد رسول الله، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي: أنا، وعلي، وحمزة، وجعفر “.
والغرض من هذا ليس إلا التعريف بخصوص فضل عمه وابن عمه، فلذلك لم يتعرض لخلق الأئمة، بل ولا شيعتهم المخلوقين من فاضل طينتهم ـ كما في صحيح الآثار ـ وإنما ذكر نفسه ووصيه لكونهما من أصول الإسلام والإيمان.
كما أن أمير المؤمنين يوم فتح البصرة لما صرّح بفضل سبعة من ولد عبد المطلب قال: ” لا ينكر فضلهم إلا كافر، ولا يجحده إلا جاحد، وهم: النبي محمد، ووصيه، والسبطان، والمهدي، وسيد الشهداء حمزة، والطيار في الجنان جعفر “، لم يقصد بذلك إلا التنويه بفضل عمه وأخيه، فقرن شهادتهما بمن نهض في سبيل الدعوة الإلهية وهم أركان الإسلام والإيمان.
ولو لم تكن لسيد الشهداء حمزة وابن أخيه الطيار كل فضيلة سوى شهادة النبيّ لهما بالتبليغ وأداء الرسالة، لكفى أن لا يطلب الإنسان غيرها.
قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): ” إذا كان يوم القيامة وجمع الله ـ تبارك وتعالى ـ الخلائق كان نوح (عليه السلام) أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟
فيقول: نعم.
فيقال له: من يشهد لك؟!
فيقول: محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله).
قال: فيخرج نوح (عليه السلام) ويتخطى الناس حتى يأتي إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو على كثيب المسك، ومعه علي (عليه السلام)، وهو قول الله عز وجل: { فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا }، فيقول نوح لمحمد (صلى الله عليه وآله): يا محمد إن الله ـ تبارك وتعالى ـ سألني هل بلغت؟ فقلت: نعم، فقال: من يشهد لك؟ قلت: محمد! فيقول: يا جعفر، يا حمزة اذهبا واشهدا أنه قد بلغ.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء (عليهم السلام) بما بلغوا “.
فقال الراوي: جعلت فداك فعلي (عليه السلام) أين هو؟
فقال: “هو أعظم منزلة من ذلك “.
وهذه الشهادة لا بد أن تكون حقيقية، بمعنى أنها تكون عن وقوف على معالم دين نوح (عليه السلام) وأديان الأنبياء الذين يشهدان لهم بنص الحديث، وإحاطة شهودية بها، وبمعارفها، وبمواقعها، وبوضعها في الموضع المقرر له، وإلا لما صحت الشهادة. وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن من الشهادة عند إطلاقها، فهي ليست شهادة علمية، بمعنى حصول العلم لهما من عصمة الأنبياء بأنهم وضعوا ودائع نبواتهم في مواضعها، ولو كان ذلك كافيا لما طولبوا بمن يشهد لهم، فإن جاعل العصمة فيهم ـ جل شأنه ـ أعرف بأمانتهم، لكنه لضرب من الحكمة أراد سبحانه وتعالى أن يجري الأمر على أصول الحكم يوم فصل القضاء.
ثم إن هذه الشهادة ليست فرعية، بمعنى إنهما يشهدان عن شهادة رسول الله، فإن المطلوب في المحاكم هي الشهادة الوجدانية فحسب.
فإذا تقرر ذلك فحسب حمزة وجعفر من العلم المتدفق خبرتهما بنواميس الأديان كلها، والنواميس الإلهية جمعاء، أو وقوفهما بحق اليقين، أو بالمعاينة في عالم الأنوار، أو المشاهدة في عالم الأظلة والذكر لها في عالم الشهود والوجود، ومن المستحيل بعد تلك الإحاطة أن يكونا جاهلين بشيء من نواميس الإسلام.
طالب
إن الثابت عند المحققين إسلام طالب بن أبي طالب من أول الدعوة، فإن المتأمل إذا نظر بعين البصيرة إلى أبي طالب، وقد ضم أولاده أجمع والنبي (صلى الله عليه وآله) معهم، لا يفارقونه في جميع الأحوال، مع ما يشاهدونه منه (صلى الله عليه وآله) من الآيات الباهرات ; لا يرتاب في صدق الدعوى، وقد أفصح عنه شعره:
إذا قيل مَنْ خيرُ هذا الورى… قبيلاً وأكرمُهُم أسرة
أناف بعبدِ منافٍ أبٌ… وفََضّله هاشم الغرة
لقد حلّ مجدُ بني هاشمٍ… مكانِ النعائِمِ والنثرة
وخيرُ بني هاشِمٍ أحمدٍ … رَسولِ الإلهِ على فترة
وإن في حديث جابر الأنصاري ما يفيد منزلة أرقى من مجرد الإسلام يقول قلت لرسول الله: أكثر الناس يقولون: إن أبا طالب مات كافرا؟
قال: ” يا جابر، ربك أعلم بالغيب، إنه لما كانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش، فرأيت أربعة أنوار، فقلت: إلهي ما هذه الأنوار؟
فقال: يا محمد، هذا عبد المطلب، وهذا أبو طالب، وهذا أبوك عبد الله، وهذا أخوك طالب.
فقلت: إلهي وسيدي، فبمَ نالوا هذه الدرجة؟
قال: بكتمانهم الإيمان والصبر على ذلك حتى ماتوا “.
وروى الكليني في روضة الكافي عن الصادق (عليه السلام): ” كان طالب مسلما قبل بدر، وإنما أخرجته قريش كَرْهاً، فنزل راجزوهم يرتجزون، ونزل طالب يرتجز:
يا ربّ إمّا يغزُوَنْ بطالِبِ… في مَقْنبٍ من هذه المَقانِبِ
في مَقْنبِ المُحاربِ المُغالِبِ… يَجعلُهُ المسلوبُ غير السالِبِ
وروى محمد بن المثنى الحضرمي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقي أبا رافع مولى العباس بن عبد المطلب يوم بدر، فسأله عن قومه؟ فأخبره أن قريشا أخرجوهم مكرهين.
ويشهد له ما رواه ابن جرير أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال يوم بدر: ” إني لأعرف رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، إنما خرج مستكرها “.
وقد اختلف في موت طالب فقيل: إنه لما خرج إلى بدر فقد ولم يعرف خبره، وقيل: أقحمه فرسه في البحر فغرق. وليس من البعيد أن قريشا قتلته حينما عرفت منه الإسلام، وعرفت مصارحته بالتفاؤل بمغلوبيتهم، وكان حاله كحال سعد بن عبادة لما رماه الجن ـ لو صدقت الأوهام ـ.
عقيل
كان عقيل بن أبي طالب أحد أغصان الشجرة الطيبة، وممن رضي عنهم الرسول (صلى الله عليه وآله)، فإن النظرة الصحيحة في التاريخ تفيد اعتناقه الإسلام أول الدعوة، وكان هذا مجلبة للحب النبوي حيث اجتمعت فيه شرائط الولاء من: رسوخ الإيمان في جوانحه، وعمل الخيرات بجوارحه، ولزوم الطاعة في أعماله، واقتفاء الصدق في أقواله، فقول النبي له: ” إني أحبك حبين: حبا لك، وحبا لحب أبي طالب لك ” إنما هو لأجل هاتيك المآثر، وليس من المعقول كون حبه لشيء من عرض الدنيا.
إذن، فحسب عقيل من العظمة هذه المكانة الشامخة. وقد حدته قوة الإيمان إلى أن يجاهد أعداء أخيه أمير المؤمنين بلسانِهِ من خلال الدليل والحجّة الدامغة، كاشفاً بذلك زيفهم وراداً عليهم كيدهم على مدى الحقب والأعوام.
على أن حب أبي طالب له لم يكن لمحض النبوة، فإنه لم يكن ولده البكر، ولا كان أشجع ولده، ولا أوفاهم ذمة، ولا ولده الوحيد، وقد كان في ولده مثل أمير المؤمنين وأبي المساكين جعفر الطيار، وهو أكبرهم سنا، وإنما كان ” شيخ الأبطح ” يظهر مرتبة من الحب له مع وجود ولده (الإمام) وأخيه الطيار لجمعه الفضائل والفواضل، موروثة ومكتسبة.
وبعد أن فرضنا أن أبا طالب حجة زمامه، وأنه وصي من الأوصياء لم يكن يحابي أحدا بالمحبة، وإن كان أعز ولده، إلا أن يجده ذلك الإنسان الكامل الذي يجب في شريعة الحق إظهار الولاء له.
ولا شك أن عقيلا لم يكن على غير الطريقة التي عليها أهل بيته أجمع من الإيمان والوحدانية لله تعالى، وكيف يشذ عن خاصته وأهله وهو وإياهم في بيت واحد، وأبو طالب هو المتكفل تربيته وإعاشته، فلا هو بطارده عن حوزته، ولا بمبعده عن حومته، ولا بمتضجر منه على الأقل؟
وكيف يتظاهر بحبه ويدنيه منه ـ كما يعلمنا النص النبوي السابق ـ لو لم يتوثق من إيمانه، ويتيقن من إسلامه، غير أنه كان مبطنا له، كما كان أبوه من قبل وأخوه طالب؟، وان كنا لا نشك في تفاوت الإيمان فيه وفي أخويه الطيار وأمير المؤمنين (عليه السلام).
وحينئذ لم يكن عقيل بمعزلٍ من هذا البيت الطاهر الذي بني الإسلام على علاليه، فهو مؤمن بما صدع به الرسول منذ هتف داعية الهدى.
كما لبت هذا الهتاف أختهم أم هاني، فكانت من السابقات إلى الإيمان، كما عليه صحيح الأثر، وفي بيتها نزل النبي عن معراجه، وهو في السنة الثالثة من البعثة، وحدثها بأمره قبل أن يخرج إلى الناس، وكانت مصدقة له غير أنها خشيت تكذيب قريش إياه، وعليه فلا يؤخذ بما زُعِمَ من تأخّر إسلامها إلى عام الفتح سنة ثمان من الهجرة.
وما عسى أن يقول القائل في أمهم فاطمة بنت أسد، زوج شيخ الأبطح، بعد شهادة الرسول الأمين بأنها من الطاهرات الطيبات المؤمنات في جميع أدوار حياتها.
والعجب! ممن اغتر بتمويه المبطلين فدون تلك الفرية، زعما منه أنها من فضائل سيد الأوصياء وهي: إن فاطمة بنت أسد دخلت البيت الحرام وهي حاملٌ بعلي (عليه السلام) فأرادت أن تسجد لهبل فمنعها علي وهو في بطنها.
وقد فات المسكين أن في هذه الكرامة طعنا بتلك الذات المبرأة من رجس الجاهلية ودنس الشرك.
وكيف يكون أشرف المخلوقات بعد خاتم الأنبياء المتكون من النور الإلهي مودعا في وعاء الكفر والجحود؟!
كما أنهم أبعدوها كثيرا عن مستوى التعاليم الإلهية، ودروس خاتم الأنبياء الملقاة عليها كل صباح ومساء، وفيها ما فرضه المهيمن ـ جل شأنه ـ على الأمة جمعاء من الإيمان بما حبا ولدها والوصي بالولاية على المؤمنين حتى اختص بها دون الأئمة من أبنائه، وإن كانوا نورا واحدا وطينة واحدة، ولقد غضب الإمام الصادق (عليه السلام) على من أسماه أمير المؤمنين وقال: ” مه لا يصلح هذا الاسم إلا لجدي أمير المؤمنين “.
فرووا أن النبي (صلى الله عليه وآله) وقف على قبرها وصاح: ” ابنك علي لا جعفر ولا عقيل ” ولما سئل عنه أجاب: ” أن الملك سألها عمن تدين بولايته بعد الرسول، فخجلت أن تقول ولدي “.
أمن المعقول أن تكون تلك الذات الطاهرة الحاملة لأشرف الخلق بعد النبيّ بعيدة عن تلك التعاليم المقدسة؟ وهل في الدين حياء؟
نعم أرادوا أن يزحزحوها عن الصراط السوي ولكن فاتهم الغرض وأخطأوا الرمية، فإن الصحيح من الآثار ينص على أن النبي لما أنزلها في لحدها ناداها بصوت رفيع: ” يا فاطمة أنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر، فإذا أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي: الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليي “، ثم خرج من القبر وأهال عليها التراب.
ولعل هذا خاص بها ومن جرى مجراها من الزاكين الطيبين، وإلا فلم يعهد في زمن الرسالة تلقين الأموات بمعرفة الولي بعده، فإنه كتخصيصها بالتكبير أربعين، مع أن التكبير على الأموات خمس.
وبالرغم من هاتيك السفاسف التي أرادوا بها الحط من مقام والدة الإمام، أظهر الرسول أمام الأمة ما أعرب عن مكانتها من الدين، وأنها بعين فاطر السماء حين كفّنها بقميصه الذي لا يبلى، لتكون مستورة يوم يعرى الخلق، وكان الاضطجاع في قبرها إجابة لرغبتها فيه عندما حدّثها عن أهوال القبر وما يكون فيه من ضغطة ابن آدم.
فتحصّل: إن هذا البيت الطاهر (بيت أبي طالب) بيت توحيد وإيمان وهدى ورشاد، وإن من حواهم البيت رجالاً ونساءً كلهم على دين واحد منذ هتف داعية الهدى وصدع بأمر الرسالة، غير أنهم بين من جاهر باتباع الدعوة، وبين من كتم الإيمان لضرب من المصلحة.
الزواج والولادة
تزوج أمير المؤمنين (عليه السلام) من فاطمة بنت حزام العامرية، إما بعد وفاة الصديقة سيدة النساء كما يراه بعض المؤرخين، أو بعد أن تزوج بأمامة بنت زينب بنت رسول الله كما يراه البعض الآخر، وهذا بعد وفاة الزهراء (عليها السلام) ; لأن الله قد حرّم النساء على علي ما دامت فاطمة موجودة.
فأنجبت منهُ أربعةُ بنين وهم: العباس، وعبد الله، وجعفر، وعثمان، وعاشت بعده مدة طويلة ولم تتزوج من غيره، كما أن أمامة وأسماء بنت عميس وليلى النهشلية لم يخرجن إلى أحد بعده. وهذه الحرائر الأربع أستُشهِدَ عنهن سيد الوصيين.
وقد خطب المغيرة بن نوفل أمامة، ثم خطبها أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحارث، فامتنعت، وروت حديثاً عن علي (عليه السلام): إن أزواج النبي والوصي لا يتزوجن بعده، فلم يتزوجن الحرائر وأمهات الأولاد عملاً بالرواية.
وكانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت (عليهم السلام)، مخلصة في ولائهم، ممحضة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، وقد زارتها زينب الكبرى بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة، كما كانت تزورها أيام العيد.
وبلغ من قمّة إيمانها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت (عليهم السلام)، أنها لما أدخلت على أمير المؤمنين ـ وكان الحسنان مريضين ـ أخذت تلاطف القول معهما، وتلقي إليهما من طيب الكلام ما يأخذ بمجامع القلوب، وما برحت على ذلك تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون.
ولاريب في ذلك فإنها حليلة شخص الإيمان، قد استضاءت بأنواره، وربّت في روضة أزهاره، واستفادت من معارفه، وتأدبت بآدابه، وتخلقت بأخلاقه.
الولادة
لقد أشرق الكون بمولد قمر بني هاشم يوم بزوغ نوره في أفق المجد العلوي، مرتضعاً ثدي البسالة، متربياً في حجر الخلافة، وقد ضربت فيه الإمامة بعرق نابض، فترعرع ومزيج روحه الشهامة والإباء والنزاهة عن الدنايا، وما شوهد مشتداً بشبيبته الغضة إلا وملء نفسِهِ إيمانٌ ثابت، وحشو ردائه حلم راجح، ولب ناضج، وعلم نافع.
فلم يزل يقتفي أثر السبط الشهيد (عليه السلام) الذي خلق لأجله، وتكوّن لأن يكون ردءً وشبيهاً له، في صفات الفضل، وشمائل الرفعة، وملامح الشجاعة، والسؤدد والخطر. فإن خطى سلام الله عليه فإلى الشرف، وإن قال فعن الهدى والرشاد، وإن رمق فإلى الحق، وإن مال فعن الباطل، وإن ترفع فعن الضيم، وإن تهالك فدون الدين.
فكان أبو الفضل جامع الفضل والمثل الأعلى للعبقرية ; لأنه كان يستفيد من أنوار هاتيك المآثر من شمس فلك الإمامة (حسين العلم والبأس والصلاح)، فكان هو وأخوه الشهيد (عليه السلام) من مصاديق قوله تعالى في التأويل: { والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها }، فلم يسبقه بقول استفاده منه، ولا بعمل أتبعه فيه، ولا بنفسية هي ظل نفسيته، ولا بمنقبة هي شعاع نوره الأقدس، المنطبع في مرآة غرائزه الصقيلة.
وقد تابع إمامه في كل أطواره حتى في بروز هيكله القدسي إلى عالم الوجود، فكان مولد الإمام السبط في ثالث شعبان، وظهور أبي الفضل العباس إلى عالم الشهود في الرابع منه سنة ست وعشرين من الهجرة.
ومما لا شك فيه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أُحضر أمامه ولده المحبوب ليقيم عليه مراسيم السُنّة النبوية التي تقام عند الولادة، ونظر إلى هذا الولد الجديد، الذي كان أختار أمير المؤمنين (عليه السلام) أمه على أن تكون من أشجع بيوتات العرب ; ليكون ولدها ناصراً لأخيه السبط الشهيد يوم تحيط به عصب الضلالة، شاهد بواسع علم الإمامة ما يجري عليه من الفادح الجلل، فكان بطبع الحال يطبق على كل عضو يشاهده مصيبة سوف تجري عليه، يقلب كفيه اللذين سيقطعان في نصرة حجة زمانه، فتهمل عيونه.
ويبصر صدره بعيبةِ العلم واليقين فيشاهده منبتا لسهام الأعداء، فتتصاعد زفرته، وينظر إلى رأسه المطهر فلا يعزب عنه أنه سوف يقرع بعمد الحديد، فتثور عاطفته، وترتفع عقيرته، كما لا يبارح ذاكرته فكره حينما يراه يسقي أخاه الماء ما يكون غدا من تفانيه في سقاية كريمات النبوة، ويحمل إليهن الماء على عطشه المرمض، وينفض الماء حين يذكر عطش أخيه، تهالكا في المواساة، ومبالغة في المفادات، وإخلاصا في الأخوة، فيتنفس الصعداء، ويكثر من قول: ” مالي وليزيد “، وعلى هذا فقس كل كارثة يقدر سوف تلم به وتجري عليه.
فكان هذا الولد العزيز على أبويه كلما سَرّ أباهُ اعتدال خلقته، أو ملامح الخير فيه، أو سمة البسالة عليه، أو شارة السعادة منه ; ساءه ما يشاهده هنالك من مصائب يتحملها، أو فادح ينوء به، من جرح دام، وعطش مجهد، وبلاء مكرب.
وهذه قضايا طبيعية تشتد عليها الحالة في مثل هاتيك الموارد، ممن يحمل أقل شيء من الرقة على أقل إنسان، فكيف بأمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو أعطف الناس على البشر عامة من الأب الرؤوف، وأرق عليهم من الأم الحنون.
إذن فكيف به في مثل هذا الإنسان الكامل (أبي الفضل) الذي لا يقف أحد على مدى فضله، كما ينحسر البيان عن تحديد مظلوميته واضطهاده.
وذكر صاحب كتاب ” قمر بني هاشم ” ص21 أن أم البنين رأت أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الأيام أجلس أبا الفضل (عليه السلام) على فخذه، وشمر عن ساعديه، وقبلهما وبكى، فأدهشها الحال ; لأنها لم تكن تعهد صبيا بتلك الشمائل العلوية ينظر إليه أبوه ويبكي، من دون سبب ظاهر، ولما أوقفها أمير المؤمنين (عليه السلام) على غامض القضاء، وما يجري على يديه من القطع في نصرة الحسين (عليه السلام) ; بكت وأعولت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها العزيز عند الله جل شأنه، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل ذلك لعمِهِ جعفر بن أبي طالب، فقامت تحمل بشرى الأبد، والسعادة الخالدة.
فأنجبت منهُ أربعةُ بنين وهم: العباس، وعبد الله، وجعفر، وعثمان، وعاشت بعده مدة طويلة ولم تتزوج من غيره، كما أن أمامة وأسماء بنت عميس وليلى النهشلية لم يخرجن إلى أحد بعده. وهذه الحرائر الأربع أستُشهِدَ عنهن سيد الوصيين.
وقد خطب المغيرة بن نوفل أمامة، ثم خطبها أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحارث، فامتنعت، وروت حديثاً عن علي (عليه السلام): إن أزواج النبي والوصي لا يتزوجن بعده، فلم يتزوجن الحرائر وأمهات الأولاد عملاً بالرواية.
وكانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت (عليهم السلام)، مخلصة في ولائهم، ممحضة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، وقد زارتها زينب الكبرى بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة، كما كانت تزورها أيام العيد.
وبلغ من قمّة إيمانها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت (عليهم السلام)، أنها لما أدخلت على أمير المؤمنين ـ وكان الحسنان مريضين ـ أخذت تلاطف القول معهما، وتلقي إليهما من طيب الكلام ما يأخذ بمجامع القلوب، وما برحت على ذلك تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون.
ولاريب في ذلك فإنها حليلة شخص الإيمان، قد استضاءت بأنواره، وربّت في روضة أزهاره، واستفادت من معارفه، وتأدبت بآدابه، وتخلقت بأخلاقه.
الولادة
لقد أشرق الكون بمولد قمر بني هاشم يوم بزوغ نوره في أفق المجد العلوي، مرتضعاً ثدي البسالة، متربياً في حجر الخلافة، وقد ضربت فيه الإمامة بعرق نابض، فترعرع ومزيج روحه الشهامة والإباء والنزاهة عن الدنايا، وما شوهد مشتداً بشبيبته الغضة إلا وملء نفسِهِ إيمانٌ ثابت، وحشو ردائه حلم راجح، ولب ناضج، وعلم نافع.
فلم يزل يقتفي أثر السبط الشهيد (عليه السلام) الذي خلق لأجله، وتكوّن لأن يكون ردءً وشبيهاً له، في صفات الفضل، وشمائل الرفعة، وملامح الشجاعة، والسؤدد والخطر. فإن خطى سلام الله عليه فإلى الشرف، وإن قال فعن الهدى والرشاد، وإن رمق فإلى الحق، وإن مال فعن الباطل، وإن ترفع فعن الضيم، وإن تهالك فدون الدين.
فكان أبو الفضل جامع الفضل والمثل الأعلى للعبقرية ; لأنه كان يستفيد من أنوار هاتيك المآثر من شمس فلك الإمامة (حسين العلم والبأس والصلاح)، فكان هو وأخوه الشهيد (عليه السلام) من مصاديق قوله تعالى في التأويل: { والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها }، فلم يسبقه بقول استفاده منه، ولا بعمل أتبعه فيه، ولا بنفسية هي ظل نفسيته، ولا بمنقبة هي شعاع نوره الأقدس، المنطبع في مرآة غرائزه الصقيلة.
وقد تابع إمامه في كل أطواره حتى في بروز هيكله القدسي إلى عالم الوجود، فكان مولد الإمام السبط في ثالث شعبان، وظهور أبي الفضل العباس إلى عالم الشهود في الرابع منه سنة ست وعشرين من الهجرة.
ومما لا شك فيه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أُحضر أمامه ولده المحبوب ليقيم عليه مراسيم السُنّة النبوية التي تقام عند الولادة، ونظر إلى هذا الولد الجديد، الذي كان أختار أمير المؤمنين (عليه السلام) أمه على أن تكون من أشجع بيوتات العرب ; ليكون ولدها ناصراً لأخيه السبط الشهيد يوم تحيط به عصب الضلالة، شاهد بواسع علم الإمامة ما يجري عليه من الفادح الجلل، فكان بطبع الحال يطبق على كل عضو يشاهده مصيبة سوف تجري عليه، يقلب كفيه اللذين سيقطعان في نصرة حجة زمانه، فتهمل عيونه.
ويبصر صدره بعيبةِ العلم واليقين فيشاهده منبتا لسهام الأعداء، فتتصاعد زفرته، وينظر إلى رأسه المطهر فلا يعزب عنه أنه سوف يقرع بعمد الحديد، فتثور عاطفته، وترتفع عقيرته، كما لا يبارح ذاكرته فكره حينما يراه يسقي أخاه الماء ما يكون غدا من تفانيه في سقاية كريمات النبوة، ويحمل إليهن الماء على عطشه المرمض، وينفض الماء حين يذكر عطش أخيه، تهالكا في المواساة، ومبالغة في المفادات، وإخلاصا في الأخوة، فيتنفس الصعداء، ويكثر من قول: ” مالي وليزيد “، وعلى هذا فقس كل كارثة يقدر سوف تلم به وتجري عليه.
فكان هذا الولد العزيز على أبويه كلما سَرّ أباهُ اعتدال خلقته، أو ملامح الخير فيه، أو سمة البسالة عليه، أو شارة السعادة منه ; ساءه ما يشاهده هنالك من مصائب يتحملها، أو فادح ينوء به، من جرح دام، وعطش مجهد، وبلاء مكرب.
وهذه قضايا طبيعية تشتد عليها الحالة في مثل هاتيك الموارد، ممن يحمل أقل شيء من الرقة على أقل إنسان، فكيف بأمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو أعطف الناس على البشر عامة من الأب الرؤوف، وأرق عليهم من الأم الحنون.
إذن فكيف به في مثل هذا الإنسان الكامل (أبي الفضل) الذي لا يقف أحد على مدى فضله، كما ينحسر البيان عن تحديد مظلوميته واضطهاده.
وذكر صاحب كتاب ” قمر بني هاشم ” ص21 أن أم البنين رأت أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الأيام أجلس أبا الفضل (عليه السلام) على فخذه، وشمر عن ساعديه، وقبلهما وبكى، فأدهشها الحال ; لأنها لم تكن تعهد صبيا بتلك الشمائل العلوية ينظر إليه أبوه ويبكي، من دون سبب ظاهر، ولما أوقفها أمير المؤمنين (عليه السلام) على غامض القضاء، وما يجري على يديه من القطع في نصرة الحسين (عليه السلام) ; بكت وأعولت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها العزيز عند الله جل شأنه، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل ذلك لعمِهِ جعفر بن أبي طالب، فقامت تحمل بشرى الأبد، والسعادة الخالدة.
العباس في نظر الأئمة
العباس في نظر الأئمة (عليهم السلام)
لا نحسب أن القارئ بحاجة إلى الإفاضة في هذا الموضوع، بعد ذكر مكانة أبي الفضل (عليه السلام)، من العلم والتقى والملكات الفاضلة، من إباء ونخوة وتضحية في سبيل الهدى، وتهالك في العبادة، فإن أئمة الهدى من أهل البيت (عليهم السلام) يقدرون لمن هو دونه في تلكم الأحوال فضله، فكيف به وهو من لحمتهم، وفرع أرومتهم، وغصن باسق في دوحتهم؟! وقد أثبت له الإمام السجاد (عليه السلام) منزلة كبرى لم ينلها غيره من الشهداء ساوى بها عمه الطيار، فقال (عليه السلام):
” رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عزوجل جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة “.
ولفظ ” الجميع ” يشمل مثل حمزة وجعفر الشاهدين للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة، وقد نفى البعد عنه العلامة المحقق المتبحر في الكبريت الأحمر ص47 ج3.
ولعل ما جاء في زيارة الشهداء يشهد له: ” السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط وسلف ونحن لكم أتباع وأنصار، أنتم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة “.
وكذلك قوله (عليه السلام) فيهم: إنهم لم يسبقهم سابق، ولايلحقهم لاحق.
فقد أثبت لهم السيادة على جميع الشهداء، أنهم لم يسبقهم ولا يلحقهم أي أحد، وأبو الفضل في جملتهم بهذا التفضيل، وقد انفرد عنهم بما أثبته له الإمام السجاد (عليه السلام) من المنزلة التي لم تكن لأي شهيد.
ولهذه الغايات الثمينة، والمراتب العليا كان أهل البيت (عليهم السلام)يدخلونه في أعالي أمورهم مِمّا لا يتدخل فيها إنسان عادي، فمن ذلك مشاطرته الحسين (عليه السلام) في غسل الحسن (عليه السلام).
وأنت بعد ما علمت مرتبة الإمامة، وموقف صاحبها من العظمة، وأنه لا يلي أمر الإمام إلا إمام مثله، فلا مندوحة لك إلا الإيمان بأن من له أي تدخل في ذلك بالخدمة من جلب الماء وما يقتضيه الحال أعظم رجل في العالم بعد أئمة الدين، فإن جثمان المعصوم عند سيره إلى العليّ الأعلى ـ تقدست أسماؤه ـ لا يمكن أن يقرب أو ينظر إليه من كان دون تلك المرتبة، إذ هو مقام قاب قوسين أو أدنى، ذلك الذي لم يطق حبيبُ إله العالمين أن يصل إليه حتى تقهقر، وغاب النبي الأقدس في سبحات الملكوت والجلال وحده إلى أن وقف الموقف الرهيب.
وهكذا خلفاء النبي (صلى الله عليه وآله) المشاركون له في المآثر كلها ما خلا النبوة والأزواج، ومنه حال انقطاعهم عن عالم الوجود بانتهاء أمد الفيض المقدس.
ومما يشهد له أن الفضل بن العباس بن عبد المطلب كان يحمل الماء عند تغسيل النبي (صلى الله عليه وآله)، معاونا أمير المؤمنين (عليه السلام)على غسله، ولكنه عصب عينيه خشية العمى إن وقع نظره على ذلك الجسد الطاهر.
ومثله ما جاء في الأثر عن الإشراف على ضريح رسول الله، حذر أن يرى الناظر شيئا فيعمى، وقد اشتهر ذلك بين أهل المدينة، فكان إذا سقط في الضريح شيء أنزلوا صبيا وشدوا عينيه بعصابة فيخرجه.
وهذه أسرار لا تصل إليها أفكار البشر، وليس لنا إلا التسليم على الجملة، ولا سبيل لنا إلى الإنكار بمجرد عدم إدراكنا مثلها، خصوصا بعد استفاضة النقل في أن للنبي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) بعد وفاتهم أحوالا غريبة، ليس لسائر الخلق معهم شراكة، كحرمة لحومهم على الأرض، وصعود أجسادهم إلى السماء، ورؤية بعضهم بعضا، وإحيائهم الأموات منهم بالأجساد الأصلية عند الاقتضاء، إذ لا يمنع العقل منه مع دلالة النقل الكثير عليه، واعتراف الأصحاب به(1)، فيصار التحصل أن الحواس الظاهرة العادية لا تتحمل مثل تلك الأمثلة القدسية، وهي في حال صعودها إلى سبحات القدس إلا نفوس المعصومين بعضها مع بعض دون غيرهم، مهما بلغ من الخشوع والطاعة.
لكن (عباس المعرفة) الذي منحه الإمام في الزيارة أسمى صفة حظي بها الأنبياء والمقربون وهي: ” العبد الصالح تسنى له الوصول إلى ذلك المحل الأقدس، من دون أن يذكر له تعصيب عين أو إغضاء طرف، فشارك السبط الشهيد، والرسول الأعظم، ووصيه المقدم مع الروح الأمين، وجملة الملائكة في غسل الإمام المجتبى الحسن السبط صلوات الله عليهم أجمعين.
وهذه هي المنزلة الكبرى التي لا يحظى بها إلا ذوو النفوس القدسية، من الحجج المعصومين، ولا غرو إن يغبط أبا الفضل (عليه السلام) الصديقون والشهداء الصالحون.
وإذا قرأنا قول الحسين للعباس (عليهما السلام)، لما زحف القوم على مخيمه، عشية التاسع من المحرم: ” اركب بنفسي أنت يا أخي ” حتى تلقاهم وتسألهم عما جاءهم، فاستقبلهم العباس في عشرين فارسا، فيهم حبيب وزهير، وسألهم عن ذلك؟ فقالوا: إن الأمير يأمر إما النزول على حكمه أو المنازلة، فأخبر الحسين، فأرجعه ليرجئهم إلى غد.
فإنك ترى الفكر يسف عن مدى هذه الكلمة، وأنى له أن يحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات مطهرة تفتدى بنفس الإمام، علة الكائنات، وهو الصادر الأول، والممكن الأشرف، والفيض الأقدس للممكنات: ” بكم فتح الله وبكم يختم “.
نعم، عرفها البصير الناقد بعد أن جربها بمحك النزاهة، فوجدها مشوبة بجنسها، ثم أطلق تلك الكلمة الذهبية الثمينة (ولا يعرف الفضل إلا أهله).
ولا يذهب بك الظن ـ أيها القارئ الفطن ـ إلى عدم الأهمية في هذه الكلمة بعد القول في زيارة الشهداء من زيارة وارث: ” بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم “.
فإن الإمام في هذه الزيارة لم يكن هو المخاطب لهم، وإنما هو(عليه السلام) في مقام تعليم صفوان الجمال عند زيارتهم أن يخاطبهم بذلك الخطاب، فإن الرواية جاءت كما في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي أن صفوان قال: استأذنت الإمام الصادق (عليه السلام) لزيارة الحسين وسألته أن يعرفني ما أعمل عليه.
فقال له: ” يا صفوان، صم قبل خروجك ثلاثة أيام ” إلى أن قال: ” ثم إذا أتيت الحائر فقل: الله أكبر كبيرا “، ثم ساق الزيارة إلى أن قال: ” ثم اخرج من الباب الذي يلي رجلي علي بن الحسين وتوجه إلى الشهداء وقل: السلام عليكم يا أولياء الله.. ” إلى آخرها.
الصادق (عليه السلام) في مقام تعليم صفوان أن يقول في السلام على الشهداء ذلك، وليس في الرواية ما يدل على أن الإمام الصادق (عليه السلام) ماذا يقول لو أراد السلام عليهم.
وهنا ظاهرة أخرى دلت على منزلة كبرى للعباس عند سيد الشهداء، ذلك أن الإمام الشهيد لما اجتمع بعمر بن سعد ليلا وسط العسكرين ; لإرشاده إلى سبيل الحق، وتعريفه طغيان ابن ميسون، وتذكيره بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) في حقه ; أمر (عليه السلام) من كان معه بالتنحي إلا العباس وابنه عليا، وهكذا صنع ابن سعد، فبقي معه ابنه وغلامه.
وأنت تعلم أن ميزة أبي الفضل على الصحب الأكارم، وسروات المجد من آل الرسول الذين شهد لهم الحسين باليقين والصدق في النية والوفاء، غير أنه (عليه السلام) أراد أن يوعز إلى الملأ من بعده ما لأبي الفضل وعلي الأكبر من الصفات التي لا تحدها العقول.
ومن هذا الباب لما كان يوم العاشر، وعلا صراخ النساء وعويل الأطفال حتى كان بمسامع الحسين (عليه السلام)، وهو ماثل أمام العسكر، أمر أخاه العباس أن يُسكتهُنّ، حذار شماتة القوم إذا سمعوا ذلك العويل، وغيرة على مخدّرات حرم النبوة أن يسمع أصواتهن الأجانب.
ولو أردنا تحليل موقف الإمام العباس (عليه السلام) وتأخّرهِ عن جميع الشهداء في شهادتِهِ (عليه السلام)، وهو حاملُ تلك النفس الأبيّة والروح الوثّابةَ إلى الدفاع عن حياض العقيدة والدين ونصرة آل الرسول الأمين (صلى الله عليه وآله) فكيف بهِ صابراً وهو يرى مصارع الكرام من أخوتهِ وأبناء عمومتهِ وأحبّته، ويسمع بكاء وعويل الفواطم المخدرات، وقد أقبل الشرُّ من جميع نواحيهِ، وقد اجتمعت في صدرهِ الحميّة الهاشمية والغيرة العلوّية لما يراهُ من المناظر الشجيّة، وكُلُّ منظرٍ منها كان لا يترك لحامل اللواء بُدّاً من أخذ الثأر من زمرة أعداء الله والدين يزيد وأعوانه.
لكن أهمية موقفه عند أخيه السبط هو الذي أرجأ تأخيره عن الإقدام، فإن سيد الشهداء(عليه السلام) يعد بقاءه من ذخائر الإمامة، وأن موتته تفت في العضد فيقول له: ” إذا مضيت تفرق عسكري “، حتى إنه في الساعة الأخيرة لم يأذن له إلا بعد أخذٍ ورَدِّ.
وإن حديث (الإيقاد) لسيدنا المتتبع الحجة السيد محمد علي الشاه عبد العظيم (قدس سره) يوقفنا على مرتبة تضاهي مرتبة المعصومين، ذلك لما حضر السجاد (عليه السلام) لدفن الأجساد الطاهرة فسح مجالاً لبني أسد في نقل الجثث الزواكي إلى محلها الأخير، عدى جسد الحسين وجثة عمه العباس، فتولى وحده إنزالهما إلى مقرهما، أو إصعادهما إلى حضيرة القدس وقال: ” إن معي من يعينني “.
أما الإمام فالأمر فيه واضح ; لأنه لا يلي أمره إلا إمام مثله، ولكن الأمر الذي لا نكاد نصل إلى حقيقته وكنهه، هو فعله بعمه الصديق الشهيد مثل ما فعل بأبيه الوصي، وليس ذلك إلا لأن ذلك الهيكل المطهر لا يمسه إلا ذوات طاهرة، في ساعة هي أقرب حالاته إلى المولى سبحانه، ولا يدنو منه من ليس من أهل ذلك المحل الأرفع.
ولم تزل هذه العظمة محفوظة له عند أهل البيت دنيا وآخرة، حتى إن الصديقة الزهراء سلام الله عليها لا تبتدئ بالشكاية بأي ظلامة من ظلامات آل محمد ـ وهي لا تحصى ـ إلا بكفي أبي الفضل المقطوعتين، كما في الأسرار ص325، وجواهر الإيقان ص194، وقد ادخرتهما من أهم أسباب الشفاعة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
لا نحسب أن القارئ بحاجة إلى الإفاضة في هذا الموضوع، بعد ذكر مكانة أبي الفضل (عليه السلام)، من العلم والتقى والملكات الفاضلة، من إباء ونخوة وتضحية في سبيل الهدى، وتهالك في العبادة، فإن أئمة الهدى من أهل البيت (عليهم السلام) يقدرون لمن هو دونه في تلكم الأحوال فضله، فكيف به وهو من لحمتهم، وفرع أرومتهم، وغصن باسق في دوحتهم؟! وقد أثبت له الإمام السجاد (عليه السلام) منزلة كبرى لم ينلها غيره من الشهداء ساوى بها عمه الطيار، فقال (عليه السلام):
” رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عزوجل جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة “.
ولفظ ” الجميع ” يشمل مثل حمزة وجعفر الشاهدين للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة، وقد نفى البعد عنه العلامة المحقق المتبحر في الكبريت الأحمر ص47 ج3.
ولعل ما جاء في زيارة الشهداء يشهد له: ” السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط وسلف ونحن لكم أتباع وأنصار، أنتم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة “.
وكذلك قوله (عليه السلام) فيهم: إنهم لم يسبقهم سابق، ولايلحقهم لاحق.
فقد أثبت لهم السيادة على جميع الشهداء، أنهم لم يسبقهم ولا يلحقهم أي أحد، وأبو الفضل في جملتهم بهذا التفضيل، وقد انفرد عنهم بما أثبته له الإمام السجاد (عليه السلام) من المنزلة التي لم تكن لأي شهيد.
ولهذه الغايات الثمينة، والمراتب العليا كان أهل البيت (عليهم السلام)يدخلونه في أعالي أمورهم مِمّا لا يتدخل فيها إنسان عادي، فمن ذلك مشاطرته الحسين (عليه السلام) في غسل الحسن (عليه السلام).
وأنت بعد ما علمت مرتبة الإمامة، وموقف صاحبها من العظمة، وأنه لا يلي أمر الإمام إلا إمام مثله، فلا مندوحة لك إلا الإيمان بأن من له أي تدخل في ذلك بالخدمة من جلب الماء وما يقتضيه الحال أعظم رجل في العالم بعد أئمة الدين، فإن جثمان المعصوم عند سيره إلى العليّ الأعلى ـ تقدست أسماؤه ـ لا يمكن أن يقرب أو ينظر إليه من كان دون تلك المرتبة، إذ هو مقام قاب قوسين أو أدنى، ذلك الذي لم يطق حبيبُ إله العالمين أن يصل إليه حتى تقهقر، وغاب النبي الأقدس في سبحات الملكوت والجلال وحده إلى أن وقف الموقف الرهيب.
وهكذا خلفاء النبي (صلى الله عليه وآله) المشاركون له في المآثر كلها ما خلا النبوة والأزواج، ومنه حال انقطاعهم عن عالم الوجود بانتهاء أمد الفيض المقدس.
ومما يشهد له أن الفضل بن العباس بن عبد المطلب كان يحمل الماء عند تغسيل النبي (صلى الله عليه وآله)، معاونا أمير المؤمنين (عليه السلام)على غسله، ولكنه عصب عينيه خشية العمى إن وقع نظره على ذلك الجسد الطاهر.
ومثله ما جاء في الأثر عن الإشراف على ضريح رسول الله، حذر أن يرى الناظر شيئا فيعمى، وقد اشتهر ذلك بين أهل المدينة، فكان إذا سقط في الضريح شيء أنزلوا صبيا وشدوا عينيه بعصابة فيخرجه.
وهذه أسرار لا تصل إليها أفكار البشر، وليس لنا إلا التسليم على الجملة، ولا سبيل لنا إلى الإنكار بمجرد عدم إدراكنا مثلها، خصوصا بعد استفاضة النقل في أن للنبي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) بعد وفاتهم أحوالا غريبة، ليس لسائر الخلق معهم شراكة، كحرمة لحومهم على الأرض، وصعود أجسادهم إلى السماء، ورؤية بعضهم بعضا، وإحيائهم الأموات منهم بالأجساد الأصلية عند الاقتضاء، إذ لا يمنع العقل منه مع دلالة النقل الكثير عليه، واعتراف الأصحاب به(1)، فيصار التحصل أن الحواس الظاهرة العادية لا تتحمل مثل تلك الأمثلة القدسية، وهي في حال صعودها إلى سبحات القدس إلا نفوس المعصومين بعضها مع بعض دون غيرهم، مهما بلغ من الخشوع والطاعة.
لكن (عباس المعرفة) الذي منحه الإمام في الزيارة أسمى صفة حظي بها الأنبياء والمقربون وهي: ” العبد الصالح تسنى له الوصول إلى ذلك المحل الأقدس، من دون أن يذكر له تعصيب عين أو إغضاء طرف، فشارك السبط الشهيد، والرسول الأعظم، ووصيه المقدم مع الروح الأمين، وجملة الملائكة في غسل الإمام المجتبى الحسن السبط صلوات الله عليهم أجمعين.
وهذه هي المنزلة الكبرى التي لا يحظى بها إلا ذوو النفوس القدسية، من الحجج المعصومين، ولا غرو إن يغبط أبا الفضل (عليه السلام) الصديقون والشهداء الصالحون.
وإذا قرأنا قول الحسين للعباس (عليهما السلام)، لما زحف القوم على مخيمه، عشية التاسع من المحرم: ” اركب بنفسي أنت يا أخي ” حتى تلقاهم وتسألهم عما جاءهم، فاستقبلهم العباس في عشرين فارسا، فيهم حبيب وزهير، وسألهم عن ذلك؟ فقالوا: إن الأمير يأمر إما النزول على حكمه أو المنازلة، فأخبر الحسين، فأرجعه ليرجئهم إلى غد.
فإنك ترى الفكر يسف عن مدى هذه الكلمة، وأنى له أن يحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات مطهرة تفتدى بنفس الإمام، علة الكائنات، وهو الصادر الأول، والممكن الأشرف، والفيض الأقدس للممكنات: ” بكم فتح الله وبكم يختم “.
نعم، عرفها البصير الناقد بعد أن جربها بمحك النزاهة، فوجدها مشوبة بجنسها، ثم أطلق تلك الكلمة الذهبية الثمينة (ولا يعرف الفضل إلا أهله).
ولا يذهب بك الظن ـ أيها القارئ الفطن ـ إلى عدم الأهمية في هذه الكلمة بعد القول في زيارة الشهداء من زيارة وارث: ” بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم “.
فإن الإمام في هذه الزيارة لم يكن هو المخاطب لهم، وإنما هو(عليه السلام) في مقام تعليم صفوان الجمال عند زيارتهم أن يخاطبهم بذلك الخطاب، فإن الرواية جاءت كما في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي أن صفوان قال: استأذنت الإمام الصادق (عليه السلام) لزيارة الحسين وسألته أن يعرفني ما أعمل عليه.
فقال له: ” يا صفوان، صم قبل خروجك ثلاثة أيام ” إلى أن قال: ” ثم إذا أتيت الحائر فقل: الله أكبر كبيرا “، ثم ساق الزيارة إلى أن قال: ” ثم اخرج من الباب الذي يلي رجلي علي بن الحسين وتوجه إلى الشهداء وقل: السلام عليكم يا أولياء الله.. ” إلى آخرها.
الصادق (عليه السلام) في مقام تعليم صفوان أن يقول في السلام على الشهداء ذلك، وليس في الرواية ما يدل على أن الإمام الصادق (عليه السلام) ماذا يقول لو أراد السلام عليهم.
وهنا ظاهرة أخرى دلت على منزلة كبرى للعباس عند سيد الشهداء، ذلك أن الإمام الشهيد لما اجتمع بعمر بن سعد ليلا وسط العسكرين ; لإرشاده إلى سبيل الحق، وتعريفه طغيان ابن ميسون، وتذكيره بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) في حقه ; أمر (عليه السلام) من كان معه بالتنحي إلا العباس وابنه عليا، وهكذا صنع ابن سعد، فبقي معه ابنه وغلامه.
وأنت تعلم أن ميزة أبي الفضل على الصحب الأكارم، وسروات المجد من آل الرسول الذين شهد لهم الحسين باليقين والصدق في النية والوفاء، غير أنه (عليه السلام) أراد أن يوعز إلى الملأ من بعده ما لأبي الفضل وعلي الأكبر من الصفات التي لا تحدها العقول.
ومن هذا الباب لما كان يوم العاشر، وعلا صراخ النساء وعويل الأطفال حتى كان بمسامع الحسين (عليه السلام)، وهو ماثل أمام العسكر، أمر أخاه العباس أن يُسكتهُنّ، حذار شماتة القوم إذا سمعوا ذلك العويل، وغيرة على مخدّرات حرم النبوة أن يسمع أصواتهن الأجانب.
ولو أردنا تحليل موقف الإمام العباس (عليه السلام) وتأخّرهِ عن جميع الشهداء في شهادتِهِ (عليه السلام)، وهو حاملُ تلك النفس الأبيّة والروح الوثّابةَ إلى الدفاع عن حياض العقيدة والدين ونصرة آل الرسول الأمين (صلى الله عليه وآله) فكيف بهِ صابراً وهو يرى مصارع الكرام من أخوتهِ وأبناء عمومتهِ وأحبّته، ويسمع بكاء وعويل الفواطم المخدرات، وقد أقبل الشرُّ من جميع نواحيهِ، وقد اجتمعت في صدرهِ الحميّة الهاشمية والغيرة العلوّية لما يراهُ من المناظر الشجيّة، وكُلُّ منظرٍ منها كان لا يترك لحامل اللواء بُدّاً من أخذ الثأر من زمرة أعداء الله والدين يزيد وأعوانه.
لكن أهمية موقفه عند أخيه السبط هو الذي أرجأ تأخيره عن الإقدام، فإن سيد الشهداء(عليه السلام) يعد بقاءه من ذخائر الإمامة، وأن موتته تفت في العضد فيقول له: ” إذا مضيت تفرق عسكري “، حتى إنه في الساعة الأخيرة لم يأذن له إلا بعد أخذٍ ورَدِّ.
وإن حديث (الإيقاد) لسيدنا المتتبع الحجة السيد محمد علي الشاه عبد العظيم (قدس سره) يوقفنا على مرتبة تضاهي مرتبة المعصومين، ذلك لما حضر السجاد (عليه السلام) لدفن الأجساد الطاهرة فسح مجالاً لبني أسد في نقل الجثث الزواكي إلى محلها الأخير، عدى جسد الحسين وجثة عمه العباس، فتولى وحده إنزالهما إلى مقرهما، أو إصعادهما إلى حضيرة القدس وقال: ” إن معي من يعينني “.
أما الإمام فالأمر فيه واضح ; لأنه لا يلي أمره إلا إمام مثله، ولكن الأمر الذي لا نكاد نصل إلى حقيقته وكنهه، هو فعله بعمه الصديق الشهيد مثل ما فعل بأبيه الوصي، وليس ذلك إلا لأن ذلك الهيكل المطهر لا يمسه إلا ذوات طاهرة، في ساعة هي أقرب حالاته إلى المولى سبحانه، ولا يدنو منه من ليس من أهل ذلك المحل الأرفع.
ولم تزل هذه العظمة محفوظة له عند أهل البيت دنيا وآخرة، حتى إن الصديقة الزهراء سلام الله عليها لا تبتدئ بالشكاية بأي ظلامة من ظلامات آل محمد ـ وهي لا تحصى ـ إلا بكفي أبي الفضل المقطوعتين، كما في الأسرار ص325، وجواهر الإيقان ص194، وقد ادخرتهما من أهم أسباب الشفاعة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
سقاية العباس لأهل البيت
سقاية العباس عليه السلام لأهل البيت عليهم السلام
السقاية ، هي من أفضل الأعمال في الشريعة لأنها إحياء النفس وصيانتها من الهلاك ..وهذا ما بينه الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله ) حيث قال:(أفضل الأعمال عند الله إبراد الكبد الحرّى من بهيمة وغيرها ولو كان على الماء فانه يوجب تناثر الذنوب كما تنثر من ورق الشجر فأعطاه الله بكل قطرة يبذلها قنطاراً في الجنة وسقاه من الرحيق المختوم وان كان فلاة من الأرض ورد حياض القدس مع النبي )..
وقد سأله رجل عن عمل يقربه من الجنة فقال( صلى الله عليه وآله)::
(اشتر سقاءً جديدا ثم اسق فيها حتى تحترفها فتبلغ بها عمل الجنة )…
وفي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام ) قال : (من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة , ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيى نفسا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس أجمعين )..
لذا فإن الماء له خصوصية الحياة للعالم والوجود وقد أكد على ذلك الإمام الصادق (عليه السلام ) عندما سئل ما طعم الماء ؟؟ فقال (عليه السلام ): (طعم الحياة )…
وهنا لا غرابة إن قلنا أن السقاية وراثة ورثها قمر بني هاشم (عليه السلام ) ساقي عطاشى كربلاء من أجداده العظام خلفا عن سلف من قصي إلى عبد مناف إلى هاشم إلى عبد المطلب إلى والده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام )
والتاريخ الإسلامي يحدثنا عن سقاية الحاج عند بني هاشم.. فضلاً عن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سقى المسلمين في غزوة بدر الكبرى عندما تقاعس المسلمون عن النزول في القليب ونزل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) غير خائف ولا يهاب أي شيء واتى بالماء وسقى الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) والمسلمين جمعاء بعد العطش الشديد الذي أصابهم فكان الإمام (عليه السلام) هو المنقذ للمسلمين ..
فالذي أتى به أبو الفضل العباس(عليه السلام ) لا يوازيه شيء في ذلك اليوم يوم الطف, حيث صارع جبالاً من حديد ببأسه الشديد حتى اخترق الصفوف وزعزع الألوف وليس له هم في ذلك المأزق الحرج سوى إغاثة شخصية الرسالة المحمدية والنفوس المقدسة من الذرية العلوية الطيبة ولم يكتفِ بذلك بل أبت نفسه الكريمة أن يلتذ بشيء من الماء قبل أن يلتذ به أخوه الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام )…
كما ذكرت الروايات أنه في اليوم السابع من محرم الحرام إلتاع أبو الفضل العبّاس عليه السلام كأشدّ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة حينما رأى أطفال أخيه وأهل بيته وهم يستغيثون من الظمأ القاتل ، فانبرى الشهم النبيل لتحصيل الماء ، وأخذه بالقوة ، وقد صحب معه ثلاثين فارساً ، وعشرين راجلاً، وحملوا معهم عشرين قربة ، وهجموا بأجمعهم على نهر الفرات وقد تقدّمهم نافع بن هلال المرادي وهو من أفذاذ أصحاب الامام الحسين فاستقبله عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو من مجرمي حرب كربلاء وقد إعهدت إليه حراسة الفرات فقال لنافع:
( ما جاء بك؟ )
جئنا لنشرب الماء الذي حلأتمونا عنه..
فقال إشرب هنيئاً.
فأجاب أفأشرب والحسين عطشان ، ومن ترى من أصحابه؟..
فقال له لا سبيل إلى سقي هؤلاء ، انّما وضعنا بهذا المكان لمنعهم عن الماء…
ولم يعنَ به الأبطال من أصحاب الاِمام الحسين (عليه السلام) ، وسخروا من كلامه ، فاقتحموا الفرات ليملاَوا قربهم منه ، فثار في وجوههم عمرو بن الحجاج ومعه مفرزة من جنوده ، والتحم معهم بطل كربلاء أبو الفضل (عليه السلام)، ونافع بن هلال، ودارت بينهم معركة إلاّ انّه لم يقتل فيها أحد من الجانبين ، وعاد أصحاب الإمام بقيادة أبي الفضل عليهم السلام ، وقد ملأوا قربهم من الماء.
وقد روى أبو الفضل (عليه السلام) عطاشى أهل البيت (عليهم السلام) ، وأنقذهم من الظمأ ، وقد مُنِحَ منذ ذلك اليوم لقب (السقاء) وهو من أشهر ألقابه ، وأكثرها ذيوعاً بين الناس كما أنّه من أحبّ الألقاب وأعزّها عنده.
السقاية ، هي من أفضل الأعمال في الشريعة لأنها إحياء النفس وصيانتها من الهلاك ..وهذا ما بينه الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله ) حيث قال:(أفضل الأعمال عند الله إبراد الكبد الحرّى من بهيمة وغيرها ولو كان على الماء فانه يوجب تناثر الذنوب كما تنثر من ورق الشجر فأعطاه الله بكل قطرة يبذلها قنطاراً في الجنة وسقاه من الرحيق المختوم وان كان فلاة من الأرض ورد حياض القدس مع النبي )..
وقد سأله رجل عن عمل يقربه من الجنة فقال( صلى الله عليه وآله)::
(اشتر سقاءً جديدا ثم اسق فيها حتى تحترفها فتبلغ بها عمل الجنة )…
وفي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام ) قال : (من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة , ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيى نفسا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس أجمعين )..
لذا فإن الماء له خصوصية الحياة للعالم والوجود وقد أكد على ذلك الإمام الصادق (عليه السلام ) عندما سئل ما طعم الماء ؟؟ فقال (عليه السلام ): (طعم الحياة )…
وهنا لا غرابة إن قلنا أن السقاية وراثة ورثها قمر بني هاشم (عليه السلام ) ساقي عطاشى كربلاء من أجداده العظام خلفا عن سلف من قصي إلى عبد مناف إلى هاشم إلى عبد المطلب إلى والده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام )
والتاريخ الإسلامي يحدثنا عن سقاية الحاج عند بني هاشم.. فضلاً عن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سقى المسلمين في غزوة بدر الكبرى عندما تقاعس المسلمون عن النزول في القليب ونزل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) غير خائف ولا يهاب أي شيء واتى بالماء وسقى الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) والمسلمين جمعاء بعد العطش الشديد الذي أصابهم فكان الإمام (عليه السلام) هو المنقذ للمسلمين ..
فالذي أتى به أبو الفضل العباس(عليه السلام ) لا يوازيه شيء في ذلك اليوم يوم الطف, حيث صارع جبالاً من حديد ببأسه الشديد حتى اخترق الصفوف وزعزع الألوف وليس له هم في ذلك المأزق الحرج سوى إغاثة شخصية الرسالة المحمدية والنفوس المقدسة من الذرية العلوية الطيبة ولم يكتفِ بذلك بل أبت نفسه الكريمة أن يلتذ بشيء من الماء قبل أن يلتذ به أخوه الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام )…
كما ذكرت الروايات أنه في اليوم السابع من محرم الحرام إلتاع أبو الفضل العبّاس عليه السلام كأشدّ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة حينما رأى أطفال أخيه وأهل بيته وهم يستغيثون من الظمأ القاتل ، فانبرى الشهم النبيل لتحصيل الماء ، وأخذه بالقوة ، وقد صحب معه ثلاثين فارساً ، وعشرين راجلاً، وحملوا معهم عشرين قربة ، وهجموا بأجمعهم على نهر الفرات وقد تقدّمهم نافع بن هلال المرادي وهو من أفذاذ أصحاب الامام الحسين فاستقبله عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو من مجرمي حرب كربلاء وقد إعهدت إليه حراسة الفرات فقال لنافع:
( ما جاء بك؟ )
جئنا لنشرب الماء الذي حلأتمونا عنه..
فقال إشرب هنيئاً.
فأجاب أفأشرب والحسين عطشان ، ومن ترى من أصحابه؟..
فقال له لا سبيل إلى سقي هؤلاء ، انّما وضعنا بهذا المكان لمنعهم عن الماء…
ولم يعنَ به الأبطال من أصحاب الاِمام الحسين (عليه السلام) ، وسخروا من كلامه ، فاقتحموا الفرات ليملاَوا قربهم منه ، فثار في وجوههم عمرو بن الحجاج ومعه مفرزة من جنوده ، والتحم معهم بطل كربلاء أبو الفضل (عليه السلام)، ونافع بن هلال، ودارت بينهم معركة إلاّ انّه لم يقتل فيها أحد من الجانبين ، وعاد أصحاب الإمام بقيادة أبي الفضل عليهم السلام ، وقد ملأوا قربهم من الماء.
وقد روى أبو الفضل (عليه السلام) عطاشى أهل البيت (عليهم السلام) ، وأنقذهم من الظمأ ، وقد مُنِحَ منذ ذلك اليوم لقب (السقاء) وهو من أشهر ألقابه ، وأكثرها ذيوعاً بين الناس كما أنّه من أحبّ الألقاب وأعزّها عنده.
موقفه في الطف
ربما يستعصي البيان عن الإفاضة في القول في هذا الفصل لشدة وضوحه، وربما أعقب الظهور خفاء، فإن من أبرز الصفات الحميدة في الهاشميين الشجاعة وقد جبلوا عليها، وبالأخص الطالبيين، وقد أوقفنا على هذه الظاهرة الحديث النبوي: ” لو ولد الناس أبو طالب كلهم لكانوا شجعانا “.
إذا فما ظنك بطالبي أبوه أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل عمر بن عبد ود، ومزهق مرحب، وقالع باب خيبر، وقد أودع في ولده البسالة كلها والشهامة بأسرها، وعلمه قراع الكتائب، فنشأ بين حروب طاحنة، وغارات شعواء، وخؤولته العامريون الذين شهد لهم عقيل بالفروسية، وللخؤولة كالعمومة عرق ضارب في الولد، ومن هنا قالت العرب: (فلان معم مخول) إذا كان كريمهم وحوى المزايا الحميدة عنهما(2)، ولم يعقد أمير المؤمنين (عليه السلام) على أم البنين إلا لتلد له هذا الفارس المغوار والبطل المجرب، فما أخطأت إرادته الغرض، ولا حاد سهمه المرمى.
فكان أبو الفضل رمز البطولة، ومثال الصولات، يلوح البأس على أسارير جبهته، فإذا يمم كميا قصده الموت معه، أو التقى بمقبل ولاه دبره، ولم يبرح هكذا تشكوه الحرب والضرب، وتشكوه الهامات، والأعناق ما خاض ملحمة إلا وكان ليلها المعتكر، ولم يلفِ في معركة إلا وقابل ببشره وجهها المكفهر.
يمثل الكرار في كرّاته… بل في المعاني الغر من صفاته
ليس يد الله سوى أبيه … وقدرة الله تجلت فيه
فهو يد الله وهذا ساعده… تغنيك عن إثباته مشاهده
صولته عند النزال صولته… لولا الغلو قلت: جلت قدرته
وهل في وسع الشاعر أن ينضد خياله، أو يتسنى للكاتب أن يسترسل في وصف تلك البسالة الحيدرية، وجوهر الحقيقة؟ قائم بنفسه، ماثل أمام الباحث، بأجلى من كل هاتيك المعرفات في مشهد يوم الطف.
إن حديث كربلاء لم يبق لسابق في الشجاعة سبقا ولا للاحق طريقا إلا الالتحاق به، فلقد استملينا أخبار الشجعان في الحروب والمغازي يوم شأوا الأقران في الفروسية، فلم يعدهم في الغالب الاستظهار بالعدد، وتوفر العتاد وتهيّؤ ممدات الحياة من المطعم والمشرب، وفي الغالب أن الكفاية بين الجيشين المتقابلين موجودة.
يسترسل المؤرخون لذكر شجعان الجاهلية والحالة كما وصفناها، واهتزوا طربا لقصة ربيعة بن مكدم، وهي: أن ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان من بني مالك بن كنانة كان أحد فرسان مضر المعدودين، خرج بالضعينة وفيها أمه أم سنان من بني أشجع بن عامر بن ليس بن بكر بن كنانة، وأخته أم عزة، وأخوه أبو القرعة، ورأى الظعينه دريد بن الصمة فقال لرجل معه: صح بالرجل أن خل الظعينة وانج بنفسك، وهو لا يعرفه، فلما رأى ربيعة أن الرجل قد ألح عليه ألقى زمام الناقة وحمل على الرجل فصرعه، فبعث دريد آخر فصرعه ربيعة، فبعث الثالث ليعلم خبر الأولين فقتله ربيعة وقد انكسر رمحه، فلما وافاه دريد ورأى الثلاثة صرعى ورمحه مكسورا قال له: يا فتى مثلك لا يقتل، وهؤلاء يثأرون، ولا رمح لك، ولكن خذ رمحي وانج بنفسك والظعينة، ثم دفع إليه رمحه ورجع دريد إلى القوم وأعلمهم أن الرجل قتل الثلاثة وغلبه على رمحه، وقد منع بالظعينة، فلا طمع لكم فيه.
هذا الذي حفظته السيرة مأثرة لربيعة بن مكدم بتهالكه دون الظعائن حتى انكسر رمحه، ولكن أين هو من (حامى الظعينة) يوم قاتل الألوف، وزعزع الصفوف عن المشرعة حتى ملك الماء وملأ القربة، والكل يرونه ويحذرونه؟!
وأنى لربيعة من بواسل ذلك المشهد الرهيب فضلا عن سيدهم أبي الفضل، فلقد كان جامع رأيهم، فلم يقدهم إلا إلى محل الشرف، منكبا بهم عن خطة الخسف والضعة، على حين أن الأبطال تتقاذف بهم سكرات الموت؟!
هذا وللسبط المقدس طرف شاخص إلى صنوه البطل المقدام كيف يرسب ويطفو بين بهم الرجال، ووجهه متهلل لكرّاته، ولحرائر بيت النبوة أمل موطد لحامية الظعائن.
وإليك مثالا من بسالته الموصوفة في ذلك المشهد الدامي، وهي لا تدعك إلا مذعنا بما له من ثبات ممنع عند الهزاهز، وطمأنينة لدى الأهوال.
الأول:في اليوم السابع من المحرم حوصر سيد الشهداء ومن معه، وسد عنهم باب الورود، ونفذ ما عندهم من الماء، فعاد كل منهم يعالج لهب الأوام(1)، وبطبع الحال كانوا بين أنة وحنة، وتضور، ونشيج، ومتطلب للماء إلى متحر ما يبل غلته، وكل ذلك بعين ” أبي علي “، والغيارى من آله، والأكارم من صحبه، وما عسى أن يجدوا لهم وبينهم وبين الماء رماح مشرعة وبوارق مرهفة، في جمع كثيف يرأسهم عمرو بن الحجاج، لكن ” ساقي العطاشى ” لم يتطامن على تحمل تلك الحالة.
أوتشتكي العطش الفواطم عنده… وبصدر صعدته الفرات المفعم
ولو استقى نهر المحمرة لارتقى… وطويل ذابله إليها سلم
لو سد ذو القرنين دون وروده …نسفته همته بما هو أعظم
في كفه اليسرى السقاء يقله …وبكفه اليمنى الحسام المخذم
مثل السحابة للفواطم صوبه… فيصيب حاصبه العدو فيرجم
هناك أوكل الحسين لهذه المهمة أخاه العباس، في حين أن نفسه الكريمة تنازعه إلى ذلك قبل الطلب، ويحدوه إليه حفاظه المر، فأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وإن كان دونه شق المرائر، وسفك المهج، وضم إليه ثلاثين فارسا وعشرين راجلا، وبعث معهم عشرين قربة، وتقدم أمامهم نافع بن هلال الجملي، فمضوا غير مبالين وكل بحفظ الشريعة ; لأنهم محتفون بسيدٍ من سادات آل محمد، فتقدم نافع باللواء وصاح به عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ وما جاء بك؟
قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه.
فقال له: أشرب هنيئا.
قال نافع: لا والله لا أشرب منه قطرة والحسين ومن ترى من آله وصحبه عطاشا.
فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء، وإنما وضعنا هاهنا لنمنعهم الماء، ثم صاح نافع بأصحابه: إملأوا قربكم، وشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القرب وبعض يقاتل، وحاميهم ” ابن بجدتها ” مسدد الكماة، المتربي في حجر البسالة الحيدرية، والمرتضع من لبانها ” أبو الفضل “، فجاؤوا بالماء وليس في القوم المناوئين من تحدثه نفسه بالدنو منهم، فرقا من ذلك البطل المغوار، فبلت غلة الحرائر والصبية الطيبة من ذلك الماء، وابتهجت به النفوس.
ولكن لا يفوت القارئ، معرفة أن تلك الكمية القليلة من الماء ما عسى أن تجدي أولئك الجمع الذي هو أكثر من مائة وخمسين رجالا ونساء وأطفالا، أو أنهم ينيفون على المائتين على بعض الروايات، ومن المقطوع به أنه لم ترو أكبادهم إلا مرة واحدة، أو أنها كمصة الوشل، فسرعان ما عاد إليهم الظما، وإلى الله سبحانه المشتكى.
الثاني: كان أصحاب الحسين (عليه السلام) بعد الحملة الأولى التي استشهد فيها خمسون، يخرج الاثنان والثلاثة والأربعة، وكل يحمي الآخر من كيد عدوه، فخرج الجابريان وقاتلا حتى قتلا، وخرج الغفاريان فقاتلا معا حتى قتلا، وقاتل الحر الرياحي ومعه زهير بن القين يحمي ظهره حتى فعلا ذلك ساعة، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنقذه حتى قتل الحر.
وفي تاريخ الطبري ج6 ص255: ” إن عمرو بن خالد الصيداوي، وسعد مولاه، وجابر بن الحارث السلماني، ومجمع بن عبد الله العائذي شدوا جميعا على أهل الكوفة، فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس من كل جانب، وقطعوهم عن أصحابهم، فندب إليهم الحسين أخاه العباس، فاستنقذهم بسيفه، وقد جرحوا بأجمعهم، وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو، فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد، وفازوا بالسعادة الخالدة.
إذا فما ظنك بطالبي أبوه أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل عمر بن عبد ود، ومزهق مرحب، وقالع باب خيبر، وقد أودع في ولده البسالة كلها والشهامة بأسرها، وعلمه قراع الكتائب، فنشأ بين حروب طاحنة، وغارات شعواء، وخؤولته العامريون الذين شهد لهم عقيل بالفروسية، وللخؤولة كالعمومة عرق ضارب في الولد، ومن هنا قالت العرب: (فلان معم مخول) إذا كان كريمهم وحوى المزايا الحميدة عنهما(2)، ولم يعقد أمير المؤمنين (عليه السلام) على أم البنين إلا لتلد له هذا الفارس المغوار والبطل المجرب، فما أخطأت إرادته الغرض، ولا حاد سهمه المرمى.
فكان أبو الفضل رمز البطولة، ومثال الصولات، يلوح البأس على أسارير جبهته، فإذا يمم كميا قصده الموت معه، أو التقى بمقبل ولاه دبره، ولم يبرح هكذا تشكوه الحرب والضرب، وتشكوه الهامات، والأعناق ما خاض ملحمة إلا وكان ليلها المعتكر، ولم يلفِ في معركة إلا وقابل ببشره وجهها المكفهر.
يمثل الكرار في كرّاته… بل في المعاني الغر من صفاته
ليس يد الله سوى أبيه … وقدرة الله تجلت فيه
فهو يد الله وهذا ساعده… تغنيك عن إثباته مشاهده
صولته عند النزال صولته… لولا الغلو قلت: جلت قدرته
وهل في وسع الشاعر أن ينضد خياله، أو يتسنى للكاتب أن يسترسل في وصف تلك البسالة الحيدرية، وجوهر الحقيقة؟ قائم بنفسه، ماثل أمام الباحث، بأجلى من كل هاتيك المعرفات في مشهد يوم الطف.
إن حديث كربلاء لم يبق لسابق في الشجاعة سبقا ولا للاحق طريقا إلا الالتحاق به، فلقد استملينا أخبار الشجعان في الحروب والمغازي يوم شأوا الأقران في الفروسية، فلم يعدهم في الغالب الاستظهار بالعدد، وتوفر العتاد وتهيّؤ ممدات الحياة من المطعم والمشرب، وفي الغالب أن الكفاية بين الجيشين المتقابلين موجودة.
يسترسل المؤرخون لذكر شجعان الجاهلية والحالة كما وصفناها، واهتزوا طربا لقصة ربيعة بن مكدم، وهي: أن ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان من بني مالك بن كنانة كان أحد فرسان مضر المعدودين، خرج بالضعينة وفيها أمه أم سنان من بني أشجع بن عامر بن ليس بن بكر بن كنانة، وأخته أم عزة، وأخوه أبو القرعة، ورأى الظعينه دريد بن الصمة فقال لرجل معه: صح بالرجل أن خل الظعينة وانج بنفسك، وهو لا يعرفه، فلما رأى ربيعة أن الرجل قد ألح عليه ألقى زمام الناقة وحمل على الرجل فصرعه، فبعث دريد آخر فصرعه ربيعة، فبعث الثالث ليعلم خبر الأولين فقتله ربيعة وقد انكسر رمحه، فلما وافاه دريد ورأى الثلاثة صرعى ورمحه مكسورا قال له: يا فتى مثلك لا يقتل، وهؤلاء يثأرون، ولا رمح لك، ولكن خذ رمحي وانج بنفسك والظعينة، ثم دفع إليه رمحه ورجع دريد إلى القوم وأعلمهم أن الرجل قتل الثلاثة وغلبه على رمحه، وقد منع بالظعينة، فلا طمع لكم فيه.
هذا الذي حفظته السيرة مأثرة لربيعة بن مكدم بتهالكه دون الظعائن حتى انكسر رمحه، ولكن أين هو من (حامى الظعينة) يوم قاتل الألوف، وزعزع الصفوف عن المشرعة حتى ملك الماء وملأ القربة، والكل يرونه ويحذرونه؟!
وأنى لربيعة من بواسل ذلك المشهد الرهيب فضلا عن سيدهم أبي الفضل، فلقد كان جامع رأيهم، فلم يقدهم إلا إلى محل الشرف، منكبا بهم عن خطة الخسف والضعة، على حين أن الأبطال تتقاذف بهم سكرات الموت؟!
هذا وللسبط المقدس طرف شاخص إلى صنوه البطل المقدام كيف يرسب ويطفو بين بهم الرجال، ووجهه متهلل لكرّاته، ولحرائر بيت النبوة أمل موطد لحامية الظعائن.
وإليك مثالا من بسالته الموصوفة في ذلك المشهد الدامي، وهي لا تدعك إلا مذعنا بما له من ثبات ممنع عند الهزاهز، وطمأنينة لدى الأهوال.
الأول:في اليوم السابع من المحرم حوصر سيد الشهداء ومن معه، وسد عنهم باب الورود، ونفذ ما عندهم من الماء، فعاد كل منهم يعالج لهب الأوام(1)، وبطبع الحال كانوا بين أنة وحنة، وتضور، ونشيج، ومتطلب للماء إلى متحر ما يبل غلته، وكل ذلك بعين ” أبي علي “، والغيارى من آله، والأكارم من صحبه، وما عسى أن يجدوا لهم وبينهم وبين الماء رماح مشرعة وبوارق مرهفة، في جمع كثيف يرأسهم عمرو بن الحجاج، لكن ” ساقي العطاشى ” لم يتطامن على تحمل تلك الحالة.
أوتشتكي العطش الفواطم عنده… وبصدر صعدته الفرات المفعم
ولو استقى نهر المحمرة لارتقى… وطويل ذابله إليها سلم
لو سد ذو القرنين دون وروده …نسفته همته بما هو أعظم
في كفه اليسرى السقاء يقله …وبكفه اليمنى الحسام المخذم
مثل السحابة للفواطم صوبه… فيصيب حاصبه العدو فيرجم
هناك أوكل الحسين لهذه المهمة أخاه العباس، في حين أن نفسه الكريمة تنازعه إلى ذلك قبل الطلب، ويحدوه إليه حفاظه المر، فأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وإن كان دونه شق المرائر، وسفك المهج، وضم إليه ثلاثين فارسا وعشرين راجلا، وبعث معهم عشرين قربة، وتقدم أمامهم نافع بن هلال الجملي، فمضوا غير مبالين وكل بحفظ الشريعة ; لأنهم محتفون بسيدٍ من سادات آل محمد، فتقدم نافع باللواء وصاح به عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ وما جاء بك؟
قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه.
فقال له: أشرب هنيئا.
قال نافع: لا والله لا أشرب منه قطرة والحسين ومن ترى من آله وصحبه عطاشا.
فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء، وإنما وضعنا هاهنا لنمنعهم الماء، ثم صاح نافع بأصحابه: إملأوا قربكم، وشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القرب وبعض يقاتل، وحاميهم ” ابن بجدتها ” مسدد الكماة، المتربي في حجر البسالة الحيدرية، والمرتضع من لبانها ” أبو الفضل “، فجاؤوا بالماء وليس في القوم المناوئين من تحدثه نفسه بالدنو منهم، فرقا من ذلك البطل المغوار، فبلت غلة الحرائر والصبية الطيبة من ذلك الماء، وابتهجت به النفوس.
ولكن لا يفوت القارئ، معرفة أن تلك الكمية القليلة من الماء ما عسى أن تجدي أولئك الجمع الذي هو أكثر من مائة وخمسين رجالا ونساء وأطفالا، أو أنهم ينيفون على المائتين على بعض الروايات، ومن المقطوع به أنه لم ترو أكبادهم إلا مرة واحدة، أو أنها كمصة الوشل، فسرعان ما عاد إليهم الظما، وإلى الله سبحانه المشتكى.
الثاني: كان أصحاب الحسين (عليه السلام) بعد الحملة الأولى التي استشهد فيها خمسون، يخرج الاثنان والثلاثة والأربعة، وكل يحمي الآخر من كيد عدوه، فخرج الجابريان وقاتلا حتى قتلا، وخرج الغفاريان فقاتلا معا حتى قتلا، وقاتل الحر الرياحي ومعه زهير بن القين يحمي ظهره حتى فعلا ذلك ساعة، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنقذه حتى قتل الحر.
وفي تاريخ الطبري ج6 ص255: ” إن عمرو بن خالد الصيداوي، وسعد مولاه، وجابر بن الحارث السلماني، ومجمع بن عبد الله العائذي شدوا جميعا على أهل الكوفة، فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس من كل جانب، وقطعوهم عن أصحابهم، فندب إليهم الحسين أخاه العباس، فاستنقذهم بسيفه، وقد جرحوا بأجمعهم، وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو، فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد، وفازوا بالسعادة الخالدة.
موقفه قبل الطف
يسترسل بعض الكتاب عن موقفه قبل الطف فيثبت له منازلة الأقران والضرب والطعن، وبالغوا في ذلك حتى حكي عن المنتخب أنه يقول: كان كالجبل العظيم، وقلبه كالطود الجسيم ; لأنه كان فارسا هماما وجسورا على الضرب والطعن في ميدان الكفار.
ويحدث صاحب الكبريت الأحمر ج3 ص24 عن بعض الكتب المعتبرة لتتبع صاحبها: أنه عليه السلام كان عضدا لأخيه الحسين يوم حمل على الفرات وأزاح عنه جيش معاوية وملك الماء.
قال: ومما يروى: أنه في بعض أيام صفين خرج من جيش أمير المؤمنين (عليه السلام) شاب على وجهه نقاب، تعلوه الهيبة، وتظهر عليه الشجاعة، يقدر عمره بسبع عشرة سنة، يطلب المبارزة، فهابه الناس، وندب معاوية إليه أبا الشعثاء، فقال: إن أهل الشام يعدونني بألف فارس، ولكن أرسل إليه أحد أولادي، وكانوا سبعة، وكلما خرج أحد منهم قتله حتى أتى عليهم، فساء ذلك أبا الشعثاء وأغضبه، ولما برز إليه ألحقه بهم، فهابه الجمع ولم يجرؤ أحد على مبارزته، وتعجب أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذه البسالة التي لاتعدو الهاشميين، ولم يعرفوه لمكان نقابه، ولما رجع إلى مقره دعاهُ أبوه أمير المؤمنين (عليه السلام) وأزال النقاب عنه، فإذا هو ” قمر بني هاشم ” ولده العباس (عليه السلام).
قال صاحب الكبريت بعد هذه الحكاية: وليس ببعيد صحة الخبر، لأن عمره يقدر بسبع عشرة سنة، وقد قال الخوارزمي: كان تاما كاملا.
وهذا نص الخوارزمي في المناقب ص147: ” خرج من عسكر معاوية رجل يقال له: كريب، كان شجاعا قويا يأخذ الدرهم فيغمزه بابهامه فتذهب كتابته، فنادى ليخرج إلي علي، فبرز إليه مرتفع بن وضاح الزبيدي فقتله، ثم برز إليه شرحبيل بن بكر فقتله، ثم برز إليه الحرث بن الحلاج الشيباني فقتله، فساء أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، فدعا ولده العباس (عليه السلام)، وكان تاما كاملا من الرجال، وأمره أن ينزل عن فرسه وينزع ثيابه، فلبس علي (عليه السلام) ثياب ولده العباس وركب فرسه، وألبس ابنه العباس ثيابه وأركبه فرسه، لئلا يجبن كريب عن مبارزته إذا عرفه، فلما برز إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) ذكّره الآخرة، وحذّره بأس الله وسخطه.
فقال كريب: لقد قتلت بسيفي هذا كثيرا من أمثالك، ثم حمل على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فاتقاه بالدرقة وضربه علي على رأسه فشقه نصفين، ورجع أمير المؤمنين وقال لولده محمد بن الحنفية: قف عند مصرع كريب، فإن طالب وتره يأتيك، فامتثل محمد أمر أبيه، فأتاه أحد بني عمه وسأله عن قاتل كريب؟ قال محمد: أنا مكانه، فتجاولا ثم قتله محمد، وخرج إليه آخر فقتله محمد حتى أتى على سبعة منهم “(1).
وفي ص105 من المناقب ذكر حديث العباس بن الحارث بن عبد المطلب: ” وقد برز إليه عثمان بن وائل الحميري فقتله العباس، فبرز إليه أخوه حمزة، وكان شجاعا قويا، فنهاه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مبارزته، وقال له: انزع ثيابك وناولني سلاحك وقف مكانك، وأنا أخرج إليه، فتنكر أمير المؤمنين (عليه السلام) وبرز إليه وضربه على رأسه، فقطع نصف رأسه ووجهه وابطه وكتفه، فتعجب اليمانيون من هذه الضربة وهابوا العباس بن الحارث “.
هذا ما حدث به في المناقب، ومنه نعرف أن هناك واقعتين جرتا لأمير المؤمنين (عليه السلام) مع ولده العباس ومع العباس بن الحارث.
فانكار شيخنا الجليل المحدث النوري في حضور العباس في صفين، مدعيا اشتباه الأمر على بعض الرواة بالعباس بن الحارث في غير محله، فإن الحجة على تفنيد الخبر غير تامة ; لأن آحاد هذا البيت ورجالاتهم قد فاقوا الكل في الفضائل جميعها، وجاؤوا بالخوارق في جميع المراتب، فليس من البدع إذا صدر من أحدهم ما يمتنع مثله عن الشجعان، وإن لم يبلغوا مبالغ الرجال.
فهذا القاسم بن الحسن السبط لم يبلغ الحلم يوم الطف، وقد ملأ ذلك المشهد الرهيب هيبة وأهدى إلى قلوب المقارعين فرقا، وإلى الفرائص ارتعادا، وإلى النفوس خورا، غير مبال بالجحفل الجرار، ولا مكترث بمزدحم الرجال حتى قتل خمسة وثلاثين فارسا(2)، وبطبع الحال فيهم من هو أقوى منه، لكن البسالة وراثة بين أشبال (علي)، على حد سواء، فهم فيها كأسنان المشط صغيرهم وكبيرهم، كما أنهم في الأنفة عن الدنية سيان، فلم يغتالوا الشبل الباسل حتى وقف يشد شسع نعله، وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، وقد أنف (شبل الوصي) أن يحتفي في الميدان.
أهوى يشد حذاءه … والحرب مشرعة لأجله
ليسومها ما إن غلت … هيجاؤها بشراك نعله
متقلدا صمصامه… متفيئا بظلال نصله
لا تعجبن لفعله … فالفرع مرتهن بأصله
السحب يخلفها الحيا …والليث منظور بشبله
يردي الطليعة منهُمُ… ويريهُمُ آيات فعله
وهذا عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب بارز يوم الطف الألوف مع صغر سنه، حتى قتل منهم على رواية محمد بن أبي طالب ثلاثة وتسعين رجلا بثلاث حملات.
وهذا محمد بن الحنفية فإن له مواقفا محمودة في الجمل وصفين والنهروان، وكانت الراية معه، فأبلى بلاء حسنا سجله له التاريخ وشكره الإسلام، وكان صغير السن على ما يظهر من السبط في تذكرة الخواص وابن كثير في البداية ج9 ص38(2)، فإنهما نصا على وفاته سنة 81 هـ عن خمس وستين فتكون ولادته سنة 16 هـ وله يوم البصرة الواقع سنة 36 عشرون سنة.
وحينئذ فلا غرابة في التحدث عن موقف أبي الفضل وما أبداه من كر وإقدام خصوصا بعد ما أوقفنا النص النبوي الآتي على ما حواه ولد أبي طالب من بسالة وبطولة.
وأما يوم شهادة أخيه الإمام المجتبى فله أربع وعشرون سنة وقد ذكر صاحب كتاب ” قمر بني هاشم ” ص84 أنه لما رأى جنازة سيد شباب أهل الجنة ترمى بالسهام عظم عليه الأمر، ولم يطق صبرا دون أن جرد سيفه وأراد البطش بأصحاب ” البغلة ” لولا كراهية السبط الشهيد الحرب، عملا بوصية أخيه ” لا تهرق في أمري محجمة من دم “(1)، فصبر أبو الفضل على أحر من جمر الغضا، ينتظر الفرصة، ويترقب الوعد الإلهي، فأجهد النفس، وبذل مهجته في مشهد (النواويس)، وحاز كلتا الحسنيين.
ويحدث صاحب الكبريت الأحمر ج3 ص24 عن بعض الكتب المعتبرة لتتبع صاحبها: أنه عليه السلام كان عضدا لأخيه الحسين يوم حمل على الفرات وأزاح عنه جيش معاوية وملك الماء.
قال: ومما يروى: أنه في بعض أيام صفين خرج من جيش أمير المؤمنين (عليه السلام) شاب على وجهه نقاب، تعلوه الهيبة، وتظهر عليه الشجاعة، يقدر عمره بسبع عشرة سنة، يطلب المبارزة، فهابه الناس، وندب معاوية إليه أبا الشعثاء، فقال: إن أهل الشام يعدونني بألف فارس، ولكن أرسل إليه أحد أولادي، وكانوا سبعة، وكلما خرج أحد منهم قتله حتى أتى عليهم، فساء ذلك أبا الشعثاء وأغضبه، ولما برز إليه ألحقه بهم، فهابه الجمع ولم يجرؤ أحد على مبارزته، وتعجب أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذه البسالة التي لاتعدو الهاشميين، ولم يعرفوه لمكان نقابه، ولما رجع إلى مقره دعاهُ أبوه أمير المؤمنين (عليه السلام) وأزال النقاب عنه، فإذا هو ” قمر بني هاشم ” ولده العباس (عليه السلام).
قال صاحب الكبريت بعد هذه الحكاية: وليس ببعيد صحة الخبر، لأن عمره يقدر بسبع عشرة سنة، وقد قال الخوارزمي: كان تاما كاملا.
وهذا نص الخوارزمي في المناقب ص147: ” خرج من عسكر معاوية رجل يقال له: كريب، كان شجاعا قويا يأخذ الدرهم فيغمزه بابهامه فتذهب كتابته، فنادى ليخرج إلي علي، فبرز إليه مرتفع بن وضاح الزبيدي فقتله، ثم برز إليه شرحبيل بن بكر فقتله، ثم برز إليه الحرث بن الحلاج الشيباني فقتله، فساء أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، فدعا ولده العباس (عليه السلام)، وكان تاما كاملا من الرجال، وأمره أن ينزل عن فرسه وينزع ثيابه، فلبس علي (عليه السلام) ثياب ولده العباس وركب فرسه، وألبس ابنه العباس ثيابه وأركبه فرسه، لئلا يجبن كريب عن مبارزته إذا عرفه، فلما برز إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) ذكّره الآخرة، وحذّره بأس الله وسخطه.
فقال كريب: لقد قتلت بسيفي هذا كثيرا من أمثالك، ثم حمل على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فاتقاه بالدرقة وضربه علي على رأسه فشقه نصفين، ورجع أمير المؤمنين وقال لولده محمد بن الحنفية: قف عند مصرع كريب، فإن طالب وتره يأتيك، فامتثل محمد أمر أبيه، فأتاه أحد بني عمه وسأله عن قاتل كريب؟ قال محمد: أنا مكانه، فتجاولا ثم قتله محمد، وخرج إليه آخر فقتله محمد حتى أتى على سبعة منهم “(1).
وفي ص105 من المناقب ذكر حديث العباس بن الحارث بن عبد المطلب: ” وقد برز إليه عثمان بن وائل الحميري فقتله العباس، فبرز إليه أخوه حمزة، وكان شجاعا قويا، فنهاه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مبارزته، وقال له: انزع ثيابك وناولني سلاحك وقف مكانك، وأنا أخرج إليه، فتنكر أمير المؤمنين (عليه السلام) وبرز إليه وضربه على رأسه، فقطع نصف رأسه ووجهه وابطه وكتفه، فتعجب اليمانيون من هذه الضربة وهابوا العباس بن الحارث “.
هذا ما حدث به في المناقب، ومنه نعرف أن هناك واقعتين جرتا لأمير المؤمنين (عليه السلام) مع ولده العباس ومع العباس بن الحارث.
فانكار شيخنا الجليل المحدث النوري في حضور العباس في صفين، مدعيا اشتباه الأمر على بعض الرواة بالعباس بن الحارث في غير محله، فإن الحجة على تفنيد الخبر غير تامة ; لأن آحاد هذا البيت ورجالاتهم قد فاقوا الكل في الفضائل جميعها، وجاؤوا بالخوارق في جميع المراتب، فليس من البدع إذا صدر من أحدهم ما يمتنع مثله عن الشجعان، وإن لم يبلغوا مبالغ الرجال.
فهذا القاسم بن الحسن السبط لم يبلغ الحلم يوم الطف، وقد ملأ ذلك المشهد الرهيب هيبة وأهدى إلى قلوب المقارعين فرقا، وإلى الفرائص ارتعادا، وإلى النفوس خورا، غير مبال بالجحفل الجرار، ولا مكترث بمزدحم الرجال حتى قتل خمسة وثلاثين فارسا(2)، وبطبع الحال فيهم من هو أقوى منه، لكن البسالة وراثة بين أشبال (علي)، على حد سواء، فهم فيها كأسنان المشط صغيرهم وكبيرهم، كما أنهم في الأنفة عن الدنية سيان، فلم يغتالوا الشبل الباسل حتى وقف يشد شسع نعله، وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، وقد أنف (شبل الوصي) أن يحتفي في الميدان.
أهوى يشد حذاءه … والحرب مشرعة لأجله
ليسومها ما إن غلت … هيجاؤها بشراك نعله
متقلدا صمصامه… متفيئا بظلال نصله
لا تعجبن لفعله … فالفرع مرتهن بأصله
السحب يخلفها الحيا …والليث منظور بشبله
يردي الطليعة منهُمُ… ويريهُمُ آيات فعله
وهذا عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب بارز يوم الطف الألوف مع صغر سنه، حتى قتل منهم على رواية محمد بن أبي طالب ثلاثة وتسعين رجلا بثلاث حملات.
وهذا محمد بن الحنفية فإن له مواقفا محمودة في الجمل وصفين والنهروان، وكانت الراية معه، فأبلى بلاء حسنا سجله له التاريخ وشكره الإسلام، وكان صغير السن على ما يظهر من السبط في تذكرة الخواص وابن كثير في البداية ج9 ص38(2)، فإنهما نصا على وفاته سنة 81 هـ عن خمس وستين فتكون ولادته سنة 16 هـ وله يوم البصرة الواقع سنة 36 عشرون سنة.
وحينئذ فلا غرابة في التحدث عن موقف أبي الفضل وما أبداه من كر وإقدام خصوصا بعد ما أوقفنا النص النبوي الآتي على ما حواه ولد أبي طالب من بسالة وبطولة.
وأما يوم شهادة أخيه الإمام المجتبى فله أربع وعشرون سنة وقد ذكر صاحب كتاب ” قمر بني هاشم ” ص84 أنه لما رأى جنازة سيد شباب أهل الجنة ترمى بالسهام عظم عليه الأمر، ولم يطق صبرا دون أن جرد سيفه وأراد البطش بأصحاب ” البغلة ” لولا كراهية السبط الشهيد الحرب، عملا بوصية أخيه ” لا تهرق في أمري محجمة من دم “(1)، فصبر أبو الفضل على أحر من جمر الغضا، ينتظر الفرصة، ويترقب الوعد الإلهي، فأجهد النفس، وبذل مهجته في مشهد (النواويس)، وحاز كلتا الحسنيين.
الشهادة
لم يزلْ قمر بني هاشم دؤوباً على مناصرة الحق في شمم وإباء مرتفعاً عن النزول على حكم الدنيّة، منذُ أن أرتضع لبان البسالة، وتربى في حجر الإمامة، فترعرع ونُصبُ عينه أمثلة الشجاعة والتضحية دون النواميس الإلهية، لمطاردة الرجال، ومجالدة الأبطال، فإما فوز بالظفر أو ظفر بالشهادة، فمن الصعب عنده النزول على الضيم، وهو يرى الموت تحت مشتبك الأسنة أسعد من حياة تحت الاضطهاد، فكان لا يرى للبقاء قيمة ” وإمام الحق ” مكدور، وعقائل بيت الوحي قد بلغ منهن الكرب كل مبلغ.
ولكن لما كان (سلام الله عليه) أنفس الذخائر عند السبط الشهيد، وأعز حُماتِهِ لديه، وطمأنينة الحرم بوجوده وبسيفه الشاهر، ولوائه الخفاق، وبطولته المعلومة ; لم يأذن له إلى النفس الأخير من النهضة المقدسة، فلا الحسين يسمح به، ولا العائلة الكريمة تألف بغيره، ولا الحالة تدعه لأن يغادر حرائر أبيه بين الوحوش الكواسر.
هكذا كان أبو الفضل (عليه السلام) بين نزوع إلى الكفاح بمقتضى غريزته، وتأخر عن الحركة لباعث ديني وهو طاعة الإمام (عليه السلام)، حتى بلغ الأمر نصابه، فلم يكن لجانب الغيرة أو دافعها مكافئ، وكان ملء سمعه ضوضاء الحرم من العطش تارة، ومن البلاء المقبل أخرى، (ومركز الإمامة) دارت عليه الدوائر، وتقطعت عنه خطوط المدد، وتفانى صحبه وذووه.
هنالك أنتفض (صاحب اللواء) ـ ولا يلحقه الليث عند الهياج ـ فمثل أمام أخيه الشهيد يستأذنه، فلم يجد أبو عبد الله بُدّاً من الإذن، حيث وجد نفسه لتسبق جسمه إذ ليس في وسعه البقاء على تلك الكوارث الملمة من دون أن يأخذ ثأره من أولئك المردة، فعّرفه الحسين أنه مهما ينظر اللواء مرفوعاً فإنّه يرى العسكر متصلاً، والمدد متتابعاً، والأعداء تحذر صولته، وترهب إقدامه، وحرائر النبوة مطمئنة بوجوده، فقال له: ” أنت صاحب لوائي “، ولكن اطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء.
فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم ينفع، فرجع إلى أخيه وأخبره، فسمع الأطفال يتصارخون من العطش، فنهضت (بساقي العطاشى) غيرته الشماء، وأخذ القربة، وركب فرسه، وقصد الفرات، فلم يرعه الجمع المتكاثر، وكشفهم شبل علي عن الماء، وملك الشريعة، ومذ أحسّ ببرده تذكّر عطش الحسين، فرأى من واجبه ترك الشرب ; لأن الإمام ومن معه أضّر بهم العطش، فرمى الماء من يده وأسرع بالقربة محافظاً على مهجة الإمام ولو في آن يسير وقال(1):
يا نفس من بعد الحسين هوني… وبعده لا كنت أن تكوني
هذا الحسين وارد المنون… وتشربين بارد المعين
تالله ما هذا فعال ديني
فتكاثروا عليه وقطعوا طريقه، فلم يبال بهم، وجعل يضرب فيهم بسيفه ويقول:
لا أرهب الموت إذا الموت زقا …حتى أوارى في المصاليت لقا
إني أنا العباس أغدو بالسقا …ولا أهاب الموت يوم الملتقى
فكمن له زيد بن الرقاد الجهني، وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي، فضربه على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله وجعل يضرب فيهم ويقول:
والله إن قطعتُمُ يميني …إني أحامي أبدا عن ديني
وعن إمام صادق اليقين …نجل النبي الطاهر الأمين
فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة، فضربه على شماله فبراها، فضم اللواء إلى صدره.
فعند ذلك أمنوا سطوته، وتكاثروا عليه، وأتته السهام كالمطر، فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب عينه، وحمل عليه رجل بعمود من حديد وضربه على رأسه المقدس.
وهوى بجنب العلقمي فليته … للشاربين به يداف العلقم
ونادى بصوت عالٍ: عليك مني السلام يا أبا عبد الله(1)، فأتاه الحسين (عليه السلام)، ويا لهف نفسي بماذا أتاه، أبحياة مستطارة منه بذلك الفادح الجلل، أو بجاذب من الأخوة إلى مصرع صنوه المحبوب!
نعم، وصل الحسين عنده وهو يبصر هيكل البسالة وقربان القداسة فوق الصعيد، وقد غشيته الدماء السائلة، وجللته النبال، ورأى ذلك الغصن الباسق قد ألم به الذبول، فلا يمين تبطش، ولا منطق يرتجز، ولا صولة ترهب، ولا عين تبصر، ومرتكز الدماغ على الأرض مبدد.
أصحيح أن الحسين ينظر إلى تلكم الفجائع ومعه حياة تقدمه، أو عافية تنهض به؟ لا والله لم يبق الحسين بعد أبي الفضل إلا هيكلا شاخصا، معرى عن لوازم الحياة، وقد أعرب سلام الله عليه عن هذا الحال بقوله: ” الآن انكسر ظهري، وقلت حيلتي، وشمت بي عدوي “.
وبانَ الانكسارُ في جبينِهِ … فانكّدت الجبال من حنينِهِ
كافل أهله وساقي صبيتِهْ … وحامل اللوا بعالي هّمتِهْ
وكيف لا وهو جمال بهجتِهْ …وفي محياه سرور مهجتِهْ
ورجع إلى المخيم منكسرا حزينا باكيا يكفكف دموعه بكمه كي لا تراه النساء، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فنادى بصوت عال: أما من مجير يجيرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من طالب حق ينصرنا؟ أما من خائف من النار فيذبّ عنا؟
كل هذا لإبلاغ الحجة، وإقامة العذر، حتى لا يعتذر أحد بالغفلة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ولما رأته سكينة مقبلا أخذت بعنان جواده، وقالت: أين عمي العباس، أراه أبطأ بالماء؟
فقال لها: إن عمك قتل، فسمعته زينب فنادت: واأخاه! واعباساه! واضيعتنا بعدك! وبكين النسوة وبكى الحسين معهن، ونادى: واضيعتنا بعدك أبا الفضل.
ولكن لما كان (سلام الله عليه) أنفس الذخائر عند السبط الشهيد، وأعز حُماتِهِ لديه، وطمأنينة الحرم بوجوده وبسيفه الشاهر، ولوائه الخفاق، وبطولته المعلومة ; لم يأذن له إلى النفس الأخير من النهضة المقدسة، فلا الحسين يسمح به، ولا العائلة الكريمة تألف بغيره، ولا الحالة تدعه لأن يغادر حرائر أبيه بين الوحوش الكواسر.
هكذا كان أبو الفضل (عليه السلام) بين نزوع إلى الكفاح بمقتضى غريزته، وتأخر عن الحركة لباعث ديني وهو طاعة الإمام (عليه السلام)، حتى بلغ الأمر نصابه، فلم يكن لجانب الغيرة أو دافعها مكافئ، وكان ملء سمعه ضوضاء الحرم من العطش تارة، ومن البلاء المقبل أخرى، (ومركز الإمامة) دارت عليه الدوائر، وتقطعت عنه خطوط المدد، وتفانى صحبه وذووه.
هنالك أنتفض (صاحب اللواء) ـ ولا يلحقه الليث عند الهياج ـ فمثل أمام أخيه الشهيد يستأذنه، فلم يجد أبو عبد الله بُدّاً من الإذن، حيث وجد نفسه لتسبق جسمه إذ ليس في وسعه البقاء على تلك الكوارث الملمة من دون أن يأخذ ثأره من أولئك المردة، فعّرفه الحسين أنه مهما ينظر اللواء مرفوعاً فإنّه يرى العسكر متصلاً، والمدد متتابعاً، والأعداء تحذر صولته، وترهب إقدامه، وحرائر النبوة مطمئنة بوجوده، فقال له: ” أنت صاحب لوائي “، ولكن اطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء.
فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم ينفع، فرجع إلى أخيه وأخبره، فسمع الأطفال يتصارخون من العطش، فنهضت (بساقي العطاشى) غيرته الشماء، وأخذ القربة، وركب فرسه، وقصد الفرات، فلم يرعه الجمع المتكاثر، وكشفهم شبل علي عن الماء، وملك الشريعة، ومذ أحسّ ببرده تذكّر عطش الحسين، فرأى من واجبه ترك الشرب ; لأن الإمام ومن معه أضّر بهم العطش، فرمى الماء من يده وأسرع بالقربة محافظاً على مهجة الإمام ولو في آن يسير وقال(1):
يا نفس من بعد الحسين هوني… وبعده لا كنت أن تكوني
هذا الحسين وارد المنون… وتشربين بارد المعين
تالله ما هذا فعال ديني
فتكاثروا عليه وقطعوا طريقه، فلم يبال بهم، وجعل يضرب فيهم بسيفه ويقول:
لا أرهب الموت إذا الموت زقا …حتى أوارى في المصاليت لقا
إني أنا العباس أغدو بالسقا …ولا أهاب الموت يوم الملتقى
فكمن له زيد بن الرقاد الجهني، وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي، فضربه على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله وجعل يضرب فيهم ويقول:
والله إن قطعتُمُ يميني …إني أحامي أبدا عن ديني
وعن إمام صادق اليقين …نجل النبي الطاهر الأمين
فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة، فضربه على شماله فبراها، فضم اللواء إلى صدره.
فعند ذلك أمنوا سطوته، وتكاثروا عليه، وأتته السهام كالمطر، فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب عينه، وحمل عليه رجل بعمود من حديد وضربه على رأسه المقدس.
وهوى بجنب العلقمي فليته … للشاربين به يداف العلقم
ونادى بصوت عالٍ: عليك مني السلام يا أبا عبد الله(1)، فأتاه الحسين (عليه السلام)، ويا لهف نفسي بماذا أتاه، أبحياة مستطارة منه بذلك الفادح الجلل، أو بجاذب من الأخوة إلى مصرع صنوه المحبوب!
نعم، وصل الحسين عنده وهو يبصر هيكل البسالة وقربان القداسة فوق الصعيد، وقد غشيته الدماء السائلة، وجللته النبال، ورأى ذلك الغصن الباسق قد ألم به الذبول، فلا يمين تبطش، ولا منطق يرتجز، ولا صولة ترهب، ولا عين تبصر، ومرتكز الدماغ على الأرض مبدد.
أصحيح أن الحسين ينظر إلى تلكم الفجائع ومعه حياة تقدمه، أو عافية تنهض به؟ لا والله لم يبق الحسين بعد أبي الفضل إلا هيكلا شاخصا، معرى عن لوازم الحياة، وقد أعرب سلام الله عليه عن هذا الحال بقوله: ” الآن انكسر ظهري، وقلت حيلتي، وشمت بي عدوي “.
وبانَ الانكسارُ في جبينِهِ … فانكّدت الجبال من حنينِهِ
كافل أهله وساقي صبيتِهْ … وحامل اللوا بعالي هّمتِهْ
وكيف لا وهو جمال بهجتِهْ …وفي محياه سرور مهجتِهْ
ورجع إلى المخيم منكسرا حزينا باكيا يكفكف دموعه بكمه كي لا تراه النساء، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فنادى بصوت عال: أما من مجير يجيرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من طالب حق ينصرنا؟ أما من خائف من النار فيذبّ عنا؟
كل هذا لإبلاغ الحجة، وإقامة العذر، حتى لا يعتذر أحد بالغفلة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ولما رأته سكينة مقبلا أخذت بعنان جواده، وقالت: أين عمي العباس، أراه أبطأ بالماء؟
فقال لها: إن عمك قتل، فسمعته زينب فنادت: واأخاه! واعباساه! واضيعتنا بعدك! وبكين النسوة وبكى الحسين معهن، ونادى: واضيعتنا بعدك أبا الفضل.